قراءة مغايرة في كتاب “نوم الغزلان”، لمحمد علي طه!
المقال كاملا
*د. محمد هيبي*
مقدّمة
عندما تضع رأسك على الوسادة بعد انتهاء يوم عملك، مهما بلغ طولا أو عرضا، راحة أو إرهاقا، قبولا أو رفضا، سعادة أو شقاء، وبغضّ النظر عن كيف سيكون نومك بعد ذلك، نوما عميقا بما فيه من راحة وهدوء، أو “نوم الغزلان” بما فيه من قلق واضطراب، لا بدّ لك أن تكون صادقا مع نفسك، أن تُحاسبها حسابا عسيرا عن كلّ ما سوّلته لك في نهارك من إساءة للآخرين. وإن لم تكن صادقا معها قبل خلودك للنوم، فلن تكون صادقا في شيء، لا في عملك ولا في حياتك، حتى لو صدّقك الناس، أو سكتوا عنك لأسباب قد نقبلها أو نرفضها. ومهما حاولتَ طمس، أو إنكار، أو تجميل ما سوّلتْه لك، فاعلم أنّ الحقيقة لا بدّ لها أن تبزغ يوما، وتسطع كالشمس في كبد السماء في يوم قائظ كقيظ ذلك اليوم الذي هُدمت فيه “ميعار” وشُرِّد أهلها.
اسأل نفسك: هل صمتك عن الحقيقة، أو أنكارك، أو تزييفك وتشويهك لها، أو تجميلك لما زيّفت وشوّهت، أو ادعاؤك البطولة في هذا الحدث أو ذاك، وأنت تعلم علم اليقين أنّه لا ناقة لك فيه ولا بعير، هل أضرّ بك وحدك، أم بالآخرين أيضا، واقعا وشعورا؟ وهل أنت مهيّأ أو مستعدّ للمساءلة، أم أنّك ترى نفسك فوقها، وليس من حقّ البسطاء أن يُسائلوا العظماء؟!
واعلم، أنّنا نعيش في مجتمع يغضّ النظر عن الأخطاء لأنّه غارق فيها. وبما هو كذلك، يرجو ألّا يفيض الكيل على كيّالٍ قد تضطرب أمعاؤه ويَبُقّ الحصوة التي لا يرغب البعض برؤيتها أو سماع ارتطامها بأرض واقعنا، ويتمنّى أن يختفي الكيّال أو يُصاب بالشّلل قبل أن يَبُقَّ حصوته، لأنّه ربما لا تزال في بعض وجوهنا بقية من حياء. ورغم ذلك، نعلم علم اليقين أنّ بيننا وجوها جفّ ماؤها ومات حياؤها، وأصبحت جلودها من السماكة والجمود ما يجعلها عازلة للماء مقاومة للصدمات. صُمِّمت كالسيّد سايكو وساعاته، “كم أنت قاسٍ يا سيّد سايكو. أنت إنسان بلا قلب وبلا شعور وبلا إنسانية” (13).[1] فهل لنا أن نلوم السيّد سايكو وبيننا من هم أقسى منه وأسوأ؟!
وضعنا الثقافي القائم وخطوات قبل “نوم الغزلان”!
نعيش في الفترة الأخيرة، صحوة أدبية ثقافية فيها الكثير ممّا يُرضي وينفع، رغم كل ما لنا عليها من مآخذ تجعلها في بعض جوانبها مشبوهة أو موجّهة بأيدٍ لا تُريد لنا الخير. وأوّلها، وربما أهمّها، هو ندرة المثقّفين العضويين بيننا، وثانيها، وأخاله لا يقلّ أهميّة، أنّنا نُبدع في الأدب وننشر، ولكنّنا لا نقرأ. ومن يقرأ، لا يُدرك غالبا، أنّ بعض كُتّابنا يخدعونه ولا يقولون الحقيقة؛ ولا أحد يُحاسبهم. والغريب أنّ بعض نقّادنا أحيانا، لا يقولون الحقيقة حول ما يُشهره النصّ أو يُضمره، لأنّهم لم يروها، وهذا مؤسف، أو رأوها وآثروا لأسبابهم، غضّ النظر عنها وعمّن كتبها مشوّهة أو مجزوءة أو مقلوبة، وهذا مؤسف أكثر. والأغرب، إنّ بعضهم، يكيلون المديح للكاتب، ويُغفلون الحقيقة المسيئة لهم ولغيرهم، لأنّ الكاتب، بغضّ النظر عن شكل كتاباته ومضمونها، هو “كاتب كبير”، أو “شابّ حبوب ويستحقّ”، أو “صبية نغنوشة” تستحقّ الاهتمام الأدبي وغير الأدبي.
عزيزي القارئ، هذا المقال ليس نقدا أدبيا خالصا، ولا علميّا خالصا. ولكن يُمكنك اعتباره فصلا على هامش النقد الأدبي، لـ “فصول على هامش السيرة الذاتية”. وقد تأخّر نشره نتيجة التّريّث في أمور عديدة كان لا بدّ من فحصها بدقّة والتأكّد من صحّتها قبل الكتابة. ذلك لأنّني لا أنتصر لنفسي، بل للذين ظُلموا وسُرقت بضاعتهم مرتين: مرة على يد السلطة الظالمة التي قد نفهم ظلمها ولكن نرفضه بكل قوة، ومرة على يد نفر من أهلنا، لا نفهم ظلمهم، وقطعا نرفضه بقوة أكبر. فهو أشدّ من ظلم السلطة على حدّ قول الثائر تشي جيفارا: “الأقربون طعنتهم أشدّ لأنّها تأتي من مسافات قصيرة”، خاصة وأنّ المظلومين في الحالين، غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، إمّا لأنّ الموت غيّبهم، وإمّا لأنّهم ضعفاء أو مستضعفون. وطلبا للحقيقة التي لا لبس فيها، بحثت عن بعض من خرجوا من دائرة الضعف، وطلبت منهم أن يدعموا رأيي فيما أدّعيه، أو يُصوّبوني فأتراجع عن كل ما يكتنفه الشكّ.
الكاتب محمد علي طه، في كتابه الأخير، “نوم الغزلان”، يبدو كمثقّف واسع الثقافة والاطّلاع. ولكن، هل هو كما وصفه بعض أصدقائه، النقّاد وغيرهم، مثقّف عضويّ حسب نظرية المفكر الإيطالي، أنطونيو غرامشي؟ هذا ما لا أراه أبدا في كتابه. فالمثقّف العضويّ عند غرامشي يعيش هموم شعبه ومجتمعه، وينتمي لمشروع ثقافي يُجنّده لخدمتهم، ويُضحّي بالنفس والنفيس من أجلهم. بينما محمد علي طه في كتابه، فعل العكس تماما، إذ لم تردعه معرفته وثقافته عن قلب الحقيقة وتزييفها، أو ادعائها لنفسه أحيانا، ضاربا باحتياجات شعبه ومجتمعه عرض الحائط. فما هو دافعه الحقيقي لذلك؟ هل هو غروره ونرجسيته؟ لو توقّف الأمر عند هذا الحدّ، لما كتبتُ. ولكنّه تعدّاها إلى ما هو أبعد بكثير. وبعض الذين كتبوا عنه، غامروا بهذا الوصف وتجاهلوا أنّ عوالمَ الاستبداد لا يُصارعها أدبٌ وأدباء ليسوا أحرارا ولا يقولون الحقيقة. ولذلك أرجو أن يتذكر القارئ المقولة التالية، لأنّها مقياس أومن به وبصدقه ومصداقيته!
قال الناقد الفلسطيني المعروف، د. فيصل درّاج: “الفنّ لا يقول الحقيقة إلّا إن كان حرّا، ولا يكون فنّا إلّا إن قال الحقيقة. ولذلك فإنّ تاريخ الفنّ العظيم هو تاريخ الصراع ضد عوالم الاستبداد”.[2] فهل يُصارع عوالم الاستبداد قلم لا يقول الحقيقة؟!
والآن، بعد أن هدأت الضجّة المفتعلة التي أثارها، لا أقول “نوم الغزلان”، وإنّما كاتبه ومن يُصفّقون له، جاء دور الحديث عن الحقيقة، وعن البطولات المزعومة وتزوير التاريخ، وما زيّفه أو ادّعاه أو أخفاه لغاية في نفسه.
للأسف، يلتفت بعض النقّاد للكاتب أكثر من النصّ، ويُهملون النقد والتحليل الاجتماعي والنفسي، الذي قد يفضح حقيقة أخفاها الكاتب أو زيّفها. فإذا أهملها النقّاد فمن سيظهرها؟! هل فكّر أحدهم، بدافع آخر غير وطنيّة الكاتب كفلسطينيّ شرّدته الصهيونية، هدمت بيته وصادرت أرضه؟ سأحاول ما استطعت، أن أكشف السرّ من خلال فهمي وتحليلي الاجتماعي والنفسي لما ورد في كتاب “نوم الغزلان”، ليتسنّى للقارئ التفكير بعمق عند اصطدامه بالحقائق التي طرحها الراوي/الكاتب أو أخفاها، وليقف على مدى صحّتها وصدقها، أو مدى التلاعب فيها.
نشر الشاعر علي هيبي، الناطق الرسمي بلسان الاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين – الكرمل، خبرا في جريدة الاتحاد، حول قيام أعضاء الاتحاد القطري بزيارة لقسم اللغة العربية في جامعة النجاح في نابلس (الاتحاد، عدد 12/4/2018، ص 9). في الخبر، سقط قصدا أو سهوا، اسم الكاتب محمد علي طه كرئيس ثانٍ لاتحاد الكتّاب العرب بعد الشاعر سميح القاسم، واللذيْن كان الأمين العام للاتحاد القطري، الكاتب سعيد نفّاع، قد ذكرهما في كلمته في اللقاء المذكور. وقامت الدنيا لدى الكاتب محمد علي طه ولم تقعد، لأنّ اسمه سقط من الخبر، فبدأ اتصالاته مع من لهم علاقة بالاتحاد القطري، والضغط عليهم ليضغطوا على الناطق الرسمي، حتى نشر الأخير بعد يومين، خبرا مفاده “سقط سهوا”، وذكر اسم الكاتب فيه (الاتحاد، 15/4/2018، ص 6). ولنا أن نتساءل هنا: إذا كان الكاتب محمد علي طه لم يحتمل مثل هذا الخطأ، مقصودا أو غير مقصود، كيف إذن احتمل هو نفسه، كلّ الموبقات المثيرة للاشمئزاز والاستهجان والتساؤل، التي ارتكبها في كتابه “نوم الغزلان”؟ ولماذا علينا نحن القراء والأشخاص والمؤسسات الذين مسّت بهم، أن نحتملها؟ وهل سيأتي ذلك اليوم الذي يعتذر فيه الكاتب الكبير لمن أساء لهم أمواتا، أو لمن دفنهم في كتابه، وهم أحياء يُرزقون؟
رغم محاولاتي النقدية، أصابت أم أخطأت، ولأسباب خاصة وعامة، لم أفكّر بنقد أعمال الكاتب محمد علي طه. أمّا اليوم، فإصداره الأخير، “نوم الغزلان”، الذي وسمه أو وصفه بـ “فصول على هامش السيرة الذاتية” (18)، طيّر النوم من عينيّ. وتصرّفه حيال الخبر أعلاه، كان القشّة التي قصمت ظهر البعير. أرغمني أن أطرح كل أسباب الصمت، لا لأسباب شخصية، ولكن دفاعا عن الحقيقة التي أعتقدُ أنّ الكتاب وكاتبه، لم يكونا أمينيْن عليها. وكل ما أريده هو إخراج الحقيقة للناس، الحقيقة التي ظلمها الراوي/الكاتب في كتابه، وظلم أصحابها حين أخرجها مجزوءة ومشوّهة، أو ادّعاها لنفسه وهو يعرف أنّها ليست له، أو قبر بعض فصولها ولم يذكره أبدا، رغم أنّه يعرف أنّها فصول لعبت دورا ذا بال في حياته وفي حياة رفاقه وأصدقائه أيّام كان مسجّلا كعضو في الحزب الشيوعي وفي الجبهة الديمقراطية، قطريّا ومحليّا. ولعبتْ كذلك دورا ذا بال في حياة الناس من أهالي قريتي “الدامون” و”ميعار” المهجّرتين، وقرية كابول الباقية، التي استقرّ فيها بعد النكبة وما زالت تحتضنه. وكل ذلك التجزيء والتشويه والقلب والقبر، الذي كان نصيبَ الحقيقة في كتابه، حسب فهمي المتواضع للنصّ، هدفه “الأنا” والذات الكاتبة التي خانت الحقيقة وخانت أهداف الكتابة والأدب؛ فقد انتفخت إلى حدّ المسّ بالآخر أو تغييبه كليّا. وقامت بإحياء الآخر المقبور، وقبر الآخر الحيّ لغاية لا أرى غيرها، الاستعلاء على الناس، أفرادا ومؤسسات، وإنكار دورهم، أو تشويهه إرضاء للنرجسية المقيتة التي يراها القارئ تطغى في كتاباته. وهي بلا شكّ، نابعة عن عقدة الشعور بالنقص، وقد أعمته فلم ير أنّها قد تكون قاتلة. ولذلك، أرى “نوم الغزلان”، رصاصة أطلقها الكاتب فارتدّت إليه وفضحته وزعزعت مصداقيته، ليس فيما كتب فقط.
ظلّ الكاتب، طيلة سنيه، يُحدّق في صورته المنعكسة في بحيرة كتاباته وبطولاته المزعومة، إلى أن سقط في البحيرة؛ وإن سقط ولم يمت، اجتماعيا وأخلاقيا، فذلك بفضل عيوب مجتمعنا. لأنّ كتابه يمسّ بالآخر ويُسيء للكثيرين، أفرادا ومؤسسات، والأهمّ من ذلك، يُزوّر التاريخ. بل ربما أكثر من ذلك أيضا، أشتمّ في بعض أسلوبه، ما هو أخطر، يجعلني أبقّ حصوة أخرى.
الكاتب محمد علي طه إنسان ذكيّ بالفطرة، وذكاءه تطوّر وتبلور عبر السنين وتراكم التجربة. فهل استخدمه يوما، في خدمة شيء غير ذاته؟ لكم جوابكم، ولي جوابي القاطع: لا! وما جاء في “نوم الغزلان”، كافٍ لإثبات ذلك. “نوم الغزلان” الذي لا تكمن خطورته في أنّه لا يخدم الآخر والجماعة، أو لا يخدم إلّا ذات الكاتب، أو لا تكمن في قلبه للحقيقة وتزييفها وتشويهها، أو قبرها أحيانا، وإنّما تكمن أيضا، في بعض جوانب أسلوبه في عرض الحقائق المزيّفة والمشوّهة بشكل يتناقض مع كونه كاتبا وطنيا، أو رئيسا للجنة الوفاق، أو عضوا في لجنة الصلح العشائري، لأنّ في أسلوبه دعوة مبطّنة للفتنة، نعم الفتنة التي قد تنشب بين من تُسوّل له نفسه نبش الماضي سعيا وراء الحقيقة، وبين أناس لهم صلة بأبطال الأحداث والحقائق التي شوّهها أو قلبها، لأنّ أبطالها الحقيقيين أصبحوا في ذمة الله. فكيف نسأل شاهدا فارق الحياة حين يضع أحد على لسانه كلاما لم يقله، أو ليس صحيحا، أو ليس دقيقا، أو يُثير تساؤلات حَسِبَ الكاتب أنّ لن يجرؤ على طرحها أحد، أو توقّع أن لا يجرؤ أحد على نبش الإجابات عنها، لأنّه إذا فعل، قد يُعرّض نفسه لصدام مع أقارب أبطال الأحداث والحقائق التي زُيِّفت. كيف سنتّهم فلانا بالعمالة ويسكت أهله؟ كيف نطرح موضوع بيع الأرض ونذكر من باعها للمؤسسة الصهيونية ولا نصطدم مع أهله؟ يعرف الكاتب أنّهم يخجلون ممّا حدث ومن مجرّد ذكره. والكاتب أدرى الناس بطبيعة مجتمعنا! فهو يُدرك جيّدا أنّ “هلل كوهين”، ذكر في كتابه “عرب جيّدون”، أسماء العملاء والخونة الذين تعاونوا مع المؤسسة الصهيونية قبل النكبة وبعدها، فهل اعترض أحد أو رفع صوت احتجاج؟ ولكن، هل يستطيع أحدنا أن يُردّد تلك الحقيقة أمام أحد أبنائهم أو أقربائهم؟ ألّا توافقون أنّه قد تحدث فتنة؟
كما أنّ هناك مثالا أطرحه وأنا أشعر بالخجل. يقول: “قدّم أبو سلام (إميل حبيبي – م. هـ.)، في بداية اللقاء تقريرا مختصرا عمّا جرى في الاجتماع السابق وحمّلني مسؤولية فشله واتّهمني بالتطرّف القومي وعدم فهمي للواقع السياسي والحزبي في البلاد وأضاف أنّ موقف “حبيبنا سميح” (القاسم – م. هـ.) كان متطرّفا ولكنّه “ألطف” أو أقلّ تطرّفا من موقف “رفيقنا أبو علي” … وأمّا سلمان ناطور فكان “ينعوص”، ولم يسلم من “وخزاته” سوى أنطون شلحت وسهام داود” (181). شعرت بالخجل، وسُررت أنّ قرّاءنا قلّة، وتمنّيت أنّهم يقرأون ولا يفهمون، لأنّ في هذه الفقرة، إلى جانب النرجسية وشعور بالعظمة، دعوة للفتنة الشخصية والاجتماعية والطائفية. سأتركها للقارئ يقرأها ويسبر أغوارها ويُحاول فهم دلالاتها. وإن لم يستطع فقد يكون ذلك أفضل من باب “ولا تكرهوا شيئا”!
“نوم الغزلان” وأسلوبه، يدفعان إلى الفتنة بكلّ من يسعى إلى الحقيقة، أو يلجمانه خوفا منها ومما قد يُصيبه من تردّد خشية الصدام، خاصة عندما يكون تاريخ من ذكرهم الكتاب مشبوها، قد لا يحتمل البعضُ نبشَه؟! وإذا كنت أبالغ في قضية الفتنة، فهل أبالغ في قضية اللجم؟ والأمر نفسه ينطبق على الرفاق والأصدقاء أعضاء الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، لأنّ معظم ما ذكره الكاتب عن قادتهم مثير للاستهجان والتساؤل، ويحتاج إلى إثبات، وقد يُثير الخلاف بينهم؛ طبعا إذا قرأوا الكتاب وركّزوا في فهم النصّ وليس في شخص الكاتب وعبقريّته.
قد يقول قائل: إنّ ما يكتبه محمد على طه، أدب، والأدب يسمح بتخييل الواقع حتى لو كذب. نعم، ذلك جائز. ولكنّ نزعة التوثيق في هذا الكتاب تطغى على الكتابة الفنيّة، خاصة وأنّ الكاتب نفسه، هو من وَسْم كتابه بـ “فصول على هامش السيرة الذاتية”، ما يعني أنّه قرّر مسبقا أن يذهب في طريق التوثيق. وعليه فقد ألزم نفسه بقول الحقيقة كاملة بغضّ النظر عن أسلوب عرضها. وأكثر من ذلك: هل هناك ناقد، مهما كان حاذقا، يستطيع أن يقول إنّ السرد الأدبي بما فيه من تخييل للواقع، يسمح بتشويه الحقيقة أو تزييفها؟
ورغم كلّ ما تقدّم، للكاتب أو عليه، يُجانب الحقيقة والصدق، من يقول إنّ محمد علي طه ليس كاتبا. فهو كاتب غزير الإنتاج، وكاتب قصة قصيرة جيد على المستوى المحلّي. وإضافة إلى غزارة الإنتاج، له أسلوبه الخاص. وهو أسلوب لا يخلو من سخرية هادفة، ولا من لغة شاعرية جميلة، وفيه كذلك نكهة عربية فلسطينية ميعارية. ولكنّ المؤسف حقّا، هو أنّ النرجسية تطغى غالبا على أسلوبه الأدبي. وقد كتب أحد النقّاد دراسة حولها،[3] ولكنّه لم يتطرّق بعمق إلى جوانبها السلبية. وفي حالة “نوم الغزلان”، هذا الكتاب الوثيقة، إلى جانب طغيان النرجسية فيه غالبا، والتكلّف والتصنّع أحيانا، يطغى فيه أيضا، أسلوب طمس الحقائق وتزييفها وتشويهها.
عندما صار عندي بعض الإلمام بالنقد الأدبي، أعدتُ قراءة بعض إنتاج الكاتب محمد علي طه، لأبحث فيه عمّا يدعم “تهمتي” له بالتكلّف والتصنّع وعدم الصدق، خاصة وأنّ له الكثير من الإعمال القصصية الجيّدة. إنتاجه الروائي لم يتعدّ رواية واحدة، “سيرة بني بلوط” (2004)، ظلّت يتيمة إلى كتابة هذه السطور. قرأت الرواية ولاحظت هزالها رغم ما فيها من جوانب إيجابية، ولم أحكم عليها إلّا بعد أن دعم رأيي أكثر من ناقد له باع في النقد، أطول من باعي بما لا يُقدّر. ومع ذلك لم أعطِ للأمر كبير أهمية. فمن جهة، الرجل كاتب قصة قصيرة جيد، ومن جهة أخرى، بحثت في إنتاجه فقط عمّا قد يدعم “تهمتي” له، لأنّني أومن أنّ الفنّ لا يكون فنّا إلّا إن قال الحقيقة، وأنّ الكاتب يكتب ذاته، بغضّ النظر عن الشخصيات التي يرسمها، أو الأحداث التي يسردها، أو القضايا التي يُعالجها في نصوصه. وقد وجدت في روايته وقصصه ما يُؤكّد تلك “التهمة”. ولكنّ ذلك لم يكن كافيا بحيث يدفعني للكتابة، لأنّني من جهة، أعرف ضرورات التخييل، وإن كان التخييل لا يعني تزييف الحقيقة أو طمسها. وقد تذكّرت دائما مقولة ألبيرتو مورافيا (1907-1990)، الروائي الإيطالي وأحد منظّري الرواية: “أنا كاذب، وهذا يعني أنّني روائي”.[4] ومن جهة أخرى، اعتبرت أنّ ما يكتبه محمد علي طه، مهما بلغت نرجسيته، لا يتجنّى فيه على أحد، بل وفيه بعض الفائدة الأدبية والمنفعة الثقافية للناس. وكان هذا كافيا، لا لأن يشفع له عندي فأستمرّ في لجم قلمي فحسب، بل لأن يضعه أيضا في المركز الحقيقي الذي بلغه من الكتابة. وعليه، فقد استمرّ صمتي إلى أن أصدر “نوم الغزلان”، ووسمه بـ “فصول على هامش السيرة الذاتية”. وهذا الوصف، شاء أم أبى، لا يُخرجه من إطار السيرة الذاتية. ولكن المهمّ في الأمر، إنّه اخترق فيه كلّ قواعد الصدق والأمانة في الكتابة والأدب، وأباح لنفسه قلب الحقائق والاستهتار بعقول الناس والقرّاء. وهنا أقصد الناس والقرّاء عامة، ولكن بشكل خاص، أولئك الذين يعرفونه شخصيا، فبعضهم عاش معه، وبعضهم لا يزال يُقاسمه المكان والهمّ.
وعودة إلى مورافيا، قال: “أعمالي ليست سيريَّة بالمعنى المعتاد للكلمة، مهما يكن للعمل صلة بالسيرة الذاتيّة، فهو كذلك، فقط بطريقة غير مباشرة مطلقًا، بطريقة عامة للغايّة. أنا ذو صلة بـ “غيرولامو”، (أحد أبطال رواياته)، لكنّني لستُ هو. لا آخذ، ولم آخذ قط لا واقعه ولا شخصيّته من حياتي بشكل مباشر. السيرة تعني شيئًا آخر. يجدر بي ألّا أُقْدِم على كتابة سيرة ذاتيّة حقيقيّة، أنتهي دائمًا إلى التزييف والاختلاق القصصي، أنا كاذب، في الحقيقة، وهذا يعني أنّني روائي”.[5]
إذن روايات ألبيرتو مورافيا ليست سيرة ذاتية له، حتى وإن لمح القارئ بعض ملامحه فيها. ولكن، أهمّ ما يُفهم من كلامه هو أنّ كتابة الرواية الفنّية، تختلف في تناول الحقائق عن كتابة رواية السيرة الذاتية. فالسيرة الذاتية تتحدّث عن أحداث وحقائق وقعت لا مجال فيها للتشويه والتزييف والتحريف، وذكرها يحتاج إلى كثير من الشجاعة والجرأة، إن لم يتَحَلّ بهما الكاتب، فالأفضل له أن يتّخذ من مورافيا قدوة، أي أن يصمت ولا يخوض التجربة.
ما قلته عن أعمال مورافيا ينطبق على أعمال غيره من الروائيين، كما ينطبق على الأعمال القصصية والروائية للكاتب محمد علي طه. فهي ليست سيرة ذاتية له كما يدّعي في كتابه. أمّا فيما يتعلّق بكتابه الأخير، “نوم الغزلان”، فالأمر مختلف تماما، لأنّه سيرة ذاتية حقيقية تحتاج إلى الأمانة والصدق. وقد أخطأ في وسمه بـ “فصول على هامش السيرة الذاتية” (18) لسببين أولهما واضح، وهو نرجسيته التي ترى كلّ أعماله خارج الأدب، وكذلك الأشخاص الذين التقاهم وأعمالهم، أقلّ شأنا من أعماله الأدبية، باعترافه حين قال إنّ “سيرته الذاتية هي كل أعماله الأدبية التي نشرها وسينشرها” (18)، وهذا القول يُكذّب ادعاءه بأنّ هذا الكتاب “فصول على هامش السيرة الذاتية”، فهو فصول من السيرة الذاتية لأنه جزء مما نشره، أي يشمله اعترافه المذكور. والسبب الثاني هو جهله أو تجاهله أنّ هذه الفصول، وثائق يجب أن تُكتب بمنتهى الصدق والأمانة، بغضّ النظر عن أسلوبها. وقد ألزم نفسه بهذا الوصف، بما لم يلتزم به من الصدق في الكتابة والأمانة في التوثيق!
وللتذكير، أول قواعد فنّ السيرة وأهمّها، الأمانة في نقل التاريخ، تاريخ صاحب السيرة ومن كانوا حوله، وقول الحقيقة ولو على نفسه. لا يجوز الانتقاء والغربلة والتجميل في السيرة إلى حدّ التشويه. وهي ليست لنقل البطولات أو اختراعها بل لبيان الحقيقة الجميلة والقبيحة على حدّ سواء. وهذا ما نعرفه بالتجربة أيضًا حين قرأنا العديد من السير الذاتية كسيرة حنا أبو حنا وفدوى طوقان وإدوارد سعيد وغيرهم. وبالإضافة لذلك، “السيرة الذاتية هي سرد نثري واقعي يدور حول شخصية حقيقية … ومن أهمّ مقوّماتها، التطابقُ التام بين المؤلِّف والشخصية والراوي، وغلبةُ الصوت الواحد الذي يحمل رؤية الكاتب الأيديولوجية”. هذا ما قاله صديقي الناقد د. رياض كامل في مقال له حول السيرة الذاتية في كتاب “نوم الغزلان”. وهذا ما أقوله أنا ويقوله كل منظّري الرواية. وأكثر من ذلك، يقول د. رياض كامل إنّ الكتاب يحمل “رؤية محمد علي طه المباشرة، فضلا عن تبعثر المقالات والمواضيع في أزمنتها وأمكنتها، واعتماد السرد في غالبيته على أحداث شهدها الكاتب أو كان شاهدا عليها في أزمنة وأمكنة واقعية … والزمان يسير في السيرة الذاتية بشكل أفقي، كما هو في “نوم الغزلان” … من الواضح أن الكاتب يعمل على ترسيخ رؤيته فعمد إلى توثيق التاريخ والأحداث من خلال شخصية واحدة شاهدة على العصر”.[6]
وعليه، “نوم الغزلان”، مهما سمّاه الكاتب، هو فصول في سيرته الذاتية، تقوم على كتابة بعض مذكراته الشخصية التي انتقاها بذكاء لتخدم أهدافه الشخصية، وليس الأهداف الحقيقية التي تبحث عنها الكتابة. وإن كسّر في كتابه قواعد السيرة الذاتية، فلا لوم في ذلك. كذلك لا حقّ لأحد بمحاسبة الكاتب على ذاتيته حتى لو بلغت حدّ النرجسية المقيتة. ولكن، يحقّ لكلّ قارئ أن يُحاسبه على غياب الحقيقة وانعدام الصدق والأمانة، وعلى نفيه المتعمّد للغير، وقلبه للحقائق وتزييفها وتشويهها أو إخفائها، إرضاء لنرجسيته التي بلغت في الكتاب، أحيانا، حدّ الوقاحة في تزوير التاريخ والاستهتار بعقول الناس عامة والقرّاء خاصة. فقد وضع نفسه بدرا واحدا ووحيدا، في سماء أقليّة عربية ظلامها حالك، ليس للناس فيها، أفرادا ومؤسسات، من رجاء أو نور إلّا نوره والهالة التي نفخها وأحاط نفسه بها. ويا للمهزلة، كأنّ كلّ المبدعين والفلاسفة والحكماء والسياسيين والعلماء، منذ فجر التاريخ، وكذلك قادة الحزب والجبهة، وقادة الشعب الفلسطيني، كلّهم خرجوا من معطفه. ألم يقل في أكثر من محفل ولأكثر من شخص، إنّ كل من عزم الترشّح للبرلمان من قادة الحزب والجبهة، كان يزوره ليحظى بنصيحته ومباركته؟ وأنّ الرئيس عرفات استشاره في مناهج التدريس (237). ولا يسعني هنا إلّا أن أكنّ الاحترام والتقدير لمن قرأ الكتاب وبقّ الحصوة، مثل صديقي ورفيقي نمر نجار، صاحب مكتبة الجيل في كفر ياسيف، الذي قرأ الكتاب فاشمأزّ وامتعض. وحين قابلته وتحدثنا عن الكتاب، سجّل موقفه بكل جرأة وصراحة. قال: “أيّ استعلاء مخجل هذا؟ كأنّه لا يوجد في العالم غيره”!
يعتدى الكاتب محمد علي طه في كتابه، على خصوصية الأحياء، ويخطف من الأموات هدأة نومتهم الأخيرة. وفيه إساءة لأفراد وجماعات ومؤسسات، كان الأجدر به ككاتب “وطنيّ” كما يدّعي، أن يكون أمينا عليهم وعلى الأحياء والأموات، وعلى التاريخ. وأن يُدافع عنهم ويُنصفهم، حتى لو ظلم نفسه. قال تعالى: “يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ” (النساء، 135). فإذا كان الكاتب الحاجّ لا يعرف هذه الآية فتلك مصيبة، وإذا كان يعرفها فالمصيبة أعظم. ولكنّه في الحقيقة، لو أراد في كتابه أن يُنصف أحدا، لأنصف المرحوم والده الذي لم يسلم من مخالب نرجسيته!
ولكيلا أظلم الكاتب، بل لأبيّن ظلمه هو لنفسه وللآخرين، قرأت الكتاب، وأعدت قراءته، ثم زرت أشخاصا ومؤسسات، واستعرضت معهم الحقيقة التي تخصّهم، لأكون أمينا على كل ما أعرضه هنا. ولكن، لن أذكر أسماءهم، لا لأنّ بعضهم طلب منّي ذلك، وإنّما لأجعل القارئ يشعر كم هو قاسٍ عدم ذكر الأسماء عند الحاجة لذكرها. وهو أسلوب استعمله صاحب “نوم الغزلان” بكثرة في كتابه. وسأتحدّث عن ذلك لاحقا.
محمد علي طه كاتب جيّد، وذو قدرة لا يمتلكها الكثيرون. ولكن للحقيقة والأمانة أيضا، يُجانب الصدق والحقيقة، حتى لو كان جهبذ الجهابذة في النقد، من يدّعي أنّه الأجود. فهناك من يفوقه محليّا في مجال القصة القصيرة، ولكنّه لم يحظَ بالاهتمام الكافي من النقّاد والمؤسسات، لا لسبب إلّا لأنّه لم يطرح نفسه في المزاد العلني في سوق النقد والجوائز. وستكون لي وقفة مع الجوائز.
في هذا المقال كما أسلفت، أحاسب “نوم الغزلان”، لأنّه ليس عملا روائيا بقدر ما هو عمل سيريّ توثيقي. ولا أبالغ إذا قلت: بلغ السيل الزّبى! فقد أغضبني وأنطقني بعد صمت! وفي الحقيقة لم أقتنِ الكتاب، ولم أكن أنوي قراءته، ولكن لسوء حظّي، وقع في يدي صدفة عندما زرت صديقا استعاره من صديق كان قد اقتناه. تناولت الكتاب وأخذت أقلّب صفحاته، إلى أن قرأت في إحداها ما أغضبني وأثار اشمئزازي وجعلني استعير الكتاب وأقرأه.
“نوم الغزلان”، قراءة مغايرة!
قبل أن أدخل في طرح الحقائق المقلوبة أو المشوّهة، وتلك التي تجاهلها وأخفاها الكاتب رغم أهميّتها، إليكم عيّنة من الكتاب، لعلّها تُساعدكم في فهم شخصية الراوي/الكاتب والوقوف على نواياه المسبقة لقلب الحقائق وتزييفها، وكذلك من خلال سخريته ممّن كان يجدر به أن يُفاخر بهم وبالانتماء إليهم، لا بل وبالخروج من صلبهم البيولوجي أو الأدبي. ولكن النرجسية لا تعصم من أعمته من أن يكشف بنفسه عن أمراض نفسه، وعن شعوره بالنقص مهما بلغ من العلم والشهرة. وهذا يدفعني للتساؤل: كيف لم ينتبه الكاتب للاوعيه الذي دفق في كتابه الكثير مما يفضحه؟ أين حساسية الكاتب التي يُفترض أن تتعامل بمنتهى الوعي مع اللاوعي؟
الكاتب، لا يمكن أن يكون إنسانا أو كاتبا جديرا باللقب، إلّا إذا اعترف بخروجه علنا أو ضمنا، من معطف كاتب أو مجموعة كتّاب سبقوه. فلا شيء يولد من العدم، والكاتب بالضبط كالإنسان، لا يمكن أن يكون إنسانا إلّا إذا خرج من صلب رجل ورحم امرأة. والفارق الوحيد بينهما، هو أنّ الإنسان الفرد، لا يخرج إلّا من صلب واحد ورحم واحد. أمّا الكاتب فقد يخرج من معاطف كثيرة. وأمّا أن لا يخرج من معطف أحد، فذلك هو المستحيل. ومن العيب أن يعتبر نفسه كبيرًا، كاتبٌ يقول إنّه لم يخرج من معطف أحد، بينما هو نفسه يقتبس فيودور دستويفسكي، عملاق الأدب الروسي، الذي قالها وبكل تواضع وجرأة وصراحة: “كلّنا خرجنا من معطف غوغول”؟ ما يعني أنّ كل أعلام الأدب الروسي الحديث هم تلامذته، أي أنّه مهّد لهم ووضع حجر الإساس ونقطة الانطلاق فتعلّموا منه وساروا بهديه. هل كان يُضير الكاتب محمد علي طه أن يقول تعلّمت من نجيب محفوظ أو تتلمذت على توفيق الحكيم أو يوسف إدريس؟ وهذا الأخير هو عملاق القصة العربية القصيرة الذي يعترف النقّاد العرب والغرب، أنّه فاق بجودة قصصه كبار الكتّاب العالميين. نعم، لقد قال “قرأتُهم”، ولكنّه لم يقل خرجت من معطف أحدهم، بل قال: “وأمّا أنا فلم أخرج من معطف كاتب عربيّ أو من عباءته أو من قمبازه” (119). فمن أين خرج كاتبنا الكبير إذن؟ لعلّه خرج من معطف كاتب أجنبي لم يذكره؟! وقد يقول: “خرجت من رحم النكبة”! هذا حقّه! ولكنّ ألا يُثير ذلك الاستهجان؟ فالنكبة ولدت قتلى ومنفيّين ومهجّرين ومشرّدين، لا كُتّابا، بل شرّدت الكُتّاب أيضا. قد أوافق أنّه بعد خروج الكاتب، أيّ كاتب، من معطف أو عدة معاطف سبقته، سواء كانت عربية أو غير عربية، أنّ النكبة القابعة في وعيه أو لاوعيه، قد عركته وساهمت في بلورة شخصيته.
وأكثر من ذلك، ليت كاتبنا الكبير قال “لم أخرج من معطف أحد”، وصمت. لقد تابع: “ولا من عباءته ولا من قنبازه”. كيف لم يُلاحظ النقّاد الذين كتبوا عن الكتاب، السخرية في هذه العبارة بالذات؟ وما عسى القارئ أن يرى فيها غير الاستخفاف بالمعاطف والسخرية من أصحاب العباءات والقنابيز التي يُنكر أنّه خرج منها؟ وما عساه أيضا أن يرى غير فلسفة مقيتة هي فلسفة الاستعلاء وإلغاء الآخر التي تنصّ على: “حتى أعيش أنا، يجب أن يموت هو”؟ أليست هذه هي الفلسفة التي صبغت الغالبية العظمى من أعمال الكاتب محمد علي طه؟ أليست هي أيضا، عقدة نقصه التي قضّت مضجعه طيلة حياته وكتاباته، وأعمت بصيرته فنسي أو تناسى أنّ الفيل إذا تواضع لا يُصبح نملة، وأنّ النملة مهما أعجبت بنفسها وانتفخت، لن تصير فيلا! أليس في ذلك مؤشّر صارخ على النرجسية البغيضة التي “يتجمّطها” القارئ (يقبلها على مضض) لأنّها حقّ الكاتب؟ ولكن، هل على القارئ أن “يتجمّط” قلب الحقائق وتشويهها وتزييفها أو تغييبها عن قصد، من كاتب يدعي الوطنيّة ولم يبحث أصلا عن الحقيقة لذاتها أو لإطلاع الناس عليها وتعريفهم بها؟ وهل على القارئ أيضا، أن “يتجمّط” سخرية الكاتب من مبدعين ومسحوقين على حدّ سواء، في حين كان عليه أنّ يُوظّف سخريته لإنصافهم وفضح أعدائهم وفضح السلطة التي ظلمتهم؟
والمثير للاستهجان حقّا، أنّ هناك أكثر من موضع في الكتاب، فيه إشارة إلى تأثّر الكاتب ببعض الكتّاب الذين سبقوه. فهو نفسه يعترف أنّه أعجب بمسرح توفيق الحكيم. يقول: “أمّا أنا فكنت معجبا بتوفيق الحكيم” (93). و”تصورت نفسي أديبا مثل توفيق الحكيم” (99). و”اعجبتني النصوص المسرحية وشدّتني إليها منذ قرأت مسرحيّات الكاتب العربي المصري الكبير توفيق الحكيم” (207). فكيف لم يخرج من معطفه؟ وفي موقع آخر، ما إن قرأت هذه العبارة، “وكان في شبابه يملك فرسا أصيلة يعتني بها عناية فائقة كأنّها عروس فيسقيها الماء الصافي ويُطعمها الشعير المنقّى والمحسّك … كان يسقيها الشراب” (78)، حتى شعرت بالطيب صالح ونخلة جدوله ونعجة حسن (أحد شخصيات قصته)، ماثلين أمامي. قد يقول قائل إنّه التناص، نعم إنّه التناص. وأنا أرى أنّ كل تناص هو خروج ما من معطف ما. كما أنّه تحدّث خارج الكتاب عن يوسف إدريس. وقد أوردت د. رقيّة زيدان في مقال لها، بعض ما قاله عنه: “أنا معجب بالكاتب العملاق يوسف إدريس، ولا شكّ في أنّه أحسن من كتب القصة القصيرة في العالم. إنّ قصص إدريس أرقى فنياً من قصص تشيخوف وموبسان وإدجار ألن بو، وأنا معجب بنجيب محفوظ وجبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن منيف وزكريا تامر.[7] هل هذا الإعجاب للتّباهي بأنّه قرأهم فقط، أم يُشير بكل وضوح إلى أنّه خرج من بعض معاطفهم؟!
الحقائق التي طمسها الكتاب!
سأطرح هنا بعض التساؤلات حول الحقائق التي طمسها الكاتب وأخفاها رغم أنّها جزء مهمّ ولا يتجزّأ من سيرته الذاتية، وقد آثر لأسبابه، ألّا يذكرها رغم أنّها شغلت في حياته حيّزا كبيرًا. والسبب في تجاهله لتلك الحقائق، كما أراه أنا، كإنسان يعرف الكاتب جيّدا، وكناقد يُحسن فهم النصّ ومعالجته، هو أنّ بعض تلك الحقائق لا تشرّف أيّ كاتب … فما بالك إذا كان كبيرا كما يدّعي هو، أو حتى كما يراه البعض. وقد يكون تجاهل تلك الحقائق والأحداث، لأنّها قد تُثير جدلا أو محاسبة لا يستطيع الكاتب مواجهتهما. وهنا لا بدّ من ذكر أمرين: الأول هو أن معظم الكتّاب الذين كتبوا سيرهم الذاتية، لم يخجلوا من ذكر بعض الأشياء المخجلة التي حدثت لهم في مرحلة ما في حياتهم، وبذلك فرضوا احترامهم ومصداقيتهم على القارئ. والثاني، هو أنّه قد يسأل سائل: من خوّل محمد هيبي أن يكتب أو يتساءل حول فترة في حياة الكاتب محمد علي طه، من حقّه أن يُخفيها؟ والجواب بسيط: من جهة، حقّ الأدب وحقّ النقد، ومن جهة أخرى، كنّا رفاق درب، ومن جهة ثالثة، الكاتب محمد علي طه نفسه! كيف؟ والجواب بسيط أيضا: كما ادّعى هو نفسه! ألم يطلب من الرفيق توفيق طوبي، أن يكتب له مذكراته، وفي النهاية هو من رفض الكتابة؟ (90-91) ووجدت بعدما فحصت الأمر، أنّ كتابة المذكرات كانت موضوعا تداوله الاثنان، ولكن أن يكون هو الذي طلب، وفي النهاية هو الذي رفض، فذلك يُثير الاستهجان، ولذلك قلت إنّه “يدّعى”، لا لأكذّبه، بل لأنّ بعض ما قاله حول الموضوع ما زال يحتاج إلى أثبات، إذ قابلتُ رفاقا هم أقرب المقرّبين من الرفيق طوبي، ولم يتمكّنوا من تأكيد الطلب والرفض لأنّهم لم يسمعوا به. طلبه من الرفيق طوبي، جعلني أعتبر كتابه “نوم الغزلان” طلبا موجّها لي أو لأي قارئ، أن يكتب ما لم يستطع هو كتابته! وكلّنا نعرف أنّه من حقّ القارئ أن يُفكّك النصّ الأدبي، وأن يُعيد بناءه كما يشاء، لأنّه بعد نشره، لم يَعُد مُلكا للكاتب. وأنا قرأت النصّ وفكّكته، ومن حقّي كقارئ أن أعيد بناءه كما أريد، وإتمام نقصه إذا لزم الأمر. ولا أنكر أنّه من حقّ الكاتب محمد علي طه وحقّ القرّاء، أن يُحاسبوني إن لم أقل الحقيقة.
سوف لا أقحم الأمور الشخصية في هذا النقد إلّا بمقدار خدمتها للحقيقة الجمعية. ولو كنت أريد أن أقحمها لأمكنني ذلك، ولقلت لكم بكل شجاعة وجرأة وصراحة: “إن الكاتب محمد على طه حين يكتب سيرته الذاتية دون أن يذكر فيها بعض الأسماء، ومن بينهم أنا، محمد هيبي، كاتب هذه السطور، لا يُمكن أن يكون صادقا فيما يكتب. ولكن من جهة أخرى، لا أستطيع أنا أو غيري، أن نطعن بذكائه، فهو بلا شكّ كاتب ذكيّ جدا. فقد وسم كتابه بـ “فصول على هامش السيرة الذاتية”، ليصبح حذف بعض الفصول، أو حذف بعض الأسماء والأحداث، شرعيا، حتى وإن كان في ذلك ضرب بالحقيقة عرض الحائط.
سأكتفي هنا ببعض التساؤلات حول حقائق وأحداث أعتقد أنّه كان على الكاتب أن يُدرجها في كتابه؛ سأطرحها وأترك للقارئ حقّ فهمها وتأويلها وبلوغ دلالاتها:
-
في “نوم الغزلان” ذكر الكاتب الكثير من الأمور السياسية، فلماذا لم يذكر أنّه طلب منّي أن أرافقه إلى قرية مجد الكروم، ورافقته، في قضية سياسية تتعلّق برئاسة مجلس كابول المُعيّن بين الأعوام 1974-1978؟ واعذروني، لا أذكر التاريخ بالضبط، ولكن أذكر أنّي يومها، كنت ولدا صغيرا في أواسط العقد الثالث من عمري، وصديقا لعَلَم أتشرّف بصداقته، وأرافقه حيثما طلب. لم أكن أعرف أنّ الزيارة ستكون لأحد رجال حزب المتديّنين الصهيوني (المفدال)! فلماذا لم يذكر ذلك؟ ألأنّي لا أستحقّ، أم لأنّ الزيارة وموضوعها لا يُشرّفان أحدا؟
-
لماذا لم يذكر شيئا، وهو الكاتب ذو الوعي الوطني منذ نعومة أظفاره، عن بداياته السياسية وعن ثورة الحمامات الشمسية في كابول وغيرها، والملصقات الانتخابية التي اعتلتها وهي تسبّح الله بالعبرية الفصحى؟
-
لماذا لم يذكر شيئا عن أشخاص باعوا أرضهم بعد النكبة للسلطة الصهيونية التي شرّدتنا، بينما يُكثر في كتاباته من تقديم النصائح للإنسان الفلسطيني، كيف يُحافظ على أرضه؟ اقرأوا ما جاء في مقال د. محمد حمد حول “الوعي السياسي في قصص محمد علي طه” حيث يقول: “تتجلّى علاقة الانتماء بالأرض بشكل مكثّف في قصّة “فارس هذا العصر” من مجموعة “وردة لعيني حفيظة”، حيث يرسم طه ملامح ثلاث طرق تقف في طريق الفلسطينيّ لنيل حرّيّته، الأوّل: “طريق السهل” والثاني طريق فيه التنازل عن الأرض والعرض، ولن يدخله الفلسطينيّ الصادق (انتبهوا جيدا لهذه الجملة “ولن يدخله الفلسطينيّ الصادق”). والثالث: “تحرسه غوليّة تدلّى ثدياها واحمرّت عيناها وشمط شعرها، تطحن الملح برحى غريب فإذا شاهدتك فلا سلام ولا كلام بل طحن عظام”، ويختار الفلسطينيّ هذه الطريق، لأنّ فيها المواجهة مع عدوّه”.[8] فلماذا لم يخبرنا الراوي/الكاتب أيّ الطرق الثلاث سلكها هو؟ وهل يحقّ لنا أن نتساءل، ونحن نعرف حقّ المعرفة، أنّ المرحوم أباه لم يبع أرضه بعد النكبة، فمن يا تُرى الذي باعها؟ وهل حقيقة أنّ والده بعد ضياع الأرض، كان ينام نوم الغزلان بسبب قلقه من مصادرة السلطة الصهيونية لأرضه، أم الذي أقلقه هو من غافله وباع الأرض للصهيونية، أو باعها رغما عنه؟
-
لماذا مرّ مرّ الكرام على انتخابات المجلس المحلّي؟ هل لكيلا يذكر أنّه أرسل لي رسولا من أقاربي، يطلب منّي أن أكون مرشّحا بديلا عنه في الانتخابات الأولى للمجلس عام 1978، بعد أن قرّرتْ قيادة حزبنا الشيوعي فرضه على فرعَي الحزب والجبهة في كابول، وترشيحه لرئاسة المجلس، وقد برّر طلبه بأنّه مشغول وليس لديه الوقت لمثل هذا العمل الذي يفرضونه عليه؟! هل فرضوه عليه حقّا؟ وهل يجرؤ أن يكشف الدافع الحقيقي وراء طلبه؟ ألم يكن الدافع هو الضحك على لحيتي ولحى عائلتي ليضمن دعمنا له في الترشيح والانتخابات؟ ألم يكن يعلم علم اليقين آنذاك، أنّنا سندعمه، إن لم يكن إكراما له فإكراما للحزب والجبهة. وكيف يتجاهل أنّنا مع كل الرفاق والأصدقاء عملنا بكل صدق وإخلاص لإنجاحه، وقد كدنا ننجح لولا أخطاؤه الكثيرة وكثرة اتّهاماته التي يمتاز بكيلها للأفراد والجماعات؟! أم أنّه ذكر عضويّته في المجلس ليقول لنا فقط، إنّه إنسان وطني شريف غير قابل للارتشاء؟ (137-140) كيف سأصدّق ذلك وكنّا معا في تلك الفترة، ولم أسمع هذا التخييل المشبوه للواقع، إلّا اليوم من كتابه، “نوم الغزلان”؟
-
لماذا لم يذكر أنّه أطلعني على رغبته بخوض معركة انتخابات المجلس المحلي مرة ثانية عام 1983، ورغبته بأن أكون أنا بالذات من يُرشّحه في الاجتماع المنعقد لذلك؟ ألا يسترجع أحيانا ذكريات لا يُمكن أن يُنسى فيها البانياس السوري المحتل وجلستنا الانتخابية هناك! ألا يظهر من طلبه هذا أنّه لم يكن صادقا حين قال إنّهم حمّلوه عبء خوض الانتخابات وهو غير راغب بذلك؟
-
لماذا مرّ مرّ الكرام على خوضه مرتين، معركة رئاسة المجلس المحلّي في كابول عامي 1978 و1983، ولم يذكر شيئا عن فرعي الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، اللذين وضعا ثقتهما فيه ورشّحاه للرئاسة نزولا عند رغبة قادة الحزب، وناب عنهما كعضو في المجلس من عام 1978 حتى جاءت اللجنة المعيّنة عام 1987؟ هل كلّ ذلك لكيلا يحدّثنا عن حلّ المجلس المحلي؟ وهل كان هو أحد أسباب ذلك؟ وماذا عن مقاومة اللجنة المعيّنة التي صادرت بل اغتصبت إرادة الإنسان الكابولي؟ ألا تستحقّ الذكر؟ هل الناس الذين قاوموها حتى انقلاعها عام 1990، لا يهمّونه؟ فماذا فعل لدعمهم؟ ولماذا لم يذكر شيئا عن أولئك الرفاق والأصدقاء الذين وصلوا الليل بالنهار وعملوا المستحيل لإنجاحه في معركتي الانتخابات؟ هل تجاهل دورهم لكيلا يذكر كيف كافأهم فيما بعد؟
-
لماذا لم يذكر شيئا عن مرافقتي له عام 1987، إلى اجتماع في قرية “نحف” الجليلية، عشيّة حلّ المجلس، في قضية سياسية تتعلّق بتهديد اللجنة المعيّنة التي كانت على الأبواب؟ ألم يكن يعرف أنّ الأمر كان منتهيا واللجنة آتية لا ريب فيها؟ هل كانت الزيارة مجرد براءة ذمّة؟ وهل يعرف اليوم أنّ بعض أطراف الاجتماع ما زالوا على قيد الحياة ويعرفون الحقيقة، وقد التقيت بعضهم لأستذكرها معهم؟
-
لماذا لم يذكر شيئا عن جلسات المجلس المحلي، وأنّه قُبيْل كل جلسة ساخنة، كان يمرّ عليّ في بيتي ليصطحبني معه لحضورها؟ أليس جديرا بالذكر كيف أوقفتُ أنا سير إحدى الجلسات ولم أسمح باستئنافها إلّا بعد أن اعتذر له رئيس المجلس وشخص آخر تفوّه بعبارة اعتبرتُها جارحة له وللحضور؟ هل من العيب أن يعترف الإنسان بحاجته لحارس شخصي ينفع عند وقوع واقعة هو ليس أهلا لها؟
-
لماذا لم يذكر شيئا عن علاقاته بفرعيّ الحزب والجبهة في كابول، قبيل وبعيد انتخابات المجلس المحلي عام 1990؟ ولماذا أنكر أنّه أقيل بعدها، بل طُرد من صفوفهما؟ مجرّد سؤال: ألم تبلغ ممارساته حدّ الخيانة؟ لماذا ادّعى أنّه تركهما وغادر بقراره واختياره، وأنّ بيتهم (الحزب والجبهة) بعد خروجه منه وابتعاده عنه، حين التفت إلى الوراء، رآه يهوي على من فيه؟ أليس هذا ما كتبه في مقال له تلك الأيام، نشره في جريدة “الاتحاد” بعد فصله؟ هل هذا ما كان يتمنّاه، أن يهوي البيت على من فيه؟! وهل طبطب له آنذاك، بعض قادة الحزب وكالوا المديح لأدبه “الوطني” الجميل؟ فهل فهم قادة الحزب مضمون مقاله؟ إذا لم يفهموا فتلك مصيبة، وإذا فهموا فالمصيبة أعظم! وما هو تفسيره، رغم أخطائه وأخطاء القيادة، لبقاء فرعي كابول يحملان مسؤوليتهما كاملة، ولبقائهما من أنشط فروع الحزب والجبهة في المنطقة. وأنّ كل القادة مدينون لهم ومقصّرون معهم، وهم لم يُقصّروا مع أحد، وليسوا مدينين لأحد سوى مبدئهم وحزبهم وجبهتهم.
-
لماذا لم يذكر أنّ الحزب والجبهة قطريا، قد احتضناه وضربا بقرار فصله من فرعيّ كابول عرض الحائط؟ أعرفُ جيّدا أنّ المسؤولية هنا، لا تقع على عاتقه، بل على عاتق قادة الحزب والجبهة. فهل هناك من يقدر على تحمّلها؟
-
لماذا لم يذكر أنّه زارني في بيتي صبيحة اليوم التالي لانتخابات المجلس المحلي عام 1983، وطلب أن أرافقه في جولة في شوارع كابول في سيارته الـ “فيات 127” الصفراء، ليستعرض أمام الناس معنويّاته العالية وعدم اهتمامه بالفشل؟ وهل يجرؤ أن يعترف أنّني في تلك الجولة، وتحديدا في مركز البلدة (المِدْوَر)، منعته من تصرّف لاأخلاقي لا يليق بمراهق، فما بالك بقائد وطني مجرّب، أو كاتب تقدميّ، أو إنسان لديه ذرّة احترام لنفسه وللآخرين؟ وهل قام بذلك لأنّه كان يعرف مسبقا، أنّ “سواد الوجه” سوف لا يقع في النهاية إلّا عليّ و”على لحية إلّي خلّفوني”؟
-
ألم يكن من الشجاعة أن يذكر أنّ فصل الانتخابات العامة حتى أواسط السبعينات، والمحلية في معركتيها عامي 1978 و1983، كان فصلا مشوّها في حياته، لا يُشرّفه الحديث عنه، وأنّه كان ولا يزال مدينا للحزب والجبهة والكلية الأرثوذكسية الذين انتشلوه من الوحل وأمّنوا مستقبله المهني والاقتصادي والأدبي؟ أليست هذه فوائد عظيمة جناها منهم، فماذا جنوا منه؟
-
هل يذكر عبارة “طبّاخ السم بذوقه” وأين استعملها؟ ألم تأتي ردا على توظيف بعض أقاربه في مؤسسات حكومية لا يصل إليها إنسان معادٍ للسلطة؟
-
ألّا يعتقد وهو عرّاب “المشتركة”، أنّ مسألة “حكّلّي تَ أحكّلّك” في مجتمعنا، مع الأفراد، أنفارا وقادة، قد استشرت، وتحتاج إلى دراسة جريئة ومخلصة، قد يراها البعض لن تقدّم أو تؤخّر شيئا، في تاريخ شعبنا المثقل بالأحزان؟
-
لماذا لم يُخصّص فصلا خاصا بقرية كابول التي احتضنته وما زالت؟ أين الناس الذين منحوه في معركتين انتخابيّتين، ما يُقارب الـ (50%) من أصواتهم؟ أين مكانهم في سيرة كاتب وطني يحترم شعبه وتضحياته، ويحترم أهل بلدته وما قدّموه له؟ ماذا قدّم هو لهم؟ وإذا كانت كابول ليست مهمّة في مسيرته الاجتماعية والسياسة والأدبية، فلماذا زحف، وزحف معه من جنّدهم ليستجدوا من بعض المسؤولين أمسية لإشهار كتابه في كابول؟
عزيزي القارئ، أنا لم أتسرّع في الحكم حين حكمت، وأطلب منك إذا قرأت الكتاب ألّا تتسرّع فيه، نزولا عند قوله تعالى: “ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” (البقرة، 232). ولكن اعلمْ أنّ ما قدمتّه هو غيض من فيض تساؤلات قد يصعُب حصرها. قدّمتها بكل أمانة لأهميّتها، ليس في حياة الكاتب محمد علي طه فحسب، وإنّما في حياة أناس آخرين عاشوها معه. وقد طرحتها وأنا أعترف بحقّه بالردّ أو الصمت. وإذا كان ما طرحته عليك عزيزي القارئ لا يكفيك، فلن يكفيك شيء!
سأستعرض الآن بعض العيّنات من “نوم الغزلان”، وما ورد فيه من أحداث وحقائق تمّ تزييفها، ليس لأنّها أثارت غضبي واشمئزازي فقط، وإنّما لأنّ فيها من النرجسية ما هو كافٍ لإثارة غضب واشمئزاز الكثيرين ممن سيقرؤون الكتاب، فما بالك بتزوير التاريخ وتزييف الحقائق وظلم الآخرين والتجنّي عليهم؟!
النرجسية وإلغاء الآخر:
النرجسي هو إنسان يُعاني من عقدة نقص تُؤدّي إلى اضطراب في شخصيته، يُرافقه شعور بالغرور والتعالي والأهمية ومحاولة الكسب ولو على حساب الآخرين. في بحث شاركت فيه سوزان كراوس وايتبورن، الباحثة في علم النفس وعلوم الدماغ، بيّنت فيه كيفية تحديد الأشخاص الذين تكون لديهم النزعة النرجسية مرتفعة. تقول: “يمكن تمييز الأشخاص المصابين بالنرجسية المرتفعة على الفور، فهم مصابون بجنون العظمة، ويحاولون باستمرار لفت الانتباه إليهم ولو على حساب الآخرين. يشعر هؤلاء بأنّ لهم الحقّ في تلقي معاملة خاصة وينتابهم الغضب حال عدم حصولهم عليها”. وخلصت الدراسة إلى استنتاج هامّ هو أنّه في الأيام التي تكون مشاعر النرجسية بها مرتفعة لديهم، فإن ذلك يصاحبه انخفاض في تقدير الذات. أمّا مشاعر الغضب والشعور بالذنب والخوف لديهم، فيمكن أن تؤدي إلى شعور الشخص بالحاجة للحماية ضدّ ما قد يراه إهانة له أو استخفافًا به، ما يقوده إلى أن يصبح متغطرسًا واستغلاليًا بشكل أكبر.[9] كما قدّمتْ الدراسة ستّ دلالات لتحديد أصحاب المشاعر النرجسية المرتفعة، أذكرها بإيجاز:
-
تكون ردود أفعالهم عنيفة حال شعروا بمعاملة سيئة.
-
يزعجون من حولهم بأساليب غير مفهومة.
-
يظنّون أنّ المبادئ لا تنطبق عليهم ويقومون بخرقها بشكل دائم.
-
يصعب توجيههم وإرشادهم.
-
يقومون بتغيير مواعيدهم وجداولهم الزمنية دون سبب.
-
يتحدّثون بطريقة تلفت الانتباه إليهم.
لا أعتقد أنّ هناك شخصا، سواء كان ناقدا أو قارئا عاديا، يعرف الكاتب محمد علي طه شخصيا أو قرأ بعض كتاباته، ولم يُلاحظ لديه تلك المواصفات أو بعضها.
رائحة النرجسية تفوح من كتابات محمد علي طه عامة، ولكنّها في “نوم الغزلان” تُطلّ من كل صفحة، وبكثير من التجاوزات المرفوضة. وقد أوردت لكم عينة “المعاطف”، وهناك الكثير مثلها. مثلا عندما يقول: “لا أستطيع أن أشير إلى مدرّس أثّر عليّ في دراستي الابتدائية” (75). يقول ذلك رغم اعترافه بأنّه تعلم في الصف الرابع في كابول، قصيدة “الحمّى” للمتنبّي (76). والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كان في كابول في تلك الفترة، بُعيد النكبة، أطفال قادرون على تعلّم شعر المتنبّي عامة وهذه القصيدة خاصة؟ والأهمّ من ذلك: هل كان في كابول آنذاك، مدرّس قادر على تعليم تلك القصيدة العظيمة؟ وإذا افترضنا وجوده، هل يكون مثل ذلك المدرّس عاجزا عن التأثير على طلابه الصغار؟
تظهر النرجسية كذلك، في إشاراته القليلة إلى مرافقيه في سفراته ونشاطاته. وكذلك في ذكره لأشخاص مهمّين، ككبار الكتّاب والمفكرين والقادة السياسيين وغيرهم. ومعظمه تخييل لواقع غير موجود في الواقع. وخاصة عندما يُصوّرهم وكأنّهم هم الذين يُبادرون لدعوته أو لقائه من منطلق حاجتهم له. أو عندما يتصل به بشكل عادي جدا (خارج البروتوكول)، شخص مثل الرئيس ياسر عرفات، ويدعوه للإفطار معه، كأنّ الأخير إنسان مسكين تقتله الوحدة لا يجد ما يفعله، أو من يُسامره. والأمر ذاته يظهر في زياراته المتكرّرة له، وكأنّ الرئيس لم يكن يتدبّر أمره لولا وجوده (235-239). قد نقول التخييل، ولا بأس في ذلك. ولكنّ هذا الخيال الجامح، شاء كاتبنا أم أبى، يُعبّر عن شعور بالنقص دفع صاحبه إلى الشعور بالعظمة والحاجة إلى مقابلة ومصاحبة العظماء. ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ، فقد تجاوزه إلى التفريط بالآخَر إلى حدّ إلغائه وقتله. والأمثلة على ذلك كثيرة سيظهر بعضها فيما يلي:
الرواية “تاريخ من لا تاريخ لهم”، على حدّ تعبير الروائي الكبير، عبد الرحمن منيف، أفلا يستحقّ أن يُذكَر بالاسم، ذلك الشاب الذي قدّم للراوي/الكاتب بصلة في مظاهرة تساقطت فيها قنابل الغاز، ثم قال له: “لماذا جئت إلى المظاهرة؟ مكانك ليس هنا. نحن بحاجة إليك!؟ (225). أليس هذا هو جنون العظمة بعينه؟ أليس هذا هو الشعور بالأهمية لدرجة أنّ جميع الناس، كبارهم وصغارهم، بحاجة إليه، وهو ليس بحاجة لأحد؟
في فصل “سنوات في الحزب”، نجد أنّ القائد الشيوعي الراحل، الشاعر توفيق زياد، لامه على توقيت انتسابه للحزب، وأنّه كان يجب أن يكون في اجتماع سياسي حاشد، لكي يكون له زخم سياسي وحزبي. يقول: “كان عليّ أن أعلن انتسابي في اجتماع جماهيري في بيت الصداقة أو في ساحة الأول من أيار في الناصرة” (166). كيف تمّت تلك القفزة من ماض سياسي تمّ التعتيم عليه في الكتاب، من ستينات حتى أواسط سبعينات القرن الماضي، أي قبيل انتسابه للحزب؟ كيف صار فجأة، قائدا شيوعيّا ووطنيّا من الصفّ الأول؟ أما كان يجدر به أن يذكر ماضيه السياسي وانتقاله من النقيض إلى النقيض، فيقول كنت أعمى وأبصرت، أم أن البصيرة لم تتغيّر والذي تغيّر هو البصر منطلِقا من عقدة الشعور بالنقص ملبّيا هاتف “الأنا”!
وعلى سبيل المثال لا الحصر، كيف صار بكلّ تلك السرعة، قادرا على الاختلاف في الرأي مع قادة الحزب حول ترتيب لائحة الانتخابات مثلا، وعلى إقناعهم بتشكيل “اتحاد الكتّاب العرب” (169). فهل يكذب ذلك الرفيق القديم الذي أخبرني أنّ الرفيق إميل حبيبي هو صاحب الفكرة، بينما يقول صاحب “نوم الغزلان” إنّ قادة الحزب والجبهة كانوا معارضين ولا يرغبون بتأسيس هذا التنظيم (180)، وهو من أقنعهم؟ وهو يذكر كلّ تلك التفاصيل وكأنّ الاتحاد لم يقم إلّا به. والسؤال: إذا كانت فكرة اتحاد الكتّاب هي فكرته هو، وهو من أقنع قادة الحزب بها، فكيف لم يتمكّن من إقناعهم باختياره رئيسا أول للاتحاد؟ هل ترفّع عن المنصب؟! أترك الإجابة لكم ولرّفاقي العالمين ببواطن الأمور!
وفي الفصل نفسه، وبشكل مضحك ومثير للسخرية وغير موثوق، يذكر كيف فاوضه الحزب على طريقة استقالته من الحزب، التي تشي كأنّه عندما انتسب للحزب، انتشله من القاع أو من الوحل، وأنّ الحزب لم يعرف كيف يُحافظ عليه ويستثمر قدراته العظيمة، وكأنّ الحزب، سيعود إلى القاع أو الوحل إذا أعلن هو عن استقالته منه. أليس هذا ما يُفهم ممّا يذكره من محاولات قادة الحزب المتكرّرة لإقناعه بالعدول عن استقالته، وكذلك من نقاشه الهادئ معهم، والذي انتهى بخضوع الحزب وقبوله بشروطه، أن يستقيل بدون شوشرة صحافية، أي أن يقبلوا استقالته ليتنازل عن التهديد بالذهاب إلى الصحافة! يقول: “أن يقبل الحزب استقالتي وعلى ألّا أصدر بيانا للصحافة حول ذلك. وهكذا افترقنا عام 1992، ولم يعلم الكثيرون من رفاق الحزب ومن الناس بهذا الفراق” (171). محمد علي طه يُهدّد الحزب باللجوء للصحافة! يا لعار حزبي وشهامة محمد علي طه! ضحكت منهما حتى استلقيت على ظهري. هل كان حزبي بهذا الضعف وبهذه المهانة؟ ما باله يحتفي بـ “نوم الغزلان” ولا أحد فيهم يُحرّك ساكنا حيال هذا الكلام الذي حين قرأته، تذكرت المقولة الشعبية، “إللي استحوا ماتوا” وترحّمت على قادة الحزب الأحياء قبل الأموات، وكذلك على السيد سايكو رغم قسوته وانعدام إنسانيته!
وسؤال آخر يطرح نفسه: هل يُمكن أن يكون وسيطا نزيها بين الحزب والشاعر سميح القاسم، من يدّعي أنّه “حاول أن يكون وسيطا بينهما “كي يبقى سميح في الحزب فنقلت مواقف الطرفين محاولا جسر الخلاف فالتوفيق” (253)، أي أن يقنع سميح بعدم الاستقالة من الحزب، بينما استقال هو بعده مباشرة، عام 1992؟ ألم تكن استقالة سميح القاسم هي الضوء الأخضر الذي انتظره الراوي/الكاتب بفارغ الصبر، ليستقيل هو أيضا؟
وفي فصل “الذكرى الخمسين للنكبة”، يصوّر الكاتب نفسه عام 1998، وكأنّه صاحب فكرة الاحتفال بذكرى النكبة ومن عمل على تنفيذها بتنظيم المسيرة الأولى إلى “صفورية” ذلك العام. رحم الله قادة الحزب والجبهة، هل ماتوا جميعا؟! كما يُصوّر نفسه بطلا قوميا في المواجهة البطولية مع رجل الموساد، غدعون عزرا، في التلفزيون الإسرائيلي في برنامج زهير بهلول، “دردشات”، حول موضوع النكبة والاحتفال بذكراها الخمسين. وصار بعد طرح الفكرة هدفا للصحافة الإسرائيلية (191-197).
وفي فصل “نصائح مجّانية”، يذكر أنّ د. يوسي بيلين، وزير العدل الإسرائيلي في حكومة “براك” آنذاك، هاتفه في صباح يوم ما من شهر كانون الثاني 2001، وطلب مقابلته، فرفض مقابلته في مكتب حزب العمل في حيفا أو في بيته في كابول، لأن زيارته لها إسقاطات سياسية وانتخابية، وتمّ لقاؤهما في فندق ماريوت في نتسيرت عيليت، دون أن يذكر تاريخ اللقاء رغم أنّه يقول: “حدّدنا تاريخ اللقاء والساعة”. ويُظهِر نفسه هنا، وكأنّ بيلين استنفره ليطلب مساعدته ونصيحته في كيفية إقناع الناخب العربي بالتصويت لإيهود براك وإسقاط شارون في انتخابات عام 2001 (201-202).
انتبهوا كيف لم يُحدّد تاريخ يوم المهاتفة، (يوم ما من كانون الثاني)، والانتخابات جرت في 6/2/2001، ما يعني أنّ اللقاء إذا تمّ، فقد تمّ على الأكثر، قبل الانتخابات بشهر واحد، أو أقل من ذلك بكثير. وهذا يعني أنّ حزب العمل قد شعر بورطته مع الناخب العربي، بعد جريمته في انتفاضة عام 2000، ولم يجد له مخرجا إلّا مشاورة الكاتب محمد علي طه! وكأنّ حزب العمل خسر وكذلك براك، مرشحه لرئاسة الحكومة، أمام شارون، لأنّه لم يعمل بنصيحته حين اقترح على بيلين، إعلان حكومة براك التزامها بعودة أهل القريتين (إقرث وبرعم) إلى قريتيهما (201-202). أترك التعليق لكم! ولكن لا بدّ أن أعلمكم بأنّني حاولت حتى ساعة إغلاق هذا المقال، أن التقي د. يوسي بيلين ولم أفلح؟
جدير بالذكر أنّ معظم المعلومات التي يُدلي بها في كتابه تخلو من التوثيق المطلوب وتحتاج إلى إثباتات، خاصة وأنّ معظم شهودها أصبحوا في ذمة الله. وإذا كانوا على قيد الحياة، فهم من النوع الذي يشكّ الراوي/الكاتب بأنّ القارئ سيبحث عنهم ويتحدّث إليهم. أفلا يحقّ للقارئ وهذه الحال، أن يشكّ أنّه اختلق الأحداث وشوّهها. وحتى لو كانت حقيقية، فقد غيّر فيها وفصّلها على مقاسه الذي يفوق كلّ مقاس؟ وهل من هدف غير النرجسية وغرور العظمة اللذين لا يصدران إلّا عن شعور بالنقص وانخفاض في تقدير الذات؟!
تجاهل الأسماء!
هناك أشخاص أهمل الكاتب أسماءهم، وذكر أسماء آخرين رغم أنّهم ليسوا بأهمية من تجاهل أسماءهم. ولذلك دلالة تُفيد نرجسية الكاتب أو شعوره بالذنب. وإليكم بعض الأمثلة:
-
عند ذكره لأشخاص من “ميعار”، كان يذكر أسماءهم الشخصية فقط، أو يقرنها بأسماء آبائهم ولا يذكر أسماء عائلاتهم. وتفسيرا ذلك أنّ اسم مختار “ميعار”، مرعي الحسن (21)، أو “الحاجّ مرعي عمّ والدي” (26)، أو “مختار القرية الحاجّ مرعي الحسن” (34)، ذكره بهذا الشكل لأنّه لا يريد لاسمه أن يرسخ في ذهن القارئ كواحد من عائلته. فالمختار، اسمه الثلاثي هو “مرعي حسن طه”. وحسب رواية الراوي/الكاتب، هو من حمل الراية البيضاء وفاوض الضابط اليهودي لتوقيع وثيقة الاستسلام (43). وكذلك اسم نعيم عبد الحميد الذي اقترح الاستسلام (28) هو نعيم عبد الحميد طه. ولنفس السبب، رغم موقفه الوطني، أهمل مضطرا، ذكر اسم عائلة أحمد الحسين (طه)، الذي شتم المختار ومؤيّديه واتّهمهم بالعمالة والخيانة (34). ومن اللافت أنّ الرجلين: مرعي الحسن وأحمد الحسين، هما عمّا والد الراوي/الكاتب. كأنّه يريد أن يقول للقارئ: عائلتنا ككل العائلات، فيها الخائن وفيها الوطني!
-
لم يذكر اسم أيّ واحد من المتحدّثين، في أمسية هامّة حول محمود درويش! إلّا نفسه حين قال: “ودعيتُ لأكون من المتكلّمين في الأمسية”، بينما اكتفى بالقول “تحدّث أستاذ يهودي عن شعر محمود درويش”، ولم يذكر اسمه (16). هل هي عقدة النقص ورهاب الأسماء الكبيرة التي يخشى أن تطغى على اسمه؟
-
والأمر ينطبق على فصل “البدايات” وإخفائه اسم رئيس تحرير الجريدة الذي أرسل له رسالة “يدعوه إلى لقاء معه في مقهى فينّا في مدينة حيفا” (100)، ثم خذله لصغر سنّه. وبعد سنين، أي بعد أن أصبح كاتبا معروفا، أرسل له رئيس التحرير ذاته، رسالة أخرى “يدعوه للقائه في مقهى على جبل الكرمل”. عاقبه بأن حضر وراقبه وتركه يتأفف إلى أن انصرف (103). من الملاحظ أنّه لم يذكر اسم الشخص ولم يذكر اسم المقهى الثاني أيضا! والأهمّ من ذلك، هو أنّ أحد أولاده لامه على تصرّفه، ووصفه ببدوي يبغي الانتقام (103)، وهذا يدلّ على أنّه غير راضٍ عن تصرّفه، وأنّه غير صادق، حتى لو كان ذلك صحيحا حين يقول: “عندما كنت كاتبا مبتدئا فقير الحال لم يُعاملني باحترام، أنا لست بحاجة إليه اليوم. أنا كاتب معروف وقصصي تُنشر في كبرى المجلّات العربية” (103). أليس هذا اعتراف أنّ تصرّفه ليس فيه نبل، وهل من الغريب أنّ يكون تصرّفه امتدادا للتصرّف غير النبيل الذي اختلقه لرئيس التحرير!
-
ما الذي منعه من ذكر اسم المثقّف المناضل الفلسطيني (162)، ومن ذكر أسماء المشاركين في أكثر من حدث (170)، مع أنّ ذكرهم يزيد من موثوقية الخبر وثقة القارئ بالكاتب.
-
لم يذكر اسم القرية واسم القائد الشيوعي المحلي الذي دعاه كقائد شيوعي لإلقاء محاضرة، وهو يجهل أنّه ترك الحزب (171). ألا يظهر في تعامله مع قادة الحزب وكأنّه يقول: ما أغبى هؤلاء الشيوعيين الذين اخترقت حزبهم بهذه السهولة، ولم أكن يوما منهم؟!
-
من هو الشاعر العربي الكبير الذي أرسل له قصيدة من أوروبا؟ (175). أكثر من صديق قال لي إنّه يقصد الشاعر نزار قبّاني وأكّد لي أنّ ذلك لم يحدث.
-
ص (203-206)، يذكر أدب الأطفال بنرجسية مفرطة. ولكن الطريف هو إخفاء اسم الكاتبة التي “سرقت” قصته. وقد نفهم شهامته في عدم ذكر اسمها، ولكن ما العيب في ذكر اسم المدرسة التي استضافته والمديرة التي دعته؟ (205-206). وإضافة لأدب الأطفال، يقول: “صدر لي حتى اليوم عشرون قصّة أطفال وما زال على طاولة مكتبي عدّة قصص تبحث عن ناشر” (206). أليس غريبا كيف تبقى قصص كاتب كبير وبهذه الشهرة، على طاولة مكتبه، ولا يتهافت الناشرون عليه لنشرها؟ هل هذا أيضا من جملة تناقضاته اللاواعية!
-
في فصل “أيام الاجتياح”، يقول: “حاجز قلنديا كان مختلفا تلك المرة، آذار 2001، عن السنة الماضية … وصلت الحاجز مع كوكبة من الأدباء والشعراء والفنّانين لنزيل الحاجز … وأزلنا الحواجز وألقينا الكلمات” (225). ليس مهمّا الآن كم هي مضحكة هذه العبارة، “أزلنا الحواجز”، ولا كيف أزالوها، ولكن لماذا لم يذكر من هم أولئك الأدباء والشعراء والفنّانون الذين رافقوه لإزالة الحاجز؟ ألم تكن بطولة من حقّهم أن يُذكَروا بها، وحقّهم وحقّنا أن نعرفهم؟ أم أنّه كان البطل الأوحد هناك؟ كما أنّ هذه الزيارة العظيمة للحاجز، تمّت في الشهر الذي تلا الانتخابات التي هُزِم فيها براك أمام شارون. فهل لذلك من دلالة أجهلها؟
-
في فصل “أهداني قبلة لحفيدي”، يقول: “رافقني (إلى غزة) رجل أعمال معروف وأستاذ جامعي والسيدة حنان حجازي (236). مع كل احترامنا للسيدة حنان حجازي وجهودها، لماذا يذكرها بالاسم ولا يذكر اسمي رجل الأعمال المعروف والأستاذ الجامعي؟ هل قالا له مثلا: “تِفْضَحْنَاش”!
-
من الشاعر الشاب الذي رافقه إلى كفر مندا ليلقي قصيدة في اجتماع شعبي؟ (260). ألا يستحقّ ذكر اسمه كشاعر وطني ناشئ؟ أليس من مهامّ كتّابنا الكبار رعاية كتّابنا الناشئين الصغار وتعريف الجمهور بهم؟ أم أنّ قادتنا الثقافيين كقادتنا السياسيين، أقليّةً وأمّةً، حين يصلون إلى الكرسي؟ هل هكذا يفهم الراوي/الكاتب الهيمنة الثقافية عند غرامشي؟
-
من هو المحامي الوطني المعروف الذي التقاه في مدينة الناصرة وقال له: “سيكتب التاريخ أنّك كنت المهندس للقائمة المشتركة؟” (263). هل يخاف أن نسأله؟
هذه عيّنات قليلة من كمّ كبير يعجّ به الكتاب. وكان الراوي/الكاتب يستطيع ذكر الأسماء التي أهملها بدون أي حرج. فهل هناك دافع آخر لإهمالها غير رهاب هذه الأسماء وقصد طمسها لتخلو الساحة لعظمة الراوي/الكاتب وإبراز منجزاته؟ ألا يُدرك أنّ ذكر تلك الأسماء يُفيد الحقيقة ويدعمها ويزيد من مصداقيته وثقة القارئ به؟ ولا أنكر أنّه قد يكون في بعض هذه الأحداث بعض الصحة، لكنّها في كلّ الأحوال تُضَخَّم وتشوَّه بقدر ما تحتاجه نرجسيّته.
والد الراوي/الكاتب!
لو أراد الراوي/الكاتب محمد علي طه في كتابه أن يُرضي شيئا غير ذاته، أو “يُنصف” أحدا غير نفسه، لأنصف والده. كلّ ميعاري جاوز الستّين من عمره يعرف أن المرحوم الشيخ علي عبد القادر طه كان قبل النكبة وبعدها، رجلا بسيطا يكدح من أجل تأمين لقمة العيش لأولاده. وقد لامس الكاتب هذه الحقيقة بكلمات قليلة بعد النكبة فقط، أما قبل النكبة، فقد صوّر والده كبطل وطني يحمل بندقيته ويُشارك في ثورة 1936، وفي معركة الليّات المشهورة، (70-71) وأنّه كان يعرف الحاج أمين الحسيني والقائد عبد القادر الحسيني، ويعلّق صورتيهما في بيته؟ (21) لماذا يُنكر أنّ والده قبل النكبة كما بعدها كان رجلا بسيطا يكدح من أجل إطعامه وتعليمه؟ ألا يعرف أنّ هناك رجالا من “ميعار”، أكبر منه سنّا، وما زالوا على قيد الحياة ويعرفون الحقيقة كاملة؟ وقد التقيت بعضهم وسألتهم عمّا قاله، فما كان منهم غير أن ضحكوا وشتموا الكاتب لوضعه أباه موضع السخرية. ما الذي أضافه الكاتب محمد علي طه، لوالده غير السخرية والشتيمة ممن يعرفونه، ولنفسه غير الانتفاخ الكاذب والتدليس على القرّاء الذين لا يعرفونه؟ وهل يعرف وهو الضالع بتوظيف التراث، المثل الشعبي الذي يقول: “الولد الشوم بجيب لأهله المسبّة”. وهل يقبل عاقل أن يُعرّض والده الذي كدح طيلة عمره لإطعامه وتعليمه، للشتيمة والسخرية؟ أليس من حقّ القارئ أن يشكّ بأن وراء الأكمة ما وراءها؟ فما الذي أراد أن يُخفيه وراء هذه البطولات المزعومة؟ ألم يُلطّخ صورة أبيه البسيطة النقيّة، خاصة وأنّ كل ميعاري، وكل كابولي، تجاوز الستّين من عمره، يعرف أنّ الشيخ علي عبد القادر، والد الراوي/الكاتب، لم يبع أرضه للسلطة الصهيونية، فهل يستطيع الكاتب أن يُخبرنا من باعها؟ ألا يحقّ لنا، كما اسلفت، أنّ نشكّ أنّ أباه لم ينم نوم الغزلان حسب تفسيره هو، أي بسبب مصادرة السلطة الصهيونية لأرضه، وإنّما نام تلك النومة القلقة بسبب من غافله وباع أرضه للصهيونية، أو باعها رغما عنه؟
وفي سياق آخر، قد نفهم الحرمان العاطفي الذي عاشه الراوي/الكاتب من خلال حديثه عن علاقاته هو بالنساء، ولكن لماذا أصرّ أن يُعبّر عن حرمانه هو، من خلال الحديث عن علاقات والده مع النساء؟ يقول: “روى لي بعض مجايليه (والده) له علاقات مع بعض صبايا القرية، وقد تكون علاقات بريئة ولكن البعض يُضخّمها، إلّا أنّ قصته مع “الجفرا” فقد كانت حديث القرية (62). هل يعني أنّ قصة والده مع “جفرا” كانت معروفة أم مفضوحة! أليس في حديثه هذا تضخيم لما لامَ الناسَ عليه حين قال: “البعض يُضخّمها”؟ ماذا أراد من وراء ذلك؟ ماذا أراد بحقّ السماء من إقحام والده في مثل هذا الموضوع الحسّاس، وفضحه بهذا الشكل المخجل حتى لو كان ما قاله حقيقة؟! لماذا لا يذكر حقيقة واحدة مخجلة تتعلّق به هو؟ هل حسِب أنّ في ذلك احتراما لأبيه؟ هل يعتقد أنّ هناك من سيُشاركه الرأي؟! هل يُفكّر بالآخرين أصلا، إلّا إذا كان التفكير بهم يخدم غروره؟ أليست هذ القضية، هي أيضا نابعة من عقدة النقص التي تبحث عن أب عظيم يليق بكاتب أعظم؟
السخرية في غير موضعها!
هناك أمور في الكتاب لم ينتبه لها، أو أهملها النقّاد الذين كتبوا عن الكتاب. منها السخرية، وهي جديرة بأن تُذكر. يذكر النقّاد أن محمد علي طه وظّف السخرية في كتاباته بشكل جيد. ولكن للأسف، في “نوم الغزلان” وظّفها بشكل سيّء وفي غير موضعها! فهل هذا هو سبب إهمال النقّاد لها؟
في مقال له، يُبرّر صديقي الناقد نبيه القاسم عدم الدقّة في الحقائق التاريخية، بأنّ محمد علي طه لا يكتب تاريخا، وهو بالتأكيد يعرف أنّ الرواية، شاء أم أبى، هي كما أسلفت، “تاريخ من لا تاريخ لهم”. كما أنّه لم يتوخّ الدقة حين قال إنّ محمد علي طه نشر قصته الأولى “متى يعود أبي” في صحيفة “الاتحاد” الشيوعية.[10] والحقيقة أنّه نشرها في صحيفة “المرصاد” الصهيونية (99). فهل سقط ذلك سهوا؟ وهل سيطالب الكاتب محمد علي طه صديقه نبيه بالاعتذار أو التصحيح، كما طالب الناطق بلسان اتحاد الأدباء الفلسطينيين – الكرمل؟ أم أنّ هذا كان خطأً محمودا يُسعده ويخدم “وطنيّته” ونرجسيّته؟
السخرية تقنيّة يُوظّفها الكاتب لغايات كثيرة قد يكون أبرزها: التعبير عن الألم والقهر، كشف الظلم وتعرية السلطة الظالمة وفضح ممارساتها القمعية، نقد الأفكار والأشخاص والمجتمع، استفزاز القارئ وتثويره لكيلا يظلّ على الحياد، وغير ذلك.
في كتاباته، أجاد محمد علي طه في توظيف السخرية رغم ما فيها من تكلّف أحيانا. ولكنّ في “نوم الغزلان”، أساء توظيفها بشكل مثير للاستهجان، فهو لم يُخفق في بنائها، وإنّما أخفق في اختيار الهدف الذي وجّهها إليه. فقد وجهها أحيانا إلى الإنسان المظلوم، بينما كان يجب أن يُوجهها إلى السلطة الظالمة. أو وجّهها إلى الإنسان الذي يخشى مواجهته، لأنّه يشعر بالنقص أمامه، فعبّر عن ذلك، ككل النرجسيين، بشكل عنيف يقمع الغير أو يُسيء إليه. والأمثلة لذلك كثيرة. ذكرت سابقا السخرية من أصحاب العباءات والقنابيز، الأدبية وليس السياسية. لو سخر من أصحاب العباءات والقنابيز السياسية أو السلطوية لشددنا على يده. والطريف في الأمر أنّ النقّاد الذين كتبوا عن الكتاب، هلّلوا له ككاتب ساخر، ولم يلتفت أحدهم إلى ذلك التوظيف الخاطئ، وربما المقصود، للسخرية. وذكرت أيضا السخرية المبطّنة من المعلمين وقصيدة “الحمى”، ولكنّ الراوي/الكاتب، ومن بداية الكتاب، في فصل “أوّل الكلام”، سخر أيضا من طلاب المدارس التي احترمته ودعته لتثقيف طلّابها، حين يقول: “قَصّة الشعر التي تتباهون بها … كنّا نسميها “قَصّة الكرار”، والكرّ هو الحمار الصغير أو ابن الحمار” (10). ماذا يمكن أن نفهم من هذه العبارة غير “إنّكم أيّها الطلاب، حمير صغار أولاد حمير كبار”؟ هل هذا أسلوب تربويّ أو أدبيّ سنقنع به طلابنا بخطأ سلوكهم، وبه سنُفلح بإقناعهم بالعدول عنه وتغييره؟!
التناقض (Paradox)، هو تقنيّة من تقنيّات السخرية. ولا أقصد هنا الحديث عن توظيفها في الكتاب. ولكن، لفت نظري في أكثر من موضع، وقوع الراوي/الكاتب في تناقضات لم يوظّفها كتقنية للسخرية، وإنّما ناقض نفسه فيها، فظهرت كأنّها تفجّرت لديه من اللاوعي، أو عن طريق الخطأ. ويظهر فيها وهو لا يدري أنّه يسخر من نفسه، أو يُثير سخرية القارئ منه. ففي فصل “أيام الولدنة” مثلا، يقول: “وما كنت أشاركهم في سرقة البيض أو الديوك فقد علمني والدي ألّا أسرق وألّا أكذب وكان يُحذّرني بأنّ من يأكل حراما لن يُوفّقه الله” (59). لا أشكّك في نوايا والده بالتربية السليمة المتّبعة آنذاك، ولكن الكاتب نفسه يُشكّك بصدقه هو في الصفحة نفسها حين يقول: “وفي شهري شباط وآذار كنت أغير مع أترابي على أشجار اللوز التي في كروم القرية ونقطف الثمر ونملأ جيوبنا منه ونهرب وأمّا في شهر حزيران فكنّا نسرق الحصرم” (59). هل سرقة البيض والديوك حرام، وسرقة اللوز والحصرم حلال؟ أم أنّ اللاوعي يفضح صاحبه، فيُظهره على الأقلّ لا يستوعب كلام أبيه أو لا يحترمه، أو ربما أكثر من ذلك؟
وفي فصل “زمن الطفولة الضائعة” يُصر على أنَ شهادة ميلاده قد ضاعت مع كواشين الأرض ومعها كلّ أوراق والده، وأنّ والديه نسيا تاريخ ميلاده (19). ويعود ليناقض نفسه في فصل “الطبيب رغم أنفه” حين يقول: “وكان أحد أعمام أمّي يُلقّبونه “التاريخ” لأنّه كان قارئا كاتبا وعلى معرفة بتاريخ العرب والبلاد. وكان يُسجّل أحداث البلدة والعائلة في دفتر سميك وبقلم كوبيا. كان يُدوّن تاريخ ميلاد كل طفل يولد في القرية وتاريخ زواج كل رجل وامرأة وتاريخ وفاة أي رجل” (60). فأين ذهب عمّه الذي نعته بـ “وزارة داخلية محلية”، وأين ذهب دفتره؟ هل ضاعت جميع أوراقه، أم نسي الرجل أن يُسجل تاريخ ميلاد الراوي/الكاتب بالذات؟ وكيف عرف أنّه ولد عام 1941، أم أن هذا التاريخ سُجّل تخمينا؟ كاتبنا لم يخبرنا بشيء من هذا!
الجوائز التي ذكرها الكاتب، وتلك التي أهمل ذكرها!
في فصل “باقة ورد” (151-154)، يقول الراوي/الكاتب: “عندما باشرت بكتابة القصة القصيرة في أواخر الخمسينات من القرن العشرين لم أفكّر بجائزة أو بمكافأة، ولم أحلم بمبلغ ماليّ” (151). قد يكون هذا الكلام صحيحا آنذاك، عندما كان صغيرا وكانت الأشياء كلّها أكبر منه، أو لم يكن يدركها أصلا. ولكن الحقائق لاحقا، نفت هذا الكلام جملة وتفصيلا. فكلّ الوسط الثقافي يعرف أنّه سعى إلى المال والجوائز كما لم يسعَ إليهما كاتب قط. بالنسبة للمال مثلا، أعرف جيّدا أنّه اشترط على إدارة جريدة “الاتحاد”، أن تدفع له مقابل كل قصّة أو مقالة ينشرها، وأنّه دخل مرّة في خصومة مع إدارتها لأنّها أوقفت الدفع، أسوة بباقي الكتّاب الذين لا تدفع لهم، وهم لا يُطالبونها بالدفع، بل كانوا وما زالوا يشكرونها على النشر.
أما بالنسبة للجوائز، فيذكر في الفصل المذكور أعلاه، أنّه حصل على ثلاث جوائز من السلطة الفلسطينية، ولا يذكر الجوائز التي حصل عليها من السلطة الإسرائيلية، مع أنّها مساوية لها في العدد! ويكتفي بذكر الجائزة الإسرائيلية التي لم يحصل عليها. وهي تلك التي أخبره بها أستاذ جامعي لا يذكر اسمه، التقاه مصادفة وأخبره أنّ ثلاث شخصيات بارزة من اليسار الإسرائيلي، لا يذكر أسماءها كذلك، تبحث عنه لمنحه جائزة مالية متواضعة باسم الشهيد سعيد حمامي. فأجابه: “لا حاجة لجوائز” (151). سبحان الله، الكل منذ فجر التاريخ يبحث عنه ويسعى وراءه وهو لا يسعى وراء أحد! وربما كذلك هي الجوائز! فهل كلّهم مخطئون، أولئك الذين يتهامسون أنّ العلاقة بينه وبين المال والجوائز، كعلاقة طالب العلم بالحديث الشريف، “اطلب العلم ولو في الصين”، بينما العلاقة بينه وبين الأصدقاء في اضمحلال مستمرّ، ولستُ بحاجة لمن يؤكّد لي ذلك.
لن أناقش هنا ما إذا كان يستحقّ الجوائز التي حصل عليها لكيلا أقحم تقييمي الشخصي! ولكن أتساءل: هل أتته الجوائز أم أتاها واستجدى مانحيها؟ على الأقلّ فيما يتعلّق بالجائزة الأخيرة عام 2015، قال لي أكثر من صديق، بعضهم من داخل وزارة الثقافة الفلسطينية: “أكل لحمة وجه فلان وعلّان”. وفلان وعلّان أعرفهم، ولا ينفون ذلك. وعلى فكرة، بعضهم قرأ “نوم الغزلان” وهو غير راضٍ عنه. أمّا بالنسبة للجوائز الإسرائيلية، فكل المثقّفين والكتّاب المحليين يعرفون أنّه كان يقول إنّها حقّ لنا. وقد حصل مرتين على جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والرياضة الإسرائيلية التي تقف برأسها اليوم، الوزيرة ميري ريغيف، تلك العنصرية التي يتهكّم عليها كثيرا في كتاباته. أمّا الجائزة الثالثة التي سعى إليها ونالها رغم تَمنُّعها، فهي جائزة الإبداع التي يقدّمها مجمع اللغة العربية في الناصرة، وهذا المجمع، هو مؤسسة تتلقّى مخصّصاتها من الحكومة الإسرائيلية. والمثير للتساؤل هنا: لماذا لم يذكر تلك الجوائز الإسرائيلية الثلاث بغض النظر عن كيفية حصوله عليها؟ هل يستطيع أن يُعلن أنّها لا تُشرّفه؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا سعى إليها، أو لماذا لم يرفضها إذا سعت هي إليه؟ هل يخشى مثلا، أن يذكر أحدٌ أفضاله على السلطتين: الإسرائيلية والفلسطينية، ويتّهمه بالعمالة المزدوجة لهما؟ (معلش، هذا السؤال الأخير مزحة ثقيلة شوي، سامحوني)!
ولجائزة مجمع اللغة العربية في الناصرة، قصة قد لا تبدو طريفة. بدأت الجائزة قبل سنتين، ومنحت حتى الآن لكاتبين. في السنة الأولى حاز عليها الكاتب محمد نفّاع، وقد منحت له لجدارته بها، في حين لم يسعَ هو إليها، ولكنّه لا يُنكرها أيضا!
أمّا في السنة الثانية، فقد مُنحت للراوي/الكاتب محمد علي طه. وقد تناهى إلى سمعي رغم ثقله، ما لم يعد سرّا، إذ أنّ الأمر سواء ذُكر سرّا وانكشف، أو ذُكر علنا في حفل توزيع الجائزة، وهو أنّ الكاتب محمد علي طه كان عضو شرف في المجمع ككاتب. وعندما أراد التقدّم للجائزة ذكّره بعضهم بأنّه عضو شرف في المجمع ولا يحقّ له التقدّم للجائزة، فما كان منه إلّا أن سحب قلمه وتنازل عن “الشرف” وتقدّم لها. وبذلك انتهى الفصل الأول لهذه الجائزة. ولن أحدّثكم عن الفصل الثاني، فصل الخطوات العملية للحصول عليها، فأنا أثق بقدراتكم على التحليل والاستنتاج، إذا علمتم أن كاتبنا حصل فعلا على الجائزة القيّمة التي لا يذكرها بين جوائزه، ربما لأنّها إسرائيلية لا تُشرّفه! ولكن، هل انتهج أسلوبا مختلفا في السعي لأيّ جائزة، سواء كانت إسرائيلية أم فلسطينية؟
تزوير التاريخ وأكاذيب تكشفها حقائق!
في “نوم الغزلان” الكثير من المرويّات التي يرويها الكاتب كحقيقة حدثت ولكنّها تفتقر إلى إثبات، لأنّ أصحابها أو شهودها أموات، والتاريخ يرفضها لأنّها لم تظهر قبل موت شهودها. وهناك حقائق يدّعيها الكاتب لنفسه وهي لغيره، أو حقائق زيّفها وشوّهها. سأقدّم نموذجا لكل نوع، كما سأقدّم الدليل الذي يُثبت صحة ما أذهب إليه. ولكنّ أهمّ ما سأبدأ به هنا هو نظرة الراوي/الكاتب للعمل الفدائي والفدائيين الفلسطينيين.
ممدوح نوفل هو أحد قادة “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، وقد لعب دورا في التخطيط لعمليات فدائية فلسطينية كان أشهرها عملية معلوت في 15/5/1974.
ليس مهمّا الآن ما هي طبيعة علاقة الراوي/الكاتب بممدوح نوفل ومدى صدقها. ولكنّه يقول إنّه هاتفه ذات يوم واتفقا أن يزوره في بيته، وعندما تأخّر يقول إنّه هاتفه وسأله:
-
أين أنت يا عزيزي؟
-
لا تؤاخذني على التأخير. أنا الآن في معلوت.
-
أين؟
-
في معلوت. قال ضاحكا.
-
قلت مازحا: صدق الكاتب الروسي دستويفسكي عندما كتب (في روايته “الجريمة والعقاب”) أنّ المجرم يحوم حول جريمته!! (ص، 302).

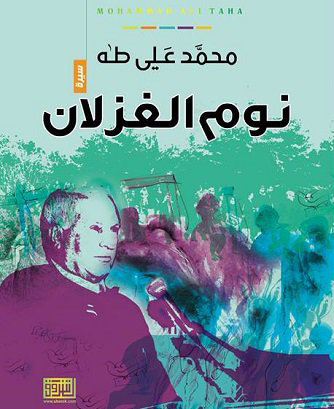
قرات جزءا كبيرا من المادة الطويلة جدا ساعود واكملها.
نعم شجعتني لقراءة الكتاب.. ولكن لدي افضليات في هذا المضمار.
[…] سايكو. أنت إنسان بلا قلب وبلا شعور وبلا إنسانية” (13).[1] فهل لنا أن نلوم السيّد سايكو وبيننا من هم أقسى منه […]