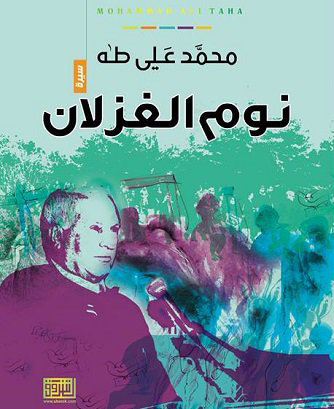
أستاذ اللغة العربية، كاتب وناقد أدبي. ولد في 5/3/1952 في قرية كابول، في الجليل الغربي، القريبة من "ميعار" المهجرة، مسقط رأس والده الشاعر الشعبي الفلسطيني، أحمد محمد هيبي (المعروف بالكشّوع أو أبو عصام الميعاري). هُدِمت ميعار وشُرّد أهلها في النكبة الفلسطينية عام 1948.