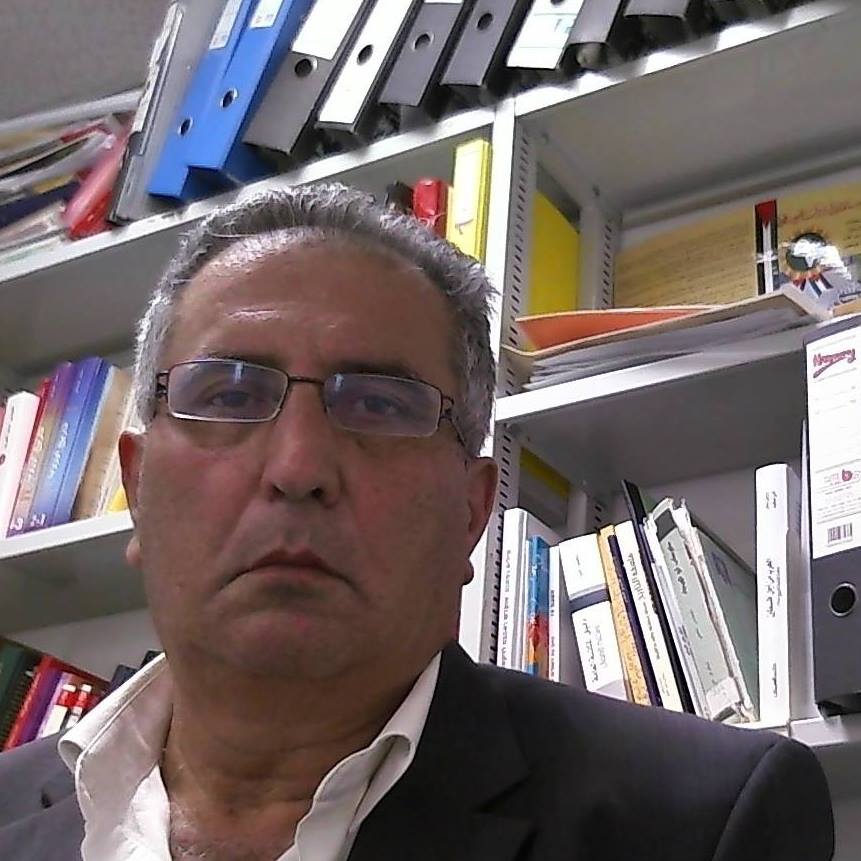جدار في بيت القاطرات، جدار من الوهم هدمه كبقائه، كلاهما مدمّر!؟
د. محمد هيبي

ما زالت الرواية الفلسطينية عامة وفي الداخل، منشغلة وبحقّ، بالهمّ الفلسطيني، فهي تُخاطب الذاكرة الفلسطينية، الفردية والجمعية، ليظلّ المشهد حاضرا في وعي الفلسطيني وفي ذاكرته، بدءا مما قبل النكبة 1948، مرورا بها، وبكل ما تبعها من هموم ونكبات ومآسٍ، عانى منها شعبنا الفلسطيني وما زال يعاني حتى اليوم.
ومن الهمّ ذاته، انطلق الكاتب مصطفى عبد الفتاح، في روايته الأولى، “عودة ستّي مدلّلة” التي أعاد فيها إلى ذاكرتنا، مرحلة من أقسى المراحل في تاريخ شعبنا الفلسطيني، يرصد فيها ويُوثّق أحداث النكبة، قبيل هجوم القوات الصهيونية على قرية صفورية، وحتى استيلائها على الأرض، وقتلها للإنسان الفلسطيني، أو تشريدها له من وطنه، لتبدأ رحلته الصعبة مع الهجيج والتهجيج إلى منفاه القسري.
كنت حاضرا في الأمسية التي أقيمت لرواية “عودة ستّي مدللة” هنا في كوكب، وفي هذا المكان بالذات، وسمعت ما قاله عنها المتحدّثون، وسمعت بشكل خاص، النقد القاسي الذي قدّمه د. محمد صفوري. وربما لحسن حظّي، لم يُطلب منّي آنذاك، التحدّث في تلك الأمسية، إذ كنت سأشدّ على يد الناقد الصفوري وأشكره على جرأته وموضوعيته وأدعم كل كلمة قالها. حينها، اكتفيت بكتابة مقال حول الرواية، نشرته في مجلة “شذا الكرمل”، مجلة اتحاد الكرمل للأدباء الفلسطينيين. كان مقالي قاسيا أيضا، فيه بيّنت معظم ما في الرواية من قصور، سواء كان في الشكل أو المضمون، والحقيقة كان فيها الكثير. في تلك الأمسية، رأيت في وجوه الحاضرين وعيونهم، الغضب الصامت مما قاله الناقد د. محمد صفوري، ولكنّي رأيت أيضا، وبإعجاب شديد، الهدوء في عيني الكاتب مصطفى عبد الفتاح، والقدرة على تقبّل النقد الموضوعي البناء مهما كان قاسيا.
اليوم، يضع مصطفى بين أيدينا، روايته الثانية، “جدار في بيت القاطرات”، ولا أشكّ بأنّ القارئ الواعي سيجد الفرق بين الروايتين، وسيقف على ما أفاده مصطفى عبد الفتاح من النقد.
قسوة النقّاد على مصطفى وروايته الأولى آتت أكلها، وها هي النتيجة بين أيدينا، رواية أخرى، فيها قفزة نوعية كبيرة من حيث الشكل والمضمون، وما كان لمصطفى أن يُحقّق هذه القفزة لولا النقد البنّاء وإن كان قاسيا.
أنا لا أقول أنّ “جدار في بيت القاطرات” هي عمل كامل متكامل، لا يوجد عمل كهذا أصلا، حتى عند الروائيين الكبار، وكل عمل خاضع للنقد ومفاهيمه التي تتباين من ناقد لآخر.
هذه الرواية، تقوم شكلا ومضمونا، على مفارقة كبيرة، تبدأ من حيث الشكل في العنوان، “جدار في بيت القاطرات”، فالبيت هنا هو الوطن الذي تمّ تقسيمه، وشُلّت حركته الطبيعية. فالمفروض أنّ الجدار يكون لبناء البيت وحمايته، وليس للفصل بين مساحاته المفتوحة، ولا بين سكّانه. والقاطرات التي تُمثّل الحركة عادة، والتنقّل الذي قد يُحيل إلى الحرية، هنا تمثّل الثبات المرفوض الذي يحيل إلى الحصار والقيد. وهو ليس جدار واقعي يحتلّ الجغرافيا كجدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل للفصل العرقي بينها وبين إخوتنا في المناطق المحتلة. وإنّما هو جدار من الوهم، يحتلّ جغرافيا النفس، بنته إسرائيل الخبيرة في التقسيم والتفسيخ وبناء الجدران وضرب الأسافين، بنته في نفس كل ساكن من سكان هذه البلاد، أصليا كان أو غير أصلي. وإن كان البعض لا يشعر به، فذلك لأسبابه الخاصة وليس لأنّ الجدار غير موجود. ومن هذا المنطلق يطرح “ناصر” سؤاله لاحقا: “لماذا هذا الجدار المرافق لحياتنا لا يزول؟” (ص 237). أما وضع المتفجّرات في الجدار، فتأكيد أنّه زائل، ولكن أيّ زوال ومتى؟ فهو كما يبدو لي، قنبلة موقوتة لا بد ّ من أنّها ستتفجّر يوما ما. ولكنّ بقاءها كتفجّرها، كلاهما مدمّر.
أما من حيث المضمون، فالمفارقة الكبرى تكمن في أنّ صاحب الأرض الأصلي يُعاني من القهر والحصار في وطنه، بينما المغتصب، يتصرّف كأنّه صاحب الأرض، وهو صاحب الكلمة والسلطة، يتحكّم بالوطن ويحاصر أصحابه ويحاول شلّ حركتهم وزرع اليأس في نفوسهم.
“جدار في بيت القاطرات” من حيث الشكل، أوكل فيها مصطفى عبد الفتاح مهمة السرد لراوٍ كلّيّ المعرفة، انطلق في سرده من حدث مركزي بسيط، هو سفر البطل من قريته عبر محطّة حافلات لم يكن قد جرّب أنّها تخاف العربي، حتى لو كان مسالما. فالعربي في هذه البلاد مشبوه، حتى لو كان مسافرا إلى الجامعة ليتلقّى علومه، وليحقّق أمل أمّه وأبيه ومجتمعه.
يقول الراوي (ص 6): “كان ناصر قد قدم من قريته قبل الوقت بساعتين وكان عليه ان يتلهّى بأيّ شيء أمامه ليقضي الوقت الضائع حتى وصول الحافلة التي ستُقِلّه الى تل أبيب ومن هناك سيواصل مشواره الى عاصمة الصحراء”.
هذا الحدث، السفر من القرية إلى بئر السبع، رغم بساطته، هو حدث مهمّ جدا، يُسمّى حامل السرد. تكمن أهميّته، فيما سبّبه من تداعٍ لأحداث كثيرة، تداعت أثناء حدوثه أو فيما بعد. هذا يعني أنّ الكاتب كان واعيا لضرورة الانطلاق من حامل للسرد، ليعطي للسرد منطقه ومصداقيته.
الأحداث التي تخلّلت هذا الحدث أو تلته، لم تكن متوقّعة رغم واقعيّتها، فقد تداعت من الحدث المركزي، بشكل لم يتوقعه البطل. وهي من حيث الشكل تشهد أن الكاتب أجاد في توظيف الترميز، حيث أنّ هذا الحدث وما تخلّله وما تلاه، ينطلق من الخاص إلى العام، ليرمز إلى حياة الإنسان الفلسطيني في الداخل، وما يُواجهه فيها من صعوبات تبغي كسره وإخضاعه، ولكنّها في الحقيقة، في حالة البطل، تُقوّيه وتُعلّمه كيف يواجه مغتصبي أرضه وحريته. والبطل في الرواية لا يُمثل فردا، وإنّما شريحة من شعب اقتلع أرضه، وهي ظلّت باقية فيها تتحمّل تبعات بقائها تحت حكم الغاصب.
فيما تداعى من أحداث أثناء السفر وبعده، لامس الكاتب تقنية تيار الوعي بكثير من تقنيّاتها الفرعية، الأمر الذي ساعده على التنقّل في الزمن بين حاضر السرد وماضيه، وهذا يُسمّى تكسير الزمن، حين يتوقف الزمن الموضوعي ليرتدّ الراوي إلى الماضي ومنه مرّة أخرى إلى الحاضر وهكذا. العملية تتكرّر أكثر من مرة في الرواية. وهذا بالطبع، يُحيلنا إلى حالة البطل النفسية التي تتغيّر بتوالي الأحداث وتغيّر الأزمنة والأمكنة.
الزمن الموضوعي في الرواية قصير، لا يتعدّى بضعة أشهر أو سنة دراسية جامعية. أما الزمن النفسي، فقد عاد بنا أكثر من مرّة إلى الماضي من خلال التّذكّر والاسترجاع، واستنادا على حالة التداعي والحلم، وحاجة البطل النفسية للبوح من خلال المونولوج أو الحوار الداخلي الذي استبطن به دواخل شخصية البطل بشكل خاص. عاد بنا إلى فترات سبقت حاضر السرد، عاشها البطل أيام الصبا والشباب المبكّر في القرية الوادعة، “المحروسة”. قريته التي عانت في حاضر السرد، أواخر سبعينيات القرن الماضي، من الإهمال والتهميش والممارسات القمعيّة.
أجاد مصطفى في لعبة التناوب في السرد، فقد رأينا مثلا، كيف ترك الراوي “ناصر” بعد الفصل الخامس ليحدّثنا عن “مريم” في الفصل السادس، ثم يعود للحديث عنه في الفصل الذي يليه. قد لا يكون الانتقال بالتناوب انتقالا بالزمن، وإنّما لسرد أحداث تتوازى في الزمن بينما تحدث في مكان آخر لشخصيات أخرى.
وعي مصطفى عبد الفتاح بأهمية عنصر الزمن في الرواية، أبعده كثيرا عن ترهّل الحبكة الذي اصطدمنا به في روايته الأولى، “عودة ستّي مدلله”. في روايته الثانية، “جدار في بيت القاطرات”، لا نكاد نجده هذا الترهّل. فهي مسبوكة ومشدودة بشكل يُشوّق القارئ ويشدّه لقراءتها من غلافها لغلافها. إلّا أنّ الكاتب يخفق في توظيف ثقافته ليضفي على الرواية بعدا معرفيا يُثري ثقافة القارئ.
واستطاع الكاتب كذلك أن يُوظّف المكان بشكل جيد، حيث رأينا البطل يتنقّل في أماكن عديدة، انطلاقا من قريته” المحروسة”، إلى أماكن أخرى يرتبط بها ارتباطا نفسيا ووطنيا. فهي أجزاء من وطن الراوي الذي احتلّه ومزّقه الغاصب الصهيوني. ولذلك رأينا كيف أنّ الحالة النفسية للبطل وغيره من الشخصيات، تتشكّل حسب المكان الذي تتواجد فيه الشخصية. فيُحسّ القارئ مثلا، براحة البطل النفسية كلّما كان يعود إلى قريته حتى ولو بالحلم والاسترجاع، أو براحته عندما نام في مضارب النقب، في الخيمة لدى الشيخ، والد صديقه.
يقول (ص 230): “لم يشعر هنا بغربة، اطمأنت نفسه، هدأت روحه، شعر بالبعد الشاسع بين هنا وهناك، بين الخيمة وبيت القاطرات، شعر أنّه ابن المكان وابن الزمان، شعر براحة لم يعهدها من قبل، نام أمام النار كطفل صغير، لفّه الشيخ بغطاء خفيف، وتركه يكمل حلمه”. هذه الأماكن، هي أجزاء من الوطن الذي يعشقه البطل، تبعث الهدوء والطمأنينة في نفسه.
وفي المقابل، كانت حالة البطل النفسية صعبة، فلم تهدأ لحظة في بيت القاطرات. أو في غزة، كمكان مرغوب ولكنّه ليس مألوفا ولا يبعث على الطمأنينة. فهو مرغوب لأنّه جزء من الوطن، ولكنه لا يبعث على الطمأنينة، لأنّنا تعرّفنا عليه عبر الاحتلال. وهو مرغوب أيضا لأنّه يضمّ أخوة لنا، إلّا أنّه يخسر ألفته حين يتّهمون من بقي في وطنه، بالتعاطف مع الغاصب المحتلّ أكثر من تعاطفه معهم.
وهناك أمر آخر في غاية الأهمية بالنسبة لتوظيف المكان. الأمكنة التي تدور فيها الأحداث هي أمكنة مفتوحة أو مغلقة، وهذا له أثره في نفس البطل ونفس القارئ. يقول (ص 237): “تاه ناصر في بحر أفكاره، لماذا يعذبُ الوطنَ من يحبهُ بدل أن يحتضنه؟ لماذا يجب أن ندفع ثمن هذا الحب؟ لماذا هذه الغربة في الوطن؟ لماذا هذا الجدار المرافق لحياتنا لا يزول؟”. أسئلة كثيرة تدلّ على حيرة البطل ونفسيته المتعبة في المكان المغلق. بينما في الأماكن المفتوحة تجدها مرتاحة مطمئنّة.
بيت القاطرات وغُرفه كمكان مغلق، ينعكس على نفسية البطل فهو دائما متعب وقلق هناك. ولم تهدأ نفسه كذلك في غرفة الاعتقال أو أثناء انتظاره في غرفة مع صديقه في غزّة. بينما الخيمة في الصحراء هي مكان مفتوح في صحراء مفتوحة مترامية الأطراف، تبعث على الهدوء والطمأنينة. لذلك شعر بالأمان ونام مطمئنّا.
وهناك ما تجدر الإشارة له عمّا دار في غرفة الاعتقال، يقول (ص 237): “لم يعد يحسب الأيام التي مضت، في الضغط والإهانات والتحقيق، لم يعد يعير اسئلتهم الروتينية اليومية أيّ اهتمام، العشرات من المعتقلين يدخلون ويخرجون، يسمع بعضا من قصصهم، فيخفّف من همّه، ويصرّ على موقفه، الى أن كان يوم أخبروه أنّ الغد سيكون يوم محاكمته”. هنا يلامس مصطفى عبد الفتاح أدب السجون بشكل ما. ولكنّ هذه العبارة أو غيرها لا تكفي لنعتبر الرواية من روايات السجن. ولكنّه أراد هنا، وفي أماكن أخرى ذكر فيها الاعتقال، أن يُظهر لنا أنّ السجن هو جزء من قدَر الإنسان الفلسطيني الذي يناضل ضدّ السلطة، ومن أجل إحقاق حقوقه. فهو معرّض لدخول السجن في أيّة لحظة من لحظات عيشه ونضاله.
وقد أجاد مصطفى هذه المرة، بما لا يُقاس في رسم الشخصيات، وخاصة في رسم شخصية البطل، “ناصر”. فقد رأينا كيف تنبني شخصية “ناصر” لبنة لبنة، على الورق، وكيف يتكشف عالمها ويتطوّر نتيجة لتفاعلها مع الأحداث ومع غيرها من الشخصيات، وبشكل خاص من خلال المونولوجات الداخلية التي تداعت في نفس البطل.
كما أنّ الكاتب، والراوي كذلك، لم يفرض أيّ منهما نفسه على الشخصيات الأخرى، بل أعطاها مساحة كافية للتعبير عن نفسها عند الحاجة، سواء في الحوار فيما بينها، أو من خلال المونولوج، الحوار الداخلي. رأينا مدى المساحة التي أعطاها لـ “راحيل”، تلك المرأة التي ساعدها وهو في طريقه الى الجامعة، وكم بحثت عنه لتبوح له بمكنونات نفسها التي تداعت من فقدها لابنها في الحرب، ودفعتها لتعترف للبطل بخطئها في التعامل معه. ولكن الكاتب للحقيقة، ظلم بعض الشخصيات أحيانا. سأتحدّث عن المجنّدة لاحقا وكيف ظلمها.
من حيث المضمون، لم يتخلّص مصطفى عبد الفتاح من عقدة موضوع النكبة والهمّ الفلسطيني، ولكنّه قفز فيه قفزة نوعية إلى معاناة أكبر وأكثر تعقيدا، بل لا زالت تزداد تعقيدا يوما بعد يوم، تلك هي المعاناة التي عاشها، وما زال يعيشها الإنسان الفلسطيني الباقي في وطنه بعد النكبة. فقد أظهر الكاتب في روايته الجديدة، معرفة واسعة ومقنعة بأوضاع الإنسان العربي في الداخل الفلسطيني، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتطوّرها بعد النكبة وحتى ما بعد يوم الأرض، الذي شكّل حدثا مفصليا في تاريخ الجماهير التي تخلّصت فيه من عقدة الخوف من السلطة. كما أنّه عبّر عن فهم عميق للعلاقات بين النظام الصهيوني وبين الأقلية العربية في الداخل، ومن جهة أخرى بينها وبين الأخوة في الأرض المحتلّة عام 1967.
اجتماعيا، كانت القرية وادعة وهادئة والعلاقات فيها جيّدة ولا يعكّر صفوها إلّا ممارسات السلطة الظالمة. واقتصاديا، عبّر الكاتب عن ذلك (ص 9) على لسان والد البطل الذي اضطر للعمل في المستوطنات التي أقيمت على أرضه المصادرة، حين قال مخاطبا ابنه “ناصر”: “نحن عائلة فقيرة يا ولدي وعلى قدر حالنا، بالكاد أستطيع أن أطعمكم الخبز، أرضنا صودرت … وما تبقى لنا من أرض لا يسدّ الرمق”. هنا من الواضح أنّ اللغة تترهل فهي لا تلائم طبيعة الشخصية، اجتماعيا أو ثقافيا.
وأكثر من ذلك، فقد فهم مصطفى الوضع السياسي والاقتصادي السياسي، وعبّر عنه أيضا على لسان والد البطل في الصفحة نفسها حين قال لابنه: “عليك أن تقتصد، عليك أن لا تتعامل بالسياسة، لا ترافق الشيوعيين، لأنّ الحكومة ضدّهم وستمنعك من أن تتوظف في المستقبل. اهتم بنفسك وبتعليمك فقط. الوطنية والوطن بالقلب فقط، لن يستطيع أحد تغيير قلبك”.
في هذه الرواية، البطل يمثل الإنسان الفلسطيني في الداخل، ومعاناته تتمثّل في مواجهته للغاصب الذي سلبه أرضه وحريته، ومواجهة أحكامه الجائرة التي فرضها عليه. ومن جهة أخرى، هناك المواجهة مع الآخر اليهودي الذي يرانا أعداء رغم جهله أو تجاهله للكثير من الحقائق المتعلّقة بنا، والمتعلّقة كذلك بما اقترفته يداه أو يد السلطة التي تحكمه وتحكمنا.
وهناك من جهة ثالثة، المواجهة مع الإخوة في الأرض المحتلّة، الذين لم يتفهّموا صعوبة بقائنا في الوطن ولا خصوصيته. ومن جهة رابعة، هناك معاناة تبخّر الحلم، واضمحلال أمكانيات تحقيقه، بسبب تقاعس الإخوة العرب أحيانا، وبسبب خيانتهم أحيانا أخرى. وهو ما تمثّله زيارة الرئيس المصري، السادات، لمدينة بئر السبع وجامعتها عام 1979. هذه المعاناة وما فيها من مواجهات مختلفة، هي ما جعل مصطفى يضعنا أمام جدار قابل للتفجّر في كل لحظة، وما من أحد يستطيع توقّع زمان أو نتائج تفجّر هذا الجدار، في حين أنّ كل المؤشّرات تشير إلى أنّ تفجّره سيكون وبالا على الإنسان الفلسطيني بشكل عام والإنسان الفلسطيني في الداخل بشكل خاص. وكأنّ مصطفى عبد الفتاح في روايته الثانية، يرسل لنا رسالة واضحة، فيها صرخة ألم وغضب وتحريض، يُطالب فيها الإنسان الفلسطيني في كل مكان، أن يصحو من أوهامه، وأن يتحمّل مسؤولياته، دون أن يحمّل غيره ما لا طاقة له به. وهذا طبعا يعكس وعي الكاتب وفكره، ويُعطي للرواية بعدا توعويا يطمح الكاتب إلى نشره بين أبناء شعبه.
الشقّ الأول من الصراع في الرواية، يبدو واضحا في مواجهة بطل الرواية للمجنّدة ولرجل المخابرات الذي أراد تجنيده ليتجسّس على أصدقائه.
قال المجنّدة ولم يقل الجندية، وهو يقصد ذلك، فمفردة “جندية” تعكس القبول والإيمان بما يفعله الجندي، بينما “مجنّدة” تعكس عملية القسر التي مورست عليها لتجنيدها. وهذا يعكس معرفة مصطفى وحذره أكثر بالتعامل مع اللغة رغم أنّه لم يستطع أن يمنع ترهّلها أحيانا وكما ذكرت سابقا. وقد ظهرت نتيجة التجنيد القسري ورفض الممارسات القمعية، واضحة في ترك المجنّدة للبلاد وعودتها إلى بولندا، موطنها الأصلي، لأنّها لم تؤمن بما تفعله هي، ولا ما تفعله السلطة التي جنّدتها.
ظلم الكاتب شخصية المجنّدة بشكل ما. وليس غريبا على الكتّاب أن يظلموا بعض شخصياتهم لأسبابهم أحيانا. لم يعطِ مصطفى لهذه الشخصية أن تتطوّر بشكل طبيعي. ترك التفاصيل واهتمّ فقط بالنتائج. أهمل المجنّدة وانشغل بنفسه وهواجسه، عندما التقاها البطل في بيتها وعلم أنّها أخت صديقه “رامي”، ثم غيّبها مستندا إلى ماضيها الذي يكرهه، إلى أن أعلمنا في آخر الرواية (ص 233)، بما جاء على لسان أخيها، “رامي”: “عادت أختي إلى “بولندا”، فهي لم تطق البقاء هنا أكثر”. كأنّ كل همّ الكاتب أن تعود من حيث جاءت دون الحاجة لمعرفة الدافع. لذلك جاءت العبارة على لسان أخيها “رامي” وليس على لسان البطل. فكأنّ تركها للبلاد هو الذي يعنيه فقط، وأنّ كونها غير راضية عما يحدث في البلاد من ممارسات السلطة الظالمة ضد العرب، فلا يعني الكاتب ولا بطل روايته.
المجنّدة ورجل المخابرات يُمثّلان السلطة التي لم تكتفِ باغتصاب الأرض، وإنّما أرادت أن تدجّن أصحابها الذين بقوا عليها، وتخضعهم لخدمتها. ويبدو هذا الصراع أيضا، في مواجهة “ناصر”، بطل الرواية، لركّاب الحافلة الذين يمثلون المجتمع اليهودي كلّه، الذي يرفضنا ويكنّ لنا العداء بمعظم أطرافه. ظهر ذلك لدى معظم ركّاب الحافلة الذين عبّروا عن غضبهم على “ناصر”، سواء بالكلام أو بالنظرات. ولم يُغفل مصطفى تلك القلّة في المجتمع اليهودي التي تتفهّم مشكلتنا وتُعبّر عن قبولها التعايش معنا في بيئة تحكمها الديمقراطية وقبول الآخر.
وربما الأهمّ من ذلك كلّه، قدرة مصطفى عبد الفتاح على الغوص في أعماق شخصياته، واستبطان دواخلها، ولم يقتصر ذلك على البطل ومنولوجاته الداخلية، فقد جعل اليهودي، والمقصود هنا “رامي” صديق “ناصر”، حين زار غزة زيارة عادية لا علاقة لها بالجيش والخدمة العسكرية، جعله يتعرّى أمام نفسه، بعد أن خلع الزيّ العسكريّ ورأى المآسي التي صنعتها يداه حين كان يرتديه. يقول (ص 178): “اكتشف لأول مرة في حياته، أن الزيّ العسكري الذي كان يرتديه قد حوّله إلى وحش كاسر، وهذه الأكوام الثقيلة من الحديد القاتل هي التي تخفي إنسانيته، وتُلغي وجوده الإنساني، عقله وتفكيره منصبّان كليّا على تدمير كل ما هو إنساني. اكتشف للتوّ أن أول ما تقوم به هذه الملابس هو أنّها تلغي إنسانيته تحت ضغطٍ رهيب ممن يأمرونه بالقتل والتدمير”.
كما أنّ مصطفى كان ذكيا جدا حين جعل سائق الحافلة عربيا. فهو يُمثل الأقلية العربية التي ترى وتصمت قسرا وخوفا، عند احتكاكها بالآخر اليهودي، ولكنّ هذه الأقلية، تنسى في اللحظة المناسبة خوفها وتطلق لسانها على الأقلّ، تأييدا للمنضالين الشجعان أمثال “ناصر”. وبالتأكيد استطاع الكاتب من خلال شخصية سائق الحافلة أن يُقدّم لنا احتمالات كثيرة سواء فكّر بها الكاتب أم لم لا. من هذه الاحتمالات:
- بقاء العربي على هذه الحالة من الخوف والصمت من الممكن أن يدفعه في اتجاهات عديدة يصعب معرفتها مسبقا. فالقارئ لم يتوقّع أن يكون السائق عربيا ولا أن يتصرّف بالشكل الذي تصرّف به.
- الحافلة لا يمكنها أن تسير إن لم يُشارك العربي في قيادتها.
- شاء من شاء وأبى من أبى، فلا أحد يستطيع أن يتجاهل دور العربي كعامل أساس في هذه البلاد، وله دور قيادي في التأثير على حركة المجتمع.
- وربما الأهمّ من ذلك كلّه، هو أنّ العربي هو من يجب أن يحكم هذه البلاد التي تمثلها الحافلة، فهي بلاده ووطنه وليست وطن من اغتصبها.
الشقّ الثاني من الصراع، هو الصراع مع الإخوة، يظهر أثناء زيارة “ناصر” لغزّة، في اتهامهم لنا بما جاء (ص 193) على لسان “أبو شباك”: “أنتم أصبحتم مثلهم، وتعيشون مثلهم، أنتم لا يهمّكم غير أنفسكم، أصبحتم صهاينة، نسيتم قضيتنا، وتدافعون عنهم”. ويجيء ردّ “ناصر” سريعا، ليؤكد صراع الإنسان العربي الفلسطيني وضياعه في الداخل، بين النظام الصهيوني الحاكم وبين إخوته في الأرض المحتلة. يقول لـ “أبو شباك”: “نحن عندكم صهاينة، وعندهم عرب إرهابيون. على ما يبدو نحن ضائعون بينكم وبينهم” (ص 193).
ويظهر هذا الصراع واضحا من جهة أخرى، كما يظهر كذلك ضياع الإنسان الفلسطيني في الداخل، في تورّط “ناصر” بنقل حقيبة المتفجّرات مرغما ودون إرادته، واضطراره لإخفائها في الجدار في بيت القاطرات، إلى أجلٍ لا يعلمه إلّا الله. هذه الحقيقة، كما تقتضي المهمّة التي ألقاها الإخوة في غزّة على كاهله، كان يجب أن يُفجّرها في الطريق أثناء مرور موكب الرئيس الزائر. وهي في كل الأحوال، قد ينكشف أمرها وقد تتفجّر، وستكون النتيجة وبالا على الإنسان الفلسطيني، خاصة في الداخل. وهذا الصراع يعكس عدم تفهّم بعض شرائح شعبنا، في الأرض المحتلة وفي الشتات، لخصوصية وجودنا وبقائنا في أرضنا تحت حكم سلطة جائرة.
وختاما، جدار في بيت القاطرات” كما أفهمها، هي حكاية مواجهة بين السلطة الإسرائيلية الغاشمة التي صادرت الأرض وشرّدت أصحابها، وبين الإنسان العربي الفلسطيني الذي بقي في أرضه وفي وطنه، شوكة في حلق السلطة الصهيونية التي تريده ولا تريده. فهو بالنسبة لها مطلوب مرفوض. من جهة تحتاجه ولا تستغني عنه وفي الوقت نفسه من جهة أخرى، تمقته ولا تطيق وجوده. وهو بين هذه المتناقضات، لا بدّ له أن يُناضل ويصمد في مواجهة لا أحد يدرك وقت وشكل نهايتها.
وعود على بدء، “جدار في بيت القاطرات” هي قفزة روائية نوعية، قفزها مصطفى عبد الفتاح نحو مستقبل روائي يُبشّر بمزيد من الإبداع.