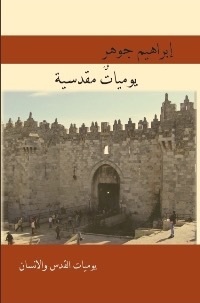قراءة في “أقحوانة الروح”، يوميات مقدسية للكاتب إبراهيم جوهر
كتابة اليوميات فنّ قديم، ربما قِدم الكتابة. قد يلجأ إليه أيّ شخص، سواء كان قريبا من حقل الأدب أو بعيدا عنه. إنّها نوع من السيرة الذاتية اليومية، يُسجّل فيها الكاتب، نشاطه اليومي المعيش، أو بعضه الذي يترك في نفسه وحياته، وفي محيطه أيضا، أثرا يرى حاجة في الاحتفاظ به أو في نشره وتعميمه. وكتابة اليوميات، تختلف عن كتابة المذكرات رغم التشابه بينهما. فهي ليست تدوين ما نمتحه من الماضي والذاكرة، في لحظة راهنة ولأسباب مختلفة، وإنما هي كتابة اليومي الذي نريد أن نتذكّره أو أن يتذكّره غيرنا. ولولا إيمان الكاتب بأهميّته في الراهن، وأهمية تذكّره لاحقا، لما كتبه، سواء كتبه لنفسه، أو لفئة قليلة، أو للنشر والتعميم على الملأ.
تعتمد كتابة اليوميات على الأحداث اليومية التي يعيشها أو يُعايشها الكاتب، من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا. قد يُسجّل الكاتب، تبعا لأهدافه، كل الأحداث أو ينتقي منها ما يُحرّك فكره ومشاعره، ويخلق لديه أفكارا وتساؤلات ومواقف، يشعر بضرورة تقاسمها مع القراء الذين يراهم عنوانه الصحيح للتّقاسم والمشاركة، سواء ضاقت شريحتهم أم اتسعت. ويمكن تصنيف اليوميات، والأفكار والتساؤلات والمواقف التي تنتج عنها، بحسب الاهتمامات الشخصية للكاتب نفسه. لذلك قد تكون اليوميات أدبية أو سياسية أو كليهما معا، أو غير ذلك. وقد تنعكس فيها أبعاد أخرى كثيرة. أمّا دافع الكتابة وهدفها، فقد يكون الإفراغ والراحة النفسية، أو فوائد أخرى يرجوها الكاتب لنفسه أو للمحيط الذي يكتب له.
تتيح كتابة اليوميات ولوج عوالم ومجالات مختلفة، فهي تجمع بين الرسالة والقصة والخبر والخاطرة، وأمور أخرى كثيرة قد تنبع من ذات الكاتب، ويراها ذات فائدة، قد يستفزّ القارئ بها، بالإضافة إلى متعته في القراءة واطلاعه على عالم الكاتب الشخصي الذي لا يعود ملكه، حيث تُصبح اليوميات بعد نشرها، وثيقة أو مجموعة وثائق ذات أهمية بالغة، لأنّها لا ترصد، حركات وانفعالات الكاتب فقط، وإنما ترصد حركات وانفعالات فترة زمنية معينة، أو مرحلة يُسجّل الكاتب تاريخها من خلال رصده وتسجيله لليومي والشخصي الذي يعيشه بتفاصيله، وبعلاقاته المختلفة مع الأحداث، بإنسانها وزمانها ومكانها. ولذا قد تُصبح تلك اليوميات، كما أسلفت، ذات فائدة عظيمة في مجالات كثيرة، قد يجنيها الكاتب أو القارئ.
قد يكتب شخص يومياته لنفسه، وقد يكتبها لشريحة ضيّقة، ولكن ليس هذا ما فعله إبراهيم جوهر في أقحوانة روحه، أو يومياته المقدسية! فقد كتب للقارئ بنوعيه: ذلك الذي يعرف مكانة القدس في الوجدان الفلسطيني، وذلك الذي يجهلها، فلسطينيا كان أو غير فلسطيني. لم يكتب إبراهيم جوهر لنفسه فقط، ولا لشريحة ضيّقة، ولا حتى للفلسطينيين فقط، وإن كانوا هدفه الأساس، وإنّما يكتب لدوائر أوسع بكثير من الدائرة الفلسطينية، وقد تتعدّى الدائرتين العربية والإسلامية. وذلك لأنّ الألم الذي يكشف عنه إبراهيم جوهر، ربما يبدأ في القدس ويتجسّد فيما يحدث فيها ولها، ولكنّه ألم أكبر من القدس، لأنّ القدس هي ليست الجرح الذي يسبّب الألم وإنّما هي عاصمته التي تستقطب أطرافه، فهو جرح شاسع بمساحة الوطن العربي، ويمتدّ إلى العالم الإسلامي أيضا، وربما إلى العالم بأسره. فالجرح قد تعفّن، وبدأ صديده ينزّ ويتدفّق من عاصمة الجسد المثقل بالجراح، القدس. يستجمعه من شرايين أجسام متعدّدة كان يجب أن تكون جسما واحدا، ومن دوائر قد تشتّتت رغم تداخلها، قد يكون أهمّها الثلاث الأقرب: المقدسية، الفلسطينية والعربية. والمؤلم أكثر، وهو ما يُعطي لهذا الألم تميّزه، هو أنّ ما يحدث للقدس وفيها، يحدث تحت عين الدوائر الثلاث، وبمباركة أصنامها.
من المؤسف حقّا، أنّ العنوان الذي اختاره الكاتب ليومياته، “أقحوانة الروح”، قد سقط سهوا، أو عمدا، من صفحة الغلاف، كما يرى الكاتب المقدسي، جميل السلحوت، صديق جوهر، حيث قال: “لكن يبدو أن الناشر قد اجتهد وغيّر عنوان الكتاب كما يروق له، دون الرجوع الى صاحب الكتاب، وهذا أمر يدعو الى التساؤل، ولو ترك الناشر عنوان الكتاب كما اختاره صاحبه لأراح واستراح”.[1]وهذا مؤسف حقّا، فإلى جانب ما فيه من تدخّل مرفوض، إذا كان مقصودا، وإهمالا إذا لم يكن، فيه أيضا محاولة لطمس حقائق ومشاعر يريد الكاتب أن يبرزها في العنوان. فالعنوان المحذوف شديد الحساسية، يعكس العلاقة الوثيقة الراسخة، بين القدس والكاتب إبراهيم جوهر، وموقعها في نفسه، وفي نفس الإنسان الفلسطيني عامة، وبكل أبعادها، وخاصة النفسية، حيث تحتلّ القدس بكامل هيبتها ووقارها، وتاريخها وتراثها، وبؤسها الراهن، تحتلّ حيّزا شاسعا في نفس الكاتب وحياته وكتاباته وفي نفس كل إنسان فلسطيني.
يكتب إبراهيم جوهر، اليومي البسيط، ولكن لا شكّ أنّه يدرك دلالة قول الشاعر: “إنّ الأمور دقيقها مما يهيج له العظيم”.[2]والعظيم يهيج فعلا من كل حدث يُسجله الكاتب، مهما كان صغيرا، لأنّه يحدث في زهرة المدائن التي يُخيم عليها الحزن، على كنائسها ومآذنها وشوارعها، منذ عقود طويلة. فهل يُريد إبراهيم جوهر في يومياته أن يُحرّر القدس، أو حتى يمسح الحزن عنها؟ يُدرك إبراهيم جوهر أنّه لا يستطيع. يظهر ذلك في ردّه على صديقه “إبراهيم عبيدات” الذي “لا يرى في الشعر أي قدرة على تحرير ولو حارة” (ص، 185). فيُذكّر صديقه وغيره، بأنّ “هذا صحيح تماما. فالشعر لا يُحرّر البلاد ولكنّه يُحرّر العقول، ويزرع الانتماء والجمال. فالعاشقون وحدهم هم الأكثر قدرة وتأهيلا على التحرّر والتحرير” (ص، 185). ويظهر في تقييمه لديوان الشاعر، الدكتور معتز قطب، “الصورة الأخيرة لمولاتي”، الذي “يحمل عشقا وهياما كبيرين للقدس … أنّ سلاح الشاعر والأديب لغته، وعشقه. إنّه يُجمّل الجميل ويدعو إلى عشقه، وحين يعشق العاشق فإنّه يُضحّي من أجل عشيقته، ويسعى لإنقاذها. الشعر يُرسّخ الحلم ويعيش فيه. يدعونا إلى إحياء أحلامنا الغاطّة في سباتها … لا عدوّ للأحلام إلّا الكسل والسبات والتسليم بالواقع” (ص، 193). وربما يكون أكثر ما تُظهره يوميات إبراهيم جوهر، بعد عشقه للقدس، هو تمسّكه بالحلم، وعدم تسليمه بالواقع، ودعوته للقارئ أن يكون كذلك أيضا.
يتجه إبراهيم جوهر في يومياته، اتجاها أدبيا واضحا في الشكل والمضمون. ففيها، وكما يجب أن يكون، لكل يوم تاريخه المحدّد باليوم والشهر والعام، ما يُؤكّد التوثيق إلى جانب الأهداف الأخرى التي لا تخفى على القارئ. ولا أدري لماذا اختار الكاتب تلك الفترة من حياته وحياة القدس، من يوم الخميس 23/2/2012 حتى يوم الاثنين 30/4/ 2012؟ هل في هذه الفترة بالذات، ما يُميّزها عن غيرها مما نعرفه من حياة القدس واتساع جرحها يوميا؟ قد يكون لذلك أسباب كثيرة، تكشف اليوميات بعضها، وأهمّها في رأيي، هو أنّ تعميق الجرح أصبح ذاتيا، الأيدي التي تعبث به لم تعد من خارج الدوائر المذكورة، وإنّما من صميمها، من أولئك الذين يتباكون على القدس ويصرخون لفضّ بكارتها ويُشرّعون للغاصب رجليها وكل أبوابها. فيُصبح الجرح أعمق بما لا يُقدّر. وعلى حدّ تعبير غوار الطوشة، والدموع تملأ عينيه في مسرحية ضيعته الضائعة: “يا ابني يا نايف، إذا ضربك الغريب شكل، وإذا ضربك ابن بلدك شكل ثاني”.
يُقدّم إبراهيم جوهر الأخبار والأحداث اليومية، البسيطة والأقلّ بساطة، بلغة مباشرة وبصراحة متناهية، ولكنّه فيما يتعلّق بمشاعره ومواقفه التي تفرضها الأخبار والأحداث، يُصرّ على اللغة المباشرة والصراحة غالبا، ولكنّه يلجأ أحيانا، إلى اللغة الشعرية شديدة الكثافة والترميز، وذلك لأسباب أدبية جمالية بالأساس، ولكنّها تحتمل أسبابا أخرى، أهمّها السياسية التي يفرضها الواقع الاحتلالي خاصة، أو السلطوي عامة. وهو في الحالين: اللغة الأدبية الشعرية التي تراعي جماليات الأدب، أو اللغة الرمزية الكثيفة التي يحتال بها الكاتب على القهر السياسي، يعتمد على ذائقة القارئ وذكائه من جهة، ومن جهة أخرى على علاقة القارئ الذاتية، يومية نفسية، أدبية أو سياسية أو غيرها، بالقدس أو بما يقرأ. وفي كل الأحوال، تفيض لغة إبراهيم جوهر، صدقا وحميمية نلمسهما في كل عبارة من عباراته، حيث يشعر القارئ أنّها صادرة من أعماق قلبه الجريح، ومن صميم جرحه المقدسي الفلسطيني النازف، تتشرّب بالألم الذي يفيض من كليهما.
لا شكّ أن الأوضاع المزرية التي تعيشها مدينة القدس، وهذا التنكّر والإهمال والتهميش لمدينة كان يجب أن تكون القلب النابض للعروبة والإسلام، هي ما يُقلق الكاتب إبراهيم جوهر، تُؤرّقه وتقضّ مضجعه، لذلك رأى ضرورة ملحّة، وربما أكثر من أيّ وقت مضى، أن يزيل عن انتمائه للقدس، أيّ ذرة رمل أو غبار قد تكون علقت به، عبر السنين وفي مأساة تفاقم الأوضاع الفلسطينية والعربية والإسلامية. فهو يرى أنّ تعزيز الانتماء وتثبيته، أمر ملّح الآن، الآن الآن وليس غدا. وهو يمرّ بالأشياء اليومية البسيطة، قد يعتبرها البعض صغيرة، ولكنّها أفضل ما يكشف العلاقة بين المكان ومحتوياته، من أبسطها إلى أهمّها، الإنسان. ولذلك اهتمّ الكاتب في معظم يومياته بطبيعة القدس، فذكر المكان الذي يسكن فيه، جبل المكبر، وكيف يُطلّ منه على المساحات الشاسعة التي تمتدّ حتى البحر الميت، وأجزاء أخرى من فلسطين، تتصل اتصالا وثيقا بالقدس، كتأكيد على ضرورة تلاحم فلسطين بكل أجزائها التي يرى الكاتب القدس مركزها وقلبها الذي يجب أن يظلّ نابضا.
تحتلّ طبيعة القدس، حيّزا واسعا في يوميات جوهر، فمن جبالها وأشجارها ونباتاتها وزهورها وطيرها وحيوانها. إلى صفاء سمائها واعتدال طقسها ربيعا، واشتداد حرارته صيفا، وإلى تكدّر سمائها وتجهّمها خريفا وثلجها وبرودة طقسها شتاء. ولا ينسى بيئته في جبل المكبر والقدس كلّها، وما فيها من أسباب قليلة للفرح الحزين، وأسباب كثيرة للحزن والقلق والتنغيص.
مواضيع كثيرة توقّف عندها الكاتب، لا يمكن ذكرها جميعا هنا، ولكن ما لا شك فيه، هو أنّها جميعا تحمل هموم الكاتب وهموم مدينته وشعبه. وما من موضوع يطرقه، إلّا لأنّه يُثقل عليه ويترك أثره في نفسه. لكل شيء لغته، ولكل شيء ذاكرته، “والذاكرة تفتح دفاتر الطفولة” (ص، 35). فالدفء مثلا، “لا يأتي من وسائل التدفئة، الدّفء له لغته الخاصّة” (ص، 33). لذلك قد يجد الكاتب الدفء كما يقول، في “وجبة دافئة أعادتني إلى أيام (عروس السّكّر) في الطفولة (ص، 33). الوجبة تدفئ الجسد وتُثير الذكريات، والذكريات السعيدة تُدفئ القلب وتُنشّط العقل. فهل كلّ الذكريات سعيدة؟!
ما من موضوع يُثيره الكاتب، إلّا ويرتبط بنفسيته أو نفسية الإنسان المقدسي أو الفلسطيني عامة، وعلاقاته بما يدور حوله، خاصة على المستوى السياسي. فمطر القدس مثلا، الذي كاد يجفّ في السنوات الأخيرة، يُقلق الكاتب، ولكنّ ما يٌلقه أكثر هو جفاف الحياة المقدسية، اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وغير ذلك. ولذلك، فالمطر الخفيف الذي يهمي أحيانا لا يبلّل الأرض فقط. “صباح الجمعة مطر خفيف همى فبلّل الطّرقات والمصاطب ورؤوس الأشجار … مطر بلّل قلبي” (ص، 33). وقلب الكاتب لا يُجفّفه انحباس المطر، بل جفاف حياة القدس التي قد لا يزيدها انحباس المطر جفافا، بقدر ما يُذكّرنا بجفافها الذي يفوق جفاف المطر.
ومن هنا، نجد أنّ كل حدث، مهما كان بسيطا، قد تتداعى منه أفكار أو ذكريات أو تساؤلات أو مواقف، تُثري اليوميات وتشدّ القارئ، بل تكبّله بذات القيد الذي يُكبّل الكاتب ومدينته. كل يوميات إبراهيم جوهر تقوم على التداعي والاستطراد. لأنّ كل حدث في القدس، بل كل حجر فيها، له ذاكرته التي لا تنفصم عراها عما حدث وما زال يحدث.
كل الأوضاع في القدس حزينة ومقلقة: الاجتماعية والسياسية والثقافية. فلا أقلّ من أن نحافظ على الثقافة التي تحفظ الذاكرة والذاكرة تحفظها. ولذلك تحدّث الكاتب كثيرا عن الأوضاع الثقافية في القدس، وخاصة عن مشروع “القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية”. ولكنّ هذا المشروع بالذات – وهذا ما يٌقلق الكاتب – سلاح ذو حدّين، قد يُثبّت القدس في الذاكرة، وقد يمحو القدس وذاكرتها من وعي أجيالنا الصاعدة. وبما أنني شاركت هذا العام في بعض نشاطات هذا المشروع، أشهد أنّ لقلق إبراهيم جوهر ما يُبرّره. ففي حياتنا “كلمات حقّ” كثيرة يُراد بها باطل، ولذلك، لا يكفي الاعتماد على ظواهر الأمور. وكأنّي بالكاتب يقرأ الرسائل والسطور وما بينها جيدا – أتمنّى أن يكون القارئ كذلك – وإلّا ما عساني أفهم من تعقيبه غير المباشر على ما قاله الشيخ العائد من مؤتمر الدوحة لدعم القدس: قال “القدس بحاجة لبرنامج عمل يتطلّب إرادة سياسية مدعومة من الشعب … القدس تحتاج إلى من يحمل راية العمل وليس من يظلّ يحمل راية المؤتمرات ولا الاستنكارات ولا الشجب” (ص، 31). هذا كلام جميل، لا أشكّ بأنّه “كلمة حقّ يُراد بها باطل”، استنادا على أمور كثيرة، بعضها يُستشف من اليوميات: الشيخ يقول ذلك بعد عودته من مؤتمر عُقد في الدوحة! الدوحة؟! هل من الدوحة، ومن القواعد الأمريكية فيها ستنطلق كتائب تحرير القدس؟! قد يكون هذا الكلام أحد قرارات المؤتمر حتى لو كانت معلنة، وإن لم تكن معلنة، فلا عجب أن تكون لُقّنت للشيخ خلف الكواليس. وإن لم يكن الأمر كذلك، وهذا الأمر الثاني، فلماذا عقّب الكاتب على كلام الشيخ وعلى ما سبقه من أحداث وأقوال، بما يلي: “إنباء (المصالحة) تُراوح مكانها / الناس يزدادون إحباطا / نحن فريق إطفاء حرائق … الحرائق تلاحقنا … الحرائق تسبقنا ونلاحقها … / نحن نلهث. ونلهث. ونلهث … ولكنّنا لا نعترف … المطر لا يقطع الخيوط. ترك المهمّة لغيره” (ص، 31-32). ومن مثل الكاتب يعرف أنّ أوضاع القدس، منذ ذلك المؤتمر، ساءت، ونحن نلهث، وساءت ونلهث، ساءت وساءت، وما زلنا نلهث ونلهث؟! فما رأي المؤتمر في تعثّر المصالحة؟؟ أليس الشجب قولا والدعم الكامل فعلا!
هذه الأوضاع التي عاشها وما زال يعيشها الكاتب، لم يجد وسيلة لمقاومتها إلّا الكتابة. وبما أنّ للكتابة لغتها، فهي تشمل أسلحة أخرى للمقاومة، السخرية مثلا، استخدم منها الكاتب في كثير من يومياته. وهي سلاح لا يُستهان به، له حدود كثيرة، بها يُعبّر الكاتب عن ألمه، وبها يكشف مصدر الألم وينتقده، بل يفضحه أحيانا، وبها أيضا، لا يستثير تعاطف القارئ فحسب، بل يستفزّه إلى المشاركة في الجرح والألم والمقاومة. وقد وظّف الكاتب السخرية بشكل موفق. فالألم مصادره كثيرة، وأكثرها وأهمّها في يوميات إبراهيم جوهر، يوميات القدس والإنسان، هو اللغة والثقافة والسياسة.
على مستوى اللغة العربية، يتألّم الكاتب لحالها وما آلت إليه من إهمال وتهميش، كأنّها لم تعد تعني لأصحابها ما كانت تحمله من وحدة وعلاقات حميمية وهوية وانتماء وتاريخ وتراث. وما يؤلم الكاتب أكثر هو خضوع أصحاب اللغة لثقافة أعدائها. ويُشير بإصبع الاتهام إلى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من إذاعة وتليفزيون وصحافة، التي تُساهم في ذلك الإهمال والتهميش والخراب. ولكنّ الكاتب لا يستسلم، لذلك لا يكفّ عن ذكر طلابه وأصدقائه، من شعراء وكتّاب، الذين لا يُشاركونه الألم فقط، بل يهتمّون مثله باللغة، ويعملون جاهدين عبر مشاريعهم الأدبية والثقافية، على إعادتها لسابق عهدها.
يوميات إبراهيم جوهر، إلى جانب اهتمامها باللغة العربية، هي يوميات أدبية ثقافية بجدارة. ولكنّها أيضا، يوميات سياسية بامتياز. على مستوى الأدب، تحقّقت أدبية تلك اليوميات خارجها وداخلها. خارجها، لاقت رواجا كثيرا بين القراء المهتمّين بالقدس والأدب عامة وأدب إبراهيم جوهر بشكل خاص. وداخلها، لا حدود للسرد الذي يعتمد الخبر والقصة والخاطرة المتوالدة من الحدث اليومي، وما يقتضيه من تناصّ وتداعٍ واستطراد، قد يقود القارئ إلى عوالم يشتهي أن يكون فيها، وكل ذلك بعاطفة صادقة تتدفّق من كل عبارة ينطق بها قلم إبراهيم جوهر نحو القدس وناسها وكل أشيائها الصغيرة والكبيرة. ولا حدود كذلك، للغة الأدبية بما فيها من فصاحة وأصالة وانسيابية تلقائية أخّاذة. وهي في الوقت نفسه، لغة تفيض حزنا وألما وسخرية، تُعبّر عن حزن الكاتب ووجع روحه، تنظر بعين ناقدة، وتضرب الواقع فتوجعه بعبارات لاذعة في سخريتها.
وعلى مستوى الثقافة، لا حدود للأسماء والأزمنة والأماكن والمعلومات التي يوردها الكاتب في يومياته، وكلّها لها ارتباطها بالقدس أو بمشاعر الكاتب نحوها. ولكن، ما يبرز هو ذكره لأسماء أصدقائه من الكتّاب والشعراء، الذين يشاركونه مشروعا ثقافيا يهدف إلى إحياء الثقافة العربية عامة، والثقافة الفلسطينية المقدسية بشكل خاص، وإبراز وجه القدس كمدينة تستحقّ أن تكون عاصمة أبدية للثقافة العربية، وليس لمغتصبيها وثقافتهم. من خلال اليوميات يتعرّف القارئ على رموز الثقافة في القدس. وهي كثيرة سأقتصر على ذكر بعضها، خاصة ممن يُواظبون على حضور ندوة “اليوم السابع” التي تهتمّ بالثقافة الفلسطينية وقراءتها ونشرها. وهي نواة لمشروع ثقافي كبير، يعمل على دفعه إلى الأمام منذ سنوات عديدة، أمثال الكاتب نفسه، وأصدقائه، مثل الكاتب جميل السلحوت، والأديب محمود شقير، والروائي عيسى القواسمي، كما أنّ هناك أسماء نسائية كثيرة مثل: الفنّانة رشا السرميطي، والكاتبة رفيقة عثمان، والكاتبة نزهة أبو غوش، وغيرهم الكثير.
وإذا كانت يوميات إبراهيم جوهر، أدبية وثقافية بجدارة، فهي في نظري يوميات سياسية بامتياز. فهي تحمل همّا وتطرح قضية سياسيين، بلغة مباشرة وغير مباشرة. وبما أنّي أعتبرها سياسية بامتياز، لا بدّ من تقديم بعض النماذج التي تُثبت ذلك، وأنّ الهمّ والقضية السياسيين، هما الدافع الحقيقي الكامن وراء كتابة اليوميات، فهو يقبع في لاوعي إبراهيم جوهر، ويُؤرّقه. وذلك لسبب بسيط يدركه جوهر لا محالة. وهو أنّه رغم صعوبة الأوضاع التي تمرّ بها القدس وفلسطين، لا شيء يخشاه إبراهيم جوهر عليهما مثل السياسة. فهو يعرف ضعف أصنامنا، وخضوعهم واذدنابهم ولهاثهم وراء سياسة لا تضمر للقدس وفلسطين أيّ خير، بل تُضمر ما يخشاه إبراهيم جوهر فقط. ولذلك يجب أن نرى في يومياته من بدايتها، دقّا لجدران الخزّان. لذلك يقتبس في الصفحات الأولى مقالا لشاعر فلسطيني في المنفى اللبناني، يعكس ما يقلقه هو أيضا: “أكتب عن فلسطين الآن، هنا، في زمن نسيانها أو تناسيها. حين معظمنا يُريد التبرّؤ منها والتنكّر لها وتركها في مهب الريح” (ص، 15).
ومن اليومية الأولى، يقترح صديقه، الروائي عيسى القواسمي، أن يُجري معه “حوارا ثنائيا يتناول الثقافة والواقع والأدب واللغة” (ص، 9). كثيرة هي الأشياء التي تؤثّر على الثقافة والأدب واللغة في القدس، ولكن، هل من واقع يُؤثّر عليها أكثر من الواقع السياسي؟! أشكّ في ذلك. ولا يتأخر الإثبات ليأتي في اليومية الثانية. “بعد الظهر تواردت أنباء اقتحام الشرطة للمسجد الأقصى، ومنعها سيارات الإسعاف من الوصول. المسجد الأقصى في طريق محفوف بالمخاطر. القدس على مرمى حجر من التهويد الكامل” (ص، 12). وهل ذكر الخاص، المسجد الأقصى، إلّا من أجل الوصول إلى العام، القدس؟ وهكذا هو إبراهيم جوهر في يومياته، كثيرا ما ينطلق من الخاص إلى العام. وهذا ما نلمسه من دعوة صديق له “لحضور احتفال الجبهة الشعبية في قصر رام الله الثقافي … (يقول) لم أذهب … لسماع خطب سياسية … تابعت جزءا من الاحتفال على شاشة الفضائية الفلسطينية … ولم أشعر بالندم لقراري بعدم الذهاب” (يوميات ص 16). هل رموز هذه الكلمات بحاجة للتوضيح؟!
ولنرى إلى تأكيد الكاتب أنّ السياسة والواقع السياسي هما ما يدفعه للكتابة، وبالأسلوب الذي يكتب فيه. “في السنوات الأخيرة صار الكتّاب السياسيون يستخدمون لغة الأدب والمجاز … إنهم يتغلّبون على قسوة الواقع السياسي بلغة الأدب وفيرة الماء” (ص، 19). وإلى من يُوجّه الكاتبُ التمنّي التالي؟ لأطراف كثيرة؟؟ نعم، هذا صحيح! ولكن هل هناك من يخلف الوعود أكثر من السياسة والسياسيين، وخاصة عندما يكون الأمر متعلّقا بالقدس وفلسطين؟؟!! يقول: “الطبيعة وحدها لا تخلف وعودها!! … ليتنا نقتدي بها” (ص، 26). ليت أصنامنا يقتدون بها!!!
ويهطل على الكاتب مطر أسود! تغرقه الجريدة اليومية بزخّة من الأخبار السوداء. “تشكيل فريق إسرائيلي لتسريع هدم منازل المقدسيين / المستوطنون والقوات الإسرائيلية يواصلون حملات الاعتداء والمداهمة والاعتقال / محكمة عوفر تنظر اليوم في قرار تثبيت الاعتقال الإداري للأسيرة شلبي / الجيش الإسرائيلي يُقيم موقعا عسكريا يقطع الطريق على سكان تل رميدة … مطر أسود … يزداد سواده حين أقرأ أنباء تعثّر المصالحة” (ص، 28). هل ستحرّر يوميات جوهر القدس من الاحتلال الإسرائيلي؟ هل ستدفع مساعي المصالحة إلى الأمام؟ بالتأكيد لا! ولكنها بالتأكيد أيضا، تُجسّد الألم، وتفتح الأعين، وتُفتّح القلوب والعقول.
من لهؤلاء المساكين في تل رميدة، وفي القدس، وفي فلسطين كلّها، إذا كانت سياسة الاحتلال هذه، لا تحرّك الإخوة نحو المصالحة، وأشعر كما يشعر إبراهيم جوهر: لن تُحرّكهم، والمصالحة لن تأتي! فمن لهؤلاء؟! هل ننتظر قرارات مؤتمر الدوحة القادم؟! يقول جوهر: “المطر لا يقطع الخيوط، يترك المهمّة لغيره” (ص، 32). والدوحة ومؤتمرها ليسا بعيدين عن مثل تلك المهامّ. ألا تذكّرنا العبارتان السابقتان بالفرج العربي وأصنامنا الذين لا يربطهم بنا رابط، بينما تربطهم بأعدائنا خيوط لا يقطعونها؟
العينات المذكورة، أخذتها من اليوميات الخمس الأولى. وإبراهيم جوهر لم يتغيّب عن يومياته يوما واحدا طيلة الفترة المذكورة سابقا. أي ما زال أمامنا تسع وخمسون يومية، لا تكاد واحدة منها تخلو من إشارة ولو صغيرة نحو الواقع السياسي المرّ الذي ينحر القدس وإبراهيم جوهر معا، بسكاكين متعدّدة الجنسيات، أكثرها عربية إسلامية موحّدة بربّ القدس والأقصى الذي بارك حوله. فهل نعتبر؟!
وأخيرا، ألا يُبرّر كل ما تقدم، النظرة التشاؤمية التي تلفّ إبراهيم جوهر ويومياته، وتلفّ معهما كل الذين يرون الأمور ويضعونها في نصابها الصحيح بلا مواربة ولا مداهنة؟! هل من غد أفضل تنتظره القدس؟! سننتظر المؤتمر القادم!!!

[1] . جميل السلحوت. يوميات مقدسية لإبراهيم جوهر في اليوم السابع. في: http://www.jamilsalhut.com/?p=1809