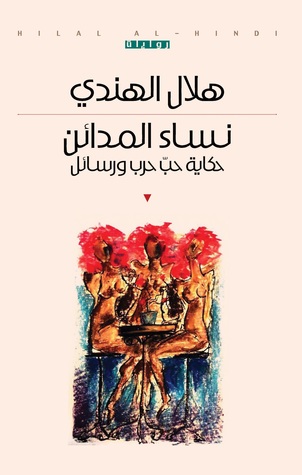قراءة في روايته “نساء المدائن”.
الشاعر والكاتب هلال الهندي، شاب مقدسي يعيش في حيفا، والقدس تعيش فيه. يُحاول أن يربط بينهما وبين غيرهما من مدائن العشق والنساء في فلسطين والوطن العربي، وغيره من بلاد الله التي ارتبطت بها حبال عشقنا، طوعا أو قسرا. وقد جاءت روايته، “نساء المدائن”، أو “حكاية حبّ، حرب ورسائل”، لتجسّد تلك العلاقة مع القدس وغيرها من مدائن العشق والنساء. وهو كغيره ممن لم يجدوا خلاصهم في الشعر، انتقل إلى عالم الرواية والسرد بعد ديوانين من الشعر. والسبب يكاد يكون واحدا لديهم جميعا، تلك المساحة الورقية الشاسعة التي توفرها الرواية ويفتقدها الشعر.
ما من شكّ أنّ الهندي بذل جهدا جديًّا لبناء رواية جيدة، أصاب فيه نجاحا لا بأس به، خاصة في عنصري اللغة والتشويق، بينما ظلّ نجاحه متواضعا من حيث الشكل والمضمون، ربما يرجع ذلك إلى إدراكه المحدود بأسرار الرواية. فهي روايته الأولى، والبداية صعبة دائما. ومع ذلك فأنا أراها رواية أخرى في الاتجاه الصحيح، ترفد أدبنا وإبداعنا المحلي، وأدبنا الفلسطيني عامة، وتضيف لبنة إلى بناء روايتنا الفلسطينية عامة والمحلية خاصة. فهي تحمل همّ فلسطين في الداخل متمثلا بحيفا والناصرة، وفي الأرض المحتلة متمثلا بالقدس التي تمثل فلسطين كلها. وتكشف عمق مأساتنا، وتفضح حالة الاغتراب والضياع التي يعيشها مجتمعنا عامة، وشبابه من نساء ورجال بشكل خاص. إنّها من جهة، رواية البحث المضني التي يعيشها الكاتب وشخصيات روايته، عن هويتهم الضائعة. ومن جهة أخرى، إعلان عن وجود مغترب حتى عن الذات، أو عن وجود ضائع يبحث عن خلاصه من هذه الحالة التي ترفض أن تنتهي.
من حيث الشكل الفني، حاول هلال الهندي أن يستثمر إمكانات التجريب المتاحة له في البناء الفنّي للرواية، ولكنّ نجاحه ظلّ متواضعا، لأنّنا نجده أحيانا، يُدمّر ما صنعه بيديه.
بدءا بالعنوان، “نساء المدائن”، وتفسيره بعنوان ثانوي، “حكاية حبّ، حرب ورسائل”، نشعر بخوف الكاتب من أن لا يستوعب القارئ رسالته. وتنتقل العدوى للقارئ فيُلازمه هذا الشعور بالخوف على امتداد الرواية رغم ما فيها من حبّ، فالقادم، إمّا أن يُلغي الحبّ ويناقضه، وإمّا أن لا يبلغ الحبّ أهدافه المتوخّاة منه. وفي ذلك تعبير عن التشظّي والانشراخ في نفس الكاتب وفي نفوس شخصياته، وفي الواقع الذي تنطلق منه الرواية.
وهنا قد يكون مشروعا أن نطرح السؤال: لماذا الرسائل والانطلاق منها؟ في رأيي، الرسائل تعني الكتابة، والكتابة بحث عن الحرية والخلاص. وهلال، تجثم على صدره مأساة فلسطين ومأساة القدس وبُعْده عنها، وكذلك مأساة المدائن التي فقدت قدرتها على الالتحام بالقدس كما فقدها هلال، أدرك أنّ الكتابة هي ملاذه وخلاصه، فلجأ إليها، شعرا ثم نثرا.
العنوان، “نساء المدائن”، بحدّ ذاته، كان اختياره موفقا، فيه كثير من التشويق الذي يشدّ القارئ إلى عمق النص. ولكنّ الكاتب أتبعه بعنوان آخر، “حكاية حبّ حرب ورسائل”، وهو ملمح ميتاقصيّ أفقد العنوان الأول وهج التشويق، رغم أنّ الكاتب رمى إلى عكس ذلك. ّهذه وغيرها، كلّها وجهات نظر قد تُصيب وقد تُخطئ.
وعند التوغّل في قراءة النص، نجد أنّ هلالا مغرم بالميتاقصّ، لدرجة أنّه تعدّى الميتاقصّ إلى الميتاميتاقصّ. نجد ذلك في العنوان، كما ذكرت، وكذلك في “الفصل الصفر” الذي افتتح به الرواية. فهو من جهة، فصل ميتاقصّي، ومع ذلك فقد بدأه بملمح ميتاقصيّ آخر (ص 9)، يتحدّث عن الفصل نفسه.
أعتقد لو أنّ الكاتب دخل نصّه بدون التورّط بالعنوان الثانوي والفصل الصفر وما فيه من توضيح وتحذير، لكان أفضل له وللنص وللقارئ، إذ لا خوف من بعض غموض يُحرّك القارئ ووعيه وثقافته ومعرفته بالواقع الذي تنطلق منه الحكاية.
اعتمد الكاتب الأسلوب الدائري، البداية من النهاية والعودة في النهاية الى البداية النهاية، في فصل “دخول/خروج” (ص 13 وص 251)، فقد بدأ به الرواية، وبه أقفلها. وهذا جميل قد يرمي به الكاتب إلى أنّنا نراوح مكاننا الآن، في ضياعنا وسؤال هويتنا. وهذا صحيح أيضا. وربما هذا هو ما جعله يترك القارئ بلا شحنة من الأمل، وفعل خيرا أنّه على الأقلّ، ترك الباب مواربا، لم يفتحه على التفاؤل والأمل، ولكنّه لم يُغلقه على اليأس، رغم كل الضياع والأسى الذي نستشفّه من الرواية ومما قالته مريم حول صباح المدينة وكريم الذي لم يحكم شوارعها، وما قالته حول فنجان قهوة كريم وحالاته المتناقضة في الفصل المذكور.
فيما يتعلّق بزمان الرواية ومكانها، اعتمد الهندي زمكانية مشروخة، هذا فضلا عن احتفائه بالمكان أكثر من الزمان، مع أنّ الزمان موجود، ويظهر محدّدا أحيانا وعائما أحيانا أخرى، ومتشظّيا في الحالين، فزمن القدس يختلف عن زمن حيفا، وزمن الحرب يختلف عمّا سبقه ولا تكاد تربطه به صلة واضحة. يشعر القارئ عندما بدأ الكاتب الحديث عن حرب تموز، كأنّه بدأ بقراءة رواية جديدة تصادف ارتباطها بروابط واهية مع ما سبقها. ومع ذلك يظلّ الزمان مرتبطا بالمكان، وإن لم تكن الصلة بينهما وثيقة تماما، لما فيهما من تشظّ واضح كما ذكرت. فالرابط بين حيفا والقدس وغيرها من المدائن، يبدو واهيا في معظم أجزاء النص، وينعكس ذلك من خلال تصرفات بعض الشخصيات، أو انقطاع مشاعرها نحو المدائن (المكان). فالقدس التي لا شيء يشبهها مثلا، والتي ظهرت بكل زخمها في الفصل الأول، تكاد تختفي بعد ذلك إلى آخر الرواية، لولا ظهور متواضع جدا هنا وهناك.
الشيء الوحيد الذي يبرز بوضوح، من خلال الزمان والمكان والتحام الشخصيات بهما، هو التشظّي واللامنطق في العلاقة بين الزمان والمكان والاغتراب والضياع فيهما. أو بين الإنسان والمكان / الإنسان والوطن. أو بين المرأة والمدينة بشكل خاص، وكل الشخصيات بشكل عام.
وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ حبكة الرواية وإن بدت متماسكة في كثير من جوانبها، إلّا أنّها أصيبت بالضعف والترهّل في بعض الجوانب، أبرزها الانتقال للحديث عن حرب تموز في الفصل الخامس والأخير.
الرواية تعجّ بالشخصيات، النسائية بشكل خاص. حضور المرأة كثيف في الرواية، يُظهر موقف هلال منها، فهو يحترمها ويخرج عن مألوف الواقع في مناصرتها والنظر إليها كشريك لا كتابع. يبدو ذلك واضحا من خلال كل الشخصيات النسائية في الرواية. ولكنّ الحضور الذي أعطاها، هو في رأيي حضور سلبي في كثير من نواحيه، يُكرّس الاغتراب والضياع. فسلمى التي قامت بعمل في غاية الأهمية في القدس، اختفت وهربت أو هُرّبت من القدس، ولم نعد نراها إلّا كحلقة وصل هامشية بين مريم والبطل كاتب الرسائل، رغم أنّها تشغل منصبا محترما في الجريدة المعروفة التي تعمل فيها في حيفا.
ومريم، التي عرض لنا بطاقة هويتها في الفصل الصفر (ص 17-19) بدون حاجة لذلك، تقطع الطريق على الراوي/البطل من البداية. “- سينفرط هذا الكون إذا لم نلتقي (يقول لها كريم. فتجيبه مريم) – إذاً لا تتعلّق بي؛ ولينفرط هذا الكون” (ص 33). حاولت أن أفهم الدافع لردّها الجافّ القاسي هذا فلم أفلح. ومع ذلك، يتعلّق بها كريم، ويكتب لها رسائله، وتصلها الرسائل عبر الجريدة. ويلهث القارئ في البحث عن السبب لموقفها الغامض، فلا يجد حتى آخر الرواية إلّا ضياعها وضياع البطل، وضياع القارئ معهما. وهو ضياع لم أجد له على المستوى الشخصي ما يُبرّره في الرواية غير الحالة العامة للضياع. ولا تشذّ مصائر الشخصيات النسائية الأخرى كثيرا عن مصير مريم. فـ “منى” لا تفلح مع حسن ولا مع كريم، ثم تختفي. وعُلا ترفض الذهاب مع سعيد المقدسي إلى القدس، فيترك البلاد. فكأن مدائن هذه الرواية ترفض أولادها وترفض بعضها. وكأنّ الرسائل التي هي لبّ الرواية، لم تُؤدِّ رسالتها، رغم جمال طرحها. فقد أعادت إلى أذهاننا رسائل حبّ سابقة، مثل رسائل مي وجبران أو غسان كنفاني وغادة السمّان، أو سميح القاسم ومحمود درويش، وغيرهم الكثير، فمثل هذه الظاهرة، الرسائل، قديم في الأدب العربي. ولكنّ رسائل هلال (كريم ومريم)، التي كانت عظما وكساها الكاتب لحما بمجموعة من الأفكار والأحداث والشخصيات، حشدها الكاتب حولها، لم تُثمر بالاتجاه الذي توقّعه القارئ على الأقلّ.
والراوي أيضا، ظهر في الرواية بمظهر إشكالي كان من الممكن أن يكتشفه أو يتجاوزه القارئ، لو أنّ الكاتب لم يلفت انتباهنا في تحذيره إلى تلك العلاقة بين الراوي وبين البطل حين قال: “الفرق بين البطل والراوي خيط شديد الدقّة …” (ص 11). هذا التحذير شوّش إلى حدّ كبير تركيز القارئ الذي راح يبحث عن تلك العلاقة فاكتشف الكثير من عيوب الراوي بشكليه: الأنا، الذي جنح للمعرفة بكل شيء أحيانا، والراوي كلّى المعرفة الذي ظلّت معرفته مبتورة بسبب جنوح الأنا. وقد كان بإمكان الكاتب أن يعتمد الراوي كلّي المعرفة، وهذا بدوره يُعطي للشخصيات التي يثق بها حقّ السرد والكلام بضمير الأنا. ما قد يُعطي للسرد والسارد مصداقية أكبر.
تقوم الرواية على استرجاع الراوي والبطل لكل أحداثها. وهذا ظاهر على امتداد الرواية، ولكنّه لم يمنع الكاتب والراوي من التصريح بذلك في عبارة أخيرة لا حاجة لها: “ما أسوأ أن يستعيد عاشق ذاكرة كهذه”(ص 254)، فهي لم تزد على أن تكرّس بشكل هشّ حالة الاغتراب والضياع التي عاشها الكاتب وشخصياته، وكذلك القارئ على امتداد الرواية.
ومهما يكن من أمر الشكل الفنّي وما فيه من سمات الضعف أحيانا، إلّا أنّ ما لا يمكن إنكاره هو لغة الرواية الشاعرية وأسلوبها الشيّق، وهما العنصران الأبرز في الإمساك بتلابيب القارئ حتى النهاية. فاللغة تجنح إلى الوضوح والمباشرة أحيانا، وإلى الترميز كثيرا. وهي في معظم حالاتها لغة شاعرية تُذكّرنا بأن الكاتب هبط إلى عالم السرد من سماء الشعر التي حلّق فيها سابقا.
أما من حيث المضمون، فالرواية في نظري، هي رواية الضياع والخراب والبحث الفلسطيني، الفردي والجمعي، المضني، عن الذات وعن الهوية في الزمن الراهن الذي تشظّت فيه الذات الفلسطينية، ففقد فيه الإنسان الفلسطيني، فردا وجمعا، ذاته وهويّته، وبات يعيش في عالم من الاغتراب والخراب والضياع، ويُصارع في يباب عربي قاتل لم يترك لا للفرد ولا للشعب ولا للأمّة، بصيصا من أمل.
البداية من الصفر هي بداية إشكالية، فهي قد تعني البتر، أو الانسلاخ عن الماضي الذي فقدناه، أو مع الحاضر الذي نضيع فيه، أو مع المستقبل الذي نخافه ولا يهمّنا إن أتى أو لم يأتِ. وقد تعني المحاسبة أيضا. فهل يُحاسب هلال الهندي المدائن على خطيئتها مع النساء فقط؟ وما هي المدائن إن لم تكن نحن؟ و”نحن” تعني المجتمع برجاله ونسائه وليس المجتمع برجاله فقط.
ومن البداية يُبين لنا الكاتب موقفه السلبي من المدائن المذكورة في الرواية (القدس، حيفا، الناصرة)، لأنّه يبدأ النص باعتذاره لها قبل الفصل الصفر. واعتذاره من غيرها أيضا، لأنّه في فقرة “دخول/خروج”، قبل بداية الرواية وفي نهايتها، يقول لنا أنّ الزقاق الذي تعلّق به قد يكون في دمشق أو بيروت أو عمان أو بغداد أو القاهرة أو الجزائر العاصمة. وهذا ما نفهمه أيضا من الفقرة الثانية في التحذير الذي يراه الكاتب ضروريا ولا أراه أنا كذلك، عندما يقول: “الحكاية هنا فضيلة النساء وخطيئة المدائن”. ومن هذه العبارة كذلك، نفهم موقفه الإيجابي من النساء. وفي الحالين، لم نستطع أثناء القراءة استنادا على الأحداث وخطّ سيرها، أن نُحدّد فضيلة النساء، وما إذا كانت خطيئة المدائن معهن، هي خطيئة اجتماعية أو سياسية أو كليهما. جاءت رسائل الحبّ في الرواية لا تُعبّر عن الحبّ بقدر ما تُعبّر عن الضياع. ورغم احتفاء الرواية وكاتبها بالمرأة، ورغم ما أسند لها من أدوار، إلّا أنّها لم تستطع أن تُمسك بيد الرجل وأن وتحول دون ذلك الضياع الذي يغرق فيه الإنسان الفلسطيني حيثما وجد، في الوطن وخاصة في الداخل الفلسطيني الذي تمثلّه حيفا والناصرة، بل تركته يتوغّل في ضياعه. ومن هنا يبدو البحث عن الذات وعن الهوية، وكأنّه غير ذي جدوى. هذا ما نستشفه: أولا من الرسائل التي عجزت عن ربط حبل المودّة بين كريم ومريم، وثانيا من سائر العلاقات بين الرجل والمرأة في الرواية. فكل العلاقات لم تفضِ إلى شيء، ما يُؤكّد أنّ كل المحاولات لاسترجاع الهوية والخروج من الضياع والخراب، هي محاولات عاجزة.
في الفصل الأول تبدأ أحداث الرواية زمن الانتفاضة الثانية، مع سعيد المقدسي وسلمى ابنة مجد الكروم، في القدس حيث كانت سلمى تعمل في الصحافة وتصوير “اشتباكات الجنود الإسرائيليين والشبان في البلدة القديمة” (ص 26)، لتعكس بذلك أوضاع القدس المشحونة ببشاعة الاحتلال والخوف منه وسبل مواجهته في آن معا. ولا أدري لماذا ذكر الكاتب أنّ سلمى من مجد الكروم، ولم يستثمر هذا الانتماء أبدا، إلّا ما قد يتبادر إلى ذهن القارئ من أنّ نساء القرى تحضرن وأصبحن ذوات شأن.
ثم تنتقل الأحداث إلى حيفا حيث يسكن كريم في بيت واحد، مع شابين آخرين هما سعيد وحسن، جمعت بينهم علاقة كانت في بدايتها “عادية لا شيء يُذكر فيها سوى أحاديثنا الغريبة آخر الليل عن القدس والناصرة وحيفا” (ص 36). ويتعرّف كريم في الجامعة، على مريم، ابنة الناصرة التي تصدّه، فيكتب لها رسائله غير المعنونة، وينشرها بدون ذكر اسمه، في الصحيفة التي تعمل فيها. أمّا الناصرة، فيكتشفها البطل في آخر الرواية. “اكتشفت أنّه لكي تتعرّف على المدائن، عليك السير في شوارعها ليلا، ولكي تكتبها، عليك أن تتخبّط في قلب فتاة تنام في ليلها الطويل وتحلم” (ص 234). كانت الناصرة قبل ذلك معزولة رغم أنّها عاصمة الجماهير العربية. وحبّ فتاة من فتياتها، لم يُثمر، ولم يُخرجها إلى النور الذي يليق بها.
أزعجتني جدا المقابلة بين القدس ولندن. “القدس ليست لندن، والفرق بينهما أن لندن لم يدخلها غزاةٌ أبدًا. القدس لم يدخلها إلا الغزاة. لندن لها حنين حضاري يدفع كلّ من سكنها أن يتحدث عنها برغبة وحبّ، أما القدس فلها حنين يقتل ويُجبر كل من سكنها على الرجوع إليها” (ص 35).
أن يُقابل هلال بين القدس ولندن، فكريا وفنيا، تاريخيا وحضاريا، هذا شيء جميل، وأنا اتّفق معه فيما قاله عن القدس، ولكن ليس فيما قاله عن لندن. ليس هنا، وفي مثل هذه الرواية على الأقلّ، الموقع الصحيح للحديث عن الحنين الحضاري إلى لندن. كان من الأفضل لو ذكر حنين من يسكنونها للغزو، وهو حنين مستمرّ حتى اليوم، تُعاني منه القدس ومن سكنها، ومن يُحب الرجوع إليها. نحن بالذات، وكثيرون غيرنا، ربما نتحدث عن لندن برغبة ولكن بالتأكيد ليس بحبّ. فينا من الإنسانية ما يجعلنا لا نكرهها، ولكن إذا ربطناها بالقدس وفلسطين، وما حدث لهما وما زال يحدث، فنحن بالتأكيد لا نستطيع أن نحبّها. وإذا قابلنا ما قالته الكاتبة ليلي الأطرش عن القدس: “حين تنظرين الآن في المرآة سترين فقط ظلال رجال عبروا يوما على طريقك”، وما قاله محمود درويش: “وما القدس والمدن الضائعة سوى ناقة تمتطيها البداوة إلى السلطة الجائعة … وما القدس والمدن الضائعة سوى منبر للخطابة ومستودع للكآبة … وما القدس إلا زجاجة خمر أو صندوق تبغ ولكنها وطني”، إذا قابلنا ذلك بما قاله هلال الهندي عن لندن سوف نعرف أنّه أخطأ لأن الوضع الذي وصفه كل من ليلي الأطرش ومحمود درويش، كان وما زال للندن وحكّامها الدور الحاسم فيه.
أمّا حربّ تمّوز، فهي أيضا عمّقت الضياع واستحالة التفاهم مع الآخر الذي هو سبب ضياعك أو أحد أسبابه على الأقلّ، حيث اللقاء في الملاجئ معه أدّى إلى الصدام وليس إلى التفاهم. وكذلك علاقة كريم بـ “منى” انتهت باختفائها زمن الحرب وفي اللحظة الحرجة التي يحتاجها فيها.
والقهوة التي لعبت دورا في الرواية، كنّا نتوقع أن تساعد في رأب الصدع، ولكن الخلطة بين ثلاثة أنواع من البن: بن الفاهوم (الناصرة) وبن إزحيمان (القدس) وبن الوادي (حيفا)، والتي تُمثل اللُّحمة وجيل الأصالة، صارت فيما بعد مجرد ذكرى. “تذكر قهوة زمان؟ … نعم، كنت أحضر أنا قهوة من الناصرة (بن الفاهوم) وسعيد كان يُحضرها من القدس (بن إزحيمان) وأنت كنت تذهب إلى (بن الوادي) هنا في حيفا لتحضر الثلث الأخير، والهيل جانبا، ألا تذكر؟ … هذا ما سنذهب لنتذكّره الآن يا حسن” (ص 225). هذه القهوة الأصيلة، تغلّب عليها الأسبرسو الذي يُمثّل جيل الضياع وفقدان الهوية والانتماء؟
لا شكّ أن الرواية حقّقت هدفها بشكل جيد من حيث متعة القراءة. ولكنّها من حيث الرسالة لم تترك في نفس القارئ وفكره، رؤية مستقبلية متفائلة، أو رؤيا تشحنه بأمل ما. فقد لامس الكاتب نقد المجتمع وفضحه، ولكنّه أيضا، أشاد ببعض جوانبه التي تمثلت بعمل سلمى في القدس وطريقة تهريبها من وجه جنود الاحتلال، ولكن سلمى اختفت من القدس، والقدس اختفت من الرواية بعد الفصل الأول. وظهورهما المتواضع لاحقا، لم يأخذ دوره الصحيح في تطوّر الأحداث، كمدينة لها سطوتها، وكامرأة تعرف ما تريد.
ويظلّ البحث عن المستقبل في الرواية، محكوم بما قاله الكاتب في الفصل الصفر: “الأحداث مستوحاة من واقع لم يحدث وربما لن يحدث”. وهكذا يظلّ حاضر الضياع وفقدان الهوية هو المسيطر إلى آخر الرواية التي تظلّ محكومة بالعلاقة اللامنطقية، والواهية غالبا، بين الماضي الذي عشناه، والحاضر الذي نعيشه، والمستقبل الذي لا نجزم بإمكانية حدوثه، حيث يظهر الكاتب راضيا عن الماضي أكثر، متذمّرا من الحاضر، خائفا من المستقبل. وهكذا تفقد الرسائل قيمتها في نظر الكاتب نفسه حيث قال: “الرسائل التي لا تصل، لا طائل من كتابتها”. كيف تعرف أنّها لن تصل إذا أرسلتها للعنوان الصحيح؟ هل هيّأت لها القناة الصحيحة؟ أم أنك أرسلتها إلى لاعنوان؟ في نظري أخطأ هلال الهندي في توظيف رسائله إذ جعل لها تلك النهاية المتشائمة، خاصة وأنّها وجدت الكثير من الاهتمام لدى مريم وفي الجريدة، ولدى القارئ كذلك، وأخطأ في رسم بعض شخصياته، خاصة سلمى ومريم. فبدل أن يتّخذ منهما مساعدا على الخروج من حالة الضياع، جعلهما تكريسا لها. كأن مجتمعنا وشعبنا يستمرآن هذا الضياع، فلا يبحثان إلّا عن كيفية التعايش معه! أمّا إذا اعتبرنا ذلك نوعا من جلد الذات، فواقعنا قد أدمن هذه اللذة القاتلة، ولم تنتقل هذه العدوى إلى أدبنا من فراغ.