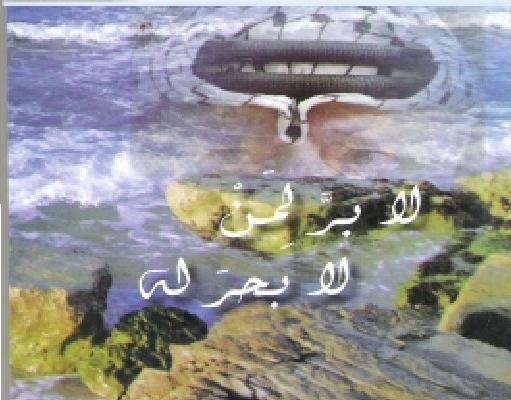قراءة سريعة في ملفات نائلة عطية
(هذه الدراسة قدّمت كمداخلة في حفل تكريم للكاتبة بمناسبة إصدارها الأول أقامه “الصالون الأدبي” التابع لـ “دار الثقافة والفنون” في الناصرة بتاريخ 15.02.2013، ونشر بعد ذلك في الموقعين المذكورين سابقا)
يسعدني أن أتعرّف من خلالكم على الكاتبة نائلة عطية، هنا في ناصرة توفيق زياد وفي مؤسسته، وفي قاعة دار الثقافة والفنون، هذه الصروح الثقافية الوطنية العريقة. حبّي للناصرة وأهلها هو ما دفعني أيضا، للتعرّف على الكاتبة من خلال كتاباتها، وإن كانت مجموعتها القصصية وحدها سببا كافيا، فهي بلا شك تستحقّ القراءة. نحن نحتاج هذا اللون من الكتابة الأدبية والتوثيقية، ومجال نائلة عطية مثقل بما يجدر توثيقه. نحتاج هذا النوع من الكتابة ليعرف كلٌّ منّا أنّ هناك أناسا يضحون أكثر منه، ويدفعون ثمنا باهظا لنضالهم، وأنّ القصص التي ترويها نائلة، عايشناها جميعا وعشنا بعضها، وكل واحد منا معرّض لأن يكون بطلا من أبطالها، لذلك، على كل واحد منّا أن يرسم في الإطار العام، طريق نضاله الخاص.
الكتابة بأشكالها، والسرد بشكل خاص، هما ذلك المعشوق الذي نعبده لنحظى بالحرية التي فضّلها أبو البشر على قيد الفردوس، وعشبة الحياة التي بحث عنها جلجامش، والسيف والقلم اللذان أوقعا بالمتنبي، قد أوقعا بالكاتبة نائلة عطية أيضا، لأنها تعشق الحرية، لها ولشعبها وللإنسانية، وهي تعرف أنّ الكتابة فعل حرية، وبخاصة السرد الذي نبحث به عن الحقيقة. ولكنّ الروائيين اليوم يبحثون عن الحقيقة والقيم في مستنقع موبوء، وإضافة إلى ذلك، تبحث نائلة عنها، أمام قضاء الغطرسة والقوة الغاشمة، ذلك القضاء الذي يرى نائلة وحقيقتها الأصيلة باطل الأباطيل، ويرى الحقيقة الزائفة التي ترسمها عنجهية القوة، قدس الأقداس.
تبحث نائلة عن الحرية، وعن قيم الخير والحب والجمال في عالم شيطاني منحطّ، شوّهه ودنّسه ذوو الحقائق الزائفة، التي يفصّلها المشوّهون على مقاساتهم. رأت نائلة أنّ مهمّتها المهنية لا تكفي، ولا تكتمل إلّا بالكتابة، والكتابة، كفعل حرية، تعبّر عن الألم والمرارة تارة، وعن الأمل والحلم تارة أخرى. وتكشف وتنقد أحيانا، وتعرّي وتفضح أحيانا أخرى. وهذا ما سعت إليه الكاتبة، فجاءت مجموعتها القصصية، لتكتمل بها المهمّة التي بدأتها محامية تدافع عن الحقّ والحقيقة في أروقة القضاء، فتفضح سادية الظلم ووحشية القمع والاحتلال، بوقوفها إلى جانب المظلومين من أبناء شعبها، أمام قضاء ملوّث، يغرّم الضحية ويُبرّئ الجلاد.
“من ملفاتي … لا برّ لمن لا بحر له”، هذا العنوان، جاء موفّقا شكلا ومضمونا. العبارة الأولى، لخّصت الشكل فأوحت بالكشف والتوثيق، والعبارة الثانية، لخّصت المضمون، لا أقصد مضمون ما تقوله نائلة بين غلافيّ كتابها فقط، وإنما قضية شعبها الذي يرزح تحت نير الاحتلال، وتناضل هي دفاعا عن حقوقه على أكثر من جبهة، لتثبّت حقّه في برّه وبحره.
وكانت الإهداءات موفقة هي الأخرى، فمن الإهداء إلى الأمّ، التي هي بحدّ ذاتها وطن، إلى الإهداء إلى الرموز، الذين حملوا هَــمّ الوطن، وأدركوا حجم المؤامرة، فناضلوا من أجل تثبيت حقّ شعبهم بالحياة في برّ الوطن وبحره، وأعدّوا الأجيال لتتابع النضال بعدهم، لكيلا تموت الحقيقة، ولا يضيع الحقّ.
الرواية، كما يراها منظّروها الكبار، جنس أدبي غير منتهٍ. بمعنى أنها جنس أدبي يواكب الحياة، ويتسع للكثير من الأجناس الأدبية الأخرى، وللكثير من الأشكال والمضامين كذلك. وهي تاريخ من لا تاريخ لهم، ونائلة تكتب في قصصها تاريخ الأبطال الحقيقيين، الناس البسطاء المهمّشين. وقصص المجموعة، يمكن اعتبارها فصولا لرواية واحدة، توثق الأحداث وتبحث عن نهايتها. وهي ما يُعرف بالرواية الوثيقة. ونائلة في مجموعتها، أو روايتها، شأنها شأن معظم الكتاب الذين تعاملوا مع رواية السجن والقصص التي لها علاقة به، سواء عاشوا تجربة السجن أو عايشوها، معظمهم اهتمّ بالتوثيق أكثر من اهتمامه بالجانب الفني، وذلك لإصرارهم على توثيق المعاناة، وفضح الممارسات الوحشية التي يمارسها الحاكم القامع ضد المحكوم المقموع، وبحثا عن طرق جديدة للنضال كذلك.
من اللحظة الأولى وفي القصة الأولى، تضعنا الكاتبة في الصورة القاتمة لوحشية الاحتلال، إذ تقول: “كنت متوجهة في طريق عودتي إلى مدينتي الساحلية حيفا للمبيت هناك، حيث بيت والدتي، فقد كانت مدينة رام الله مغلقة المداخل بالدبابات، والقدس محاصرة ولا طريق من بيتي إلى مكتبي إلا الطريق الالتفافية حولها، وهي طريق غير آمنة، ومزروعة بالمدرّعات.” هذه الصورة تلخص بكثافتها وحشية الاحتلال. والمجموعة في مجملها، سلسلة من الأحداث والقضايا، الفردية أحيانا، الجمعية أحيانا أخرى، التي تشكّل حلقاتٍ في تاريخ وقضية، هي قضية شعب شرّدته النكبة ومزّقه الاحتلال. ورغم هول ما رأى، لم يفقد الأمل، فتابع نضاله من أجل إحقاق حقّه في ممارسة حياته بحرّية، في برّ الوطن وبحره. والاحتلال يستدعي النضال، والنضال يستدعي المواجهة مع الغاصب المحتلّ، والمواجهة مع المحتلّ تستدعي الاعتقال والسجن، إن لم يسبقهما القتل، والاعتقال والسجن يستدعيان نائلة، لتمارس نضالها بطريقتها الخاصة: أولا كمحامية، تدافع عن أبناء شعبها المظلومين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، وتمثلهم أمام قضائه، فتحاول التخفيف عنهم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. لا تدّخر جهدا ولا وقتا، وتذوق هي الأخرى مرارة التشرّد من خلال تنقّلاتها المكوكية بين المحاكم والمعتقلات والسجون، تفرح بما تحقّقه للمظلومين من انتصارات مهما كانت صغيرة. تفرح لإفراج أو تخفيف حكم تحقّقه لمعتقل أو سجين، وتفرح لبسمة تعلو شفتيه أو شفتي أحد ذويه. وتحزن وتبكي كذلك، لما تشاهده من حالات إنسانية تعكس بشاعة الاحتلال، وآثار ممارساته الوحشية.
وثانيا، تناضل نائلة ككاتبة، تكشف وتفضح وتوثق، فكتابها الذي بين أيدينا، يمكن أن يقرأه كل عربيّ، فلسطيني على الأقلّ، تستفزّه الكاتبة، أولا إلى المعرفة، وثانيا، إلى دوره كشريك يجب أن يُساهم بحصته من المسؤولية والنضال.
تمتدّ أحداث الرواية، التي تحملنا الكاتبة إلى بعضها عبر الذاكرة، تمتدّ على مساحة زمنية تعود إلى ما قبل النكبة أحيانا، وتستمرّ لتطال بدايات القرن الحالي، إن لم أقل يومنا هذا، إذ يمكن اعتبار المجموعة سردا مفتوحا لرواية أحداثها ما زالت مستمرة. وبكل تأكيد، ما زال في جَعبة نائلة الكثيرُ مما يعزّز ذاكرتنا الجماعية. وهي تُصرّ في قصصها على جانب التوثيق والكشف والفضح، لكّن ذلك لا يعني أنّ قصصها تخلو من بعض الملاح الفنية، أو من متعة السرد وجمالية التخييل. مثلا: أحداث القصة الأولى، “لا برّ لمن لا بحر له”، أي قصة السفينة اللبنانية وبحاريها، هي أحداث عايشناها جميعا، وأن يكون القائد الرمز المرحوم أبو عمار قد طلب من الكاتبة تمثيلهم والدفاع عنهم، فأمرٌ لا ترويه الكاتبة إلّا لأنه حدث فعلا، أما أن تكون قد رجعت إلى حيفا في اليوم ذاته الذي قُطرت فيه السفينة إلى ميناء حيفا، وشاهدتها الراوية بأمّ عينها وهي تُقطَر محاطة بسفن خفر السواحل الإسرائيلي، قبالة “تل السمك” ومسبح “بوتاجي” اللذين تُعرّفنا الكاتبة بتاريخهما، وكذلك قبالة مقام الخضر الذي كان مسلما فأرغِم على أن يصير يهوديا، فذلك بعض ما يُظهر لي قدرة الكاتبة على تخييل السرد، وقدرتها على مزج التخييل بالواقع الذي يحيل إلى المرجعية الجغرافية والتاريخية التي ينطلق منها السرد في نصوصها. إذ لا بد لأيّ نص من مرجعية، قد تكون جغرافية أو تاريخية أو اجتماعية أو أيديولوجية، أو كلها مجتمعة. وكل هذه المرجعيات تحيلنا إليها نصوص نائلة.
في الجانب التوثيقي، تهتمّ الكاتبة بنقل المعاناة التي يعيشها شعبها، أفرادا وجماعات. الأفراد في سجون الاحتلال وزنازينه، والشعب في السجن الكبير، الوطن المحتلّ، داخل جدار الفصل العنصري. والسجّان هوة السجّان ذاته، والمفارقة، أو المضحك المبكي، هو أنّ المدّعي والقاضي هما السجّان ذاته أيضا. فكيف لمن يُمارس القمع ويباركه، أن يُنصف المقموع؟ وهكذا، تأخذ المعاناة التي توثقها المجموعة القصصية، أبعادا إنسانية تفوق أبعادها المهنية، فتصرّ نائلة على فضح الاحتلال كقاضٍ بقدر ما تصرّ على فضحه كسجّان، لأنّ القضاء في مثل هذه الحالة، هو قضاء مزيّف، لا يسعى لنشر القيم الإنسانية وفي مقدّمتها العدل، وإنما يعمل كمستشفى متخصّص بإجراء عمليات تجميل لوجه السجّان البشع، وجه الاحتلال. وزيادة في التوثيق، فهي تذكر الأحداث بتواريخها المحدّدة، في القصة الأولى مثلا، تتحدث عن عملية القرصنة البحرية التي مارسها خفر السواحل الإسرائيلي ضد السفينة اللبنانية، “سانت توريني”، وطاقمها المكوّن من أربعة بحارين لبنانيين، وتحدّد أنّ ذلك حدث يوم الأحد عصر السادس من أيار 2001.
من خلال توثيق الأحداث، وتأكيدا لواقعيّـتها، تنقل الكاتبة أسماء الأشخاص كما هي في الواقع، خاصة أسماء المناضلين المعتقلين، وذويهم، وأسماء من يساعدها في مهمّتها. وتحملنا إلى أماكن نعرفها. توثق أسماء المحاكم والمعتقلات والسجون، التي لا بدّ زرناها مرة، أو سمعنا وقرأنا عنها في وسائل الإعلام، وتذكر أسماء المدن والمخيمات وكل الأماكن الفلسطينية التي تتنقّل بينها، وفيها، لممارسة مهمّتها. ولا تنسى الأماكن حتى الصغيرة منها، التي ربما يكون بعضنا قد نسيَها. لا تنسى، كما سبق وذكرت، “تل السمك” حين تمرّ به. ذلك التل قليل الارتفاع إلى الجهة الجنوبية الغربية لحيفا، يحوي أثاراً تعود للفترة البيزنطية، كبقايا بيوت وكنيسة وفسيفساء.
وعلى التل والشاطئ أقيم مسبح عُرف بمسبح “بوتاجي”، نسبةً لعائلة “بوتاجي” الثرية في حيفا التي امتلكته حتى النكبة، حينها استولت إسرائيل عليه”. كذلك لا تنسى ذكر مقام “الخضر” عند مرورها به. وتذكر أنّ عائلة خالد وهاني الحسن كانت تتولّى حراسته حتى النكبة، وكيف حوّلته وزارة الأديان الإسرائيلية إلى مقام يهودي، وقامت بتجريده من كل علاماته الإسلامية. ولا تنسى الكاتبة في قصة “لا … لا لن يمرّوا” أن تذكّرنا بقرية الطنطورة التي تطلّ عليها كلما سافرت في الطريق الساحلي، من حيفا وإليها، الطنطورة التي هُدمت في النكبة وشُرّد أهلها بعد المجزرة الرهيبة التي نفّذتها قوات “الهاجناه” التي جمعت رجال القرية ورمتهم بالرصاص ودفنتهم في قبر جماعي.
إنها إشارات واضحة إلى الحقيقة الثابتة تاريخيا، عربيا وفلسطينيا، وإلى محاولة طمس معالمها العربية والتاريخية من قِبل إسرائيل. وفي هذه الإشارات تربط الكاتبة بذكاء، بين القارئ، وبين أسماء الأشخاص والأماكن، ليعي العلاقة بينه وبينهم. وتربط بين أسماء الأشخاص والأماكن، قبل النكبة وبعدها، لتربط بين الإنسان والمكان والزمان، وبذلك تربط بين الحاضر والماضي، من خلال حقائق تاريخية ومعالم جغرافية وتاريخية ما زالت شاهدة على التاريخ والجغرافية الحقيقييْن، وعلى محاولات التشويه والتزييف التي تمارسها إسرائيل.
وإذا نظرنا إلى المبنى والشكل الفني لقصص المجموعة، سنجد أنّ الكاتبة اهتمّت به أيضا، وإن كان ذلك بتواضع ملحوظ. ذكرتُ سابقا أنّه يمكن اعتبار قصص المجموعة فصولا لرواية واحدة، لأنّ هناك الكثير من الروابط بينها، حتى لو لم تقصد الكاتبة إلى ذلك. سنجد في كل القصص مثلا، أنّ الراوية والبطلة هما شخص واحد يتماهى بشكل يكاد يكون مطلقا مع الكاتبة، فهي الراوي الأنا الشاهد المشارك البطل، الذي يسرد الأحداث بضمير المتكلم. الكاتبة تنتقي قصصها من ملفاتها كمحامية، والراوية تسردها من وجهة نظرها. والراوي الواحد في القصص كلها، هو تقنية تدعم التوثيق. ولكنّ الراوية البطلة، المحامية التي تحدّد أهدافها وتسعى إلى تحقيقها، ليست مجرد راوية، وإنما هي تعبير عن موقف أيديولوجي، موقف الكاتبة طبعا، فهي تؤمن بالديمقراطية والتعدّدية، يظهر ذلك واضحا من عدم استئثارها بالبطولة، فهي تتقاسمها مع إبناء شعبها الذين يشكّل اعتقالهم وسجنهم مظهرا من مظاهر نضالهم وصمودهم، الذي تمجّده وتخلّده وتراه يفوق مهمتها النضالية. وسواء نظرنا إليها كراوية للأحداث، أو كبطلة فيها، أو كمحامية تمارس مهنتها بموضوعية ومهنيّة، وهي لا تتوخّى الموضوعية والمهنية إلّا للضرورة، سنراها في صورها الثلاث تلك، ليست محايدة أبدا، وإنما ترى نفسها جزءا من الإنسان والمكان والزمان والقضية، ويبدو ذلك واضحا في القصة الأولى، “لا برّ لمن لا بحر له”، حين تتذكر الراوية زيارتها لمخيم الشاطئ في غزة بصحبة والدها: تقول: “يومها تحدثنا مع الأطفال الذين كانوا في مثل سني. لقد كنا متشابهين بالهمّ، فلم أجد فارقاً يُذكر على قدر استيعابي بين أن تكون ابن وادي النسناس الحيفاوي، أو مخيم الشاطئ الغزاوي” (ص 23).
ويظهر ذلك صارخا في قصة “استشهاد مصطفى العكّاوي”، في ردّها على زميلتها ليئة تسيمل التي بلّغتها أنّ مصطفى مات، تقول: “فصرختُ: استشهد” (ص 170). هذه الصرخة هي تدفّق عاطفي له دلالاته. وبهذا تختلف نائلة عطية عن فليتسيا لانغر المحامية اليهودية الشجاعة، التي سبقت نائلة إلى مثل هذا اللون من الكتابة في ملفاتها الخاصة، وفي كتابها “بأمّ عيني”، حيث كان دافع فليتسيا إنسانيا ومهنيا، إما عند نائلة فهو عاطفي ووطني بالأساس، ثم إنساني ومهني. ويمكن أن نرى ذلك أيضا في آلامها ودموعها أحيانا، وفي علاقاتها مع المعتقلين وذويهم، وفي علاقتهم الحميمية بها وحبّهم لها. وكذلك في اللغة الواحدة المشتركة بينها وبينهم. يبدو ذلك واضحا في المشهد التالي، في لقائها مع أمّ كامل، أم أحد المعتقلين في مخيم “الأمعري”، في قصة “العكّاوي” نفسها، تقول عن أمّ كامل:
“تجبرني على الدخول، لتشمشم رائحة ابنها، كعادتها حين أعود من زيارته في الاعتقالات السابقة. وتبكي موّلولة مشتاقة وتسأل ألف مرة لتتأكد:
أكيد شفتيه؟
كيف حاله؟
وينتا بده يرّوح يا حبيبتي؟
أتركها بعد أن تعانقني عناق الأمّ … وما أحوجني إليه بعد يوم كهذا” (ص 169).
ولا بدّ من الانتباه أيضا، إلى قصة “تُهم لا تُخجل”، ومدى اهتمام الكاتبة بسمعة شعبها ودفاعها عن قيمه، عندما تفانت في الدفاع عن الصبيان الأربعة لتبرّئتهم من التهمة، المخجلة ولكن الكاذبة، التي ألصقها الاحتلال بهم، وهي محاولة اغتصاب فتاة يهودية. الراوية، أو الكاتبة في نهاية القصة، تجعل الصبيان الأربعة بعد أعوام، بعد أن صاروا شبابا، تجعلهم يناضلون ويدافعون عن شعبهم ووطنهم، وتمثلهم هي أمام القضاء ولكن، بتهم لا تخجلهم.
والزمن في قصص المجموعة، نجده كذلك مشتركا بشكل ما، وهو أيضا يدعم التوثيق، فرغم تعدّد الأحداث وتشتّتها أحيانا باختلاف زمانها ومكانها، إلّا أنّ هذه الأزمنة، يربط بينها، بل يوحدها زمن واحد، هو في الحقيقة زمنان زائفان: زمن إسرائيلي يُمارس فيه الاحتلال بكل موبقاته، وزمن فلسطيني رازح تحت الاحتلال.
ولا يختلف المكان عن الزمان، إذ رغم كثرة الأمكنة التي تتنقّل بينها وفيها الراوية، من محاكم ومعتقلات وسجون، ومن مخيمات فلسطينية تزور فيها ذوي المعتقلين، يمكن اختزال تلك الأماكن في مكان واحد يضمّها جميعا، هو الوطن الفلسطيني المحتلّ. وقد نجحت الكاتبة في أكثر من موقع بكشف العلاقة النفسية التي تربطها هي شخصيا، وتربط الشخصيات الأخرى بالزمان والمكان معا. وقد رأينا كيف جعلت حيفا ملاذها حين يستعصي بقاؤها أو دخولها إلى الأماكن المحاصرة في الوطن. وهذا بحدّ ذاته يشكّل رابطا بين حيفا والأماكن الأخرى التي تتحرّك فيها الراوية أو الكاتبة، يحلّ أحدها مكان الآخر عند الحاجة، فكلّها وطن. وقد رأينا تلك العلاقة واضحة في قصة “استشهاد مصطفى العكّاوي”، حين قالت له الكاتبة “أنا حيفاوية يا عكّاوي” (ص 164). وجدير بالذكر أنّ هذه العبارة بالإضافة إلى تعبيرها عن تشابك الأماكن، تبثّ الكثير من الطمأنينة والدعم في نفس المعتقل، وتُؤكّد وعي الكاتبة لمهمّتها.
أمّا الشخصيات، فالكاتبة ترسمها بكل واقعيتها. تنقلها ببساطة كما هي، من أروقة الواقع بزمانه ومكانه، إلى الزمان والمكان ذاته، ولكن في أروقة الحكاية. وهي شخصيات كثيرة يمكن أن نهتمّ في هذه العجالة، بثلاث منها:
أولا، شخصية الراوية، المحامية والإنسانة التي تتوكّل بالدفاع عن قضايا المظلومين من أبناء شعبها، وهي تقوم بدورها بدافع وطني وإنساني ومهني. اعتراف الراوية بوجود غيرها ممن يساعدونها ويقومون بالعمل ذاته، للدوافع ذاتها أو بعضها، يُسجّل مأثرة للكاتبة والراوية معا، فهي تذكرهم بالاسم. المحامية اليهودية ليئة تسيمل مثلا. وهذا بدوره يحيلنا مرة أخرى إلى أيديولوجيا الكاتبة وكونها شيوعية أممية.
ثانيا، شخصيات المعتقلين الذين ينفرد كلّ منهم بقضيته الشخصية أحيانا، كضحية من ضحايا الاحتلال، وبطريقته الخاصة في النضال، إلّا أنّ تلك الشخصيات هي في الواقع أجزاء لشخصية واحدة، الضحية الجمعية التي تقاوم الجلاد، شخصية الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، وهو يناضل، أفرادا وجماعات، فيدفع أبناؤه حياتهم ثمنا للدفاع عن حقّه في الحياة والحرية.
وثالثا، شخصية الجلاد، التي تتمثل في المجموعة، بأفراد من رجال الجيش والشرطة والمحقّقين والقضاة العسكريين، يمارسون كل أصناف الإذلال، من اعتقال وتعذيب وإهانة، تميّزت بوحشيتها واختراقها لكل القوانين والمواثيق الدولية، وبتحقيرها لكل الأعراف والمشاعر البشرية. وهذه الشخصيات أيضا هي أجزاء لشخصية واحدة، هي شخصية الجلاد، الاحتلال الإسرائيلي.
وأخيرا، تكتب نائلة بلغة مباشرة تليق بالتوثيق والمرافعة، ورغم اهتمامها بالتوثيق على حساب الشكل الفني، لم تخلُ لغتها من كثافة وترميز أحيانا. رجال القانون يحتاجون إلى اللغة المباشرة غالبا، وأحيانا إلى الكثافة والترميز، أما الكتّاب فيحتاجون إلى الكثافة والترميز غالبا، وأحيانا إلى اللغة المباشرة. حاولت نائلة هنا وهناك الجمع بين اللغتين، وهكذا فقد جاءت لغتها مطابقة للمهام المتعدّدة التي تقوم بها: السرد والتوثيق والمرافعة.