|
حين يضيق الواقع يمسي الحلم أداةً لترميم الذّات المشرّدة، ويصبح حقيقة، ولو على سبيل التّمنّي. هكذا يكون الخيال الأدبيّ شكلًا من أشكال الحريّة؛ يحرّر النّفس في فسحة الفعل القادر على الخلق والتّغيير. لهذا يكتب د. هيبي، يكتب تفريغًا للحزن المكبوت، وتطهيرًا لألم الفقد، ليحقّق توازنه المفقود من فقده لوطنٍ يعشقُه، ما زال فقدُه يقتلُه. إنّ فعل الكتابة هنا هو انعتاقٌ وأمل.
يكتب هيبي ليلومَ من كاد ينسى، وليذكّرَ بجرحٍ ما زال ينزف، هو جرح المنارة والمشرّدين. يكتب لينفّضَ عن ذاكرة بني الأعفم غبارَ السنوات الطّويلة، لذاكرةٍ قد ضاعت في متاهات النسيان وغدر الزّمان، واعيًا لدور الأدب في حفظ التّاريخ والذّاكرة، مؤكّدًا أنّ المنارة، وهي حكاية من اقتلع من وطنه من بني الأعفم، من أبناء المنارة، هي الوطن الذي كان، والذي سيبقى، والذي سيعود. وهذا هو حلم محمّد الأعفم، بطل الرواية.
الأعفم، كما يوضّح لنا الكاتب بآليّة الميتاقصّ في الإهداء: “هو رمز للإنسان العربيّ الفلسطينيّ المشرّد في الوطن والمنافي، تسكنه المنارة، ويحملها جيلا بعد جيل”. ومحمّد الأعفم جاء إلى الدّنيا بعد النّكبة، يبلغ السّتّين من عمره، يعيش وجع الانتظار، يحمل المنارة في قلبه وفكره، يبحث عن طريقها، رافضًا الزّواج بعيدًا عنها.
هو ثمرة الخراب والضّياع، هو الضّياع، ولكنّه الأمل الذي لا يضيع. “هو حكاية عمر استباحه الغدر، غدر الأعداء، وغدر الإخوة الأعداء. غدر الإخوة الأعداء قبل الأعداء”(ص 8). هكذا صارت المنارة كومةً من حجارة، أمست حلمًا بعد أن كانت حقيقةً. لم يولد فيها محمّد الأعفم ولكنّها ولدت فيه، يراها عروسًا حسناءَ ترتدي ثوبها الأبيض، تنتظر فارسها الّذي تأخّر.
أمّا هو فيأتيها فارسًا هزمه القهر والحنين، وقتلته الثرثرةُ الصّامتة عبر السنين.
هي ما زالت تنتظر، أمّا هو فقد سئم الصّمتَ والانتظار.
تكثر ملامح التّصوّف في هذه الرواية، فإذا كان الصّوفيُّ يعاني غياب الحبيب إلى أن يلتحم به ويتحقّق “الاتّحاد”؛ فالأعفم صوفيٌّ يعاني في غياب حبيبته المنارة. وإذا كان واجب العاشق الصّوفيّ أن يجعل من المعشوق غايةً في ذاته فالأعفم يجعل من المنارةِ الحقيقةَ الأسمى والغاية العليا إلى أن تمسيَ يقينًا وينتهي إلى أحضانها.
وإذا كانت الصّوفيّة هي غريزة السّؤال الّذي يلوب على المجهول والمفقود فإنّ الأعفم يلوب متسائلًا عن المنارة المفقودة. والسّؤال هنا سعيٌ وراء الكمال، والسّعي بداية الفعل، والفعل قد يبدأ بالحلم. أمّا المتسائل فهو مسلوبٌ ومقهور؛ وقد أدخله السّلب في قوقعة التنقيب عن اليقينِ، حيث الفضاء الموجع المشرذم بالغياب. وإلى أن يمسيَ الغيابُ حضورًا يلوب عليه الوجدانُ لَوَبانَ الأمِّ على ولدِها الرضيعِ. هكذا يكون الصّوفيّ، وهكذا كان الأعفم.
إنّ الأعفم مشغولٌ بالطّريق إليها أكثر من انشغاله بالغايةِ نفسها، فكم من مرّة يكرّر كلمة “الطريق” في الرواية! ويذكّرني هذا الانشغالُ بالطّريقِ والشّوقِ إلى الخلاص ببحث صابر عن والده في رواية “الطّريق” لنجيب محفوظ، وإن اختلفت طريق صابر عن طريق الأعفم. كما أوافق أستاذي بروفيسور إبراهيم طه في قوله بأنّها تذكّرنا كثيرًا بقصّة زعبلاوي لمحفوظ أيضًا. فإذا كان صابر يبحث عن والده ليمنحه حياة كريمة، وإذا كان الرّاوي في قصّة زعبلاوي يبحث عن زعبلاوي ليقدّم له الشّفاء والسّعادة، فالأعفم كذلك يبحث عن السّعادة في عودة المنارة. وإذا كان الأعفم يشعر بالضّياع لأنّه لم يصل إلى اليقين بعد، أيّ المنارة، فإنّه سيشعر باليقين عندما يلتقي بسلوى، امرأة المنارة. حينها يرى الأعفم ان سعادتهما تتحقّق في الحلم. كذلك يجد الرّاوي السّعادة في قصّة “زعبلاوي” عندما يلتقي بزعبلاوي في الحلم.
وحين يصل الصّوفيّ إلى حالة الوجد يستطيع أن يجد التّوافق الضّائع بينه وبين نفسه، مثلما يصل الأعفم مع سلوى الى حالة الوجد وينتشي بالحبّ، ويتذوّق سعادة الوجود، فيدرك أنّه في طريق المنارة. والمحبّ الصّوفيّ يمحو من قلبه كلّ شيء إلّا المحبوب. كذلك ينفّض الأعفم قلبه من كلّ شيء إلّا المنارة، مسخّرًا كلّ علاقاته وذكرياته وهواجسه للمنارة.
/// صورة المرأة في الرّواية
يسعى د. هيبي للتّأكيد على مركزيّة حضور المرأة في الرّواية. فإذا كانت الأنوثة قد اقترنت على صعيد الوعي الجمعيّ بالضّعف والخنوع فإنّها بعيدةٌ هنا عن أن تكونَ خاضعة عاجزة. لقد وصلت المرأة الفلسطينيّة هنا قمّة التّفاعل مع الهمّ الجماعيّ والوطنيّ، بَدءًا بوالدة الأعفم وصولًا إلى سلوى الأعفم.
يتجلّى نضال الأمّ في عدم رضوخها لقرار أهلها في ترك زوجها، وفي رفضها التّخلي عن المنارة. ربطت مصيرها بمصير الوطن. اختارت البقاء مع زوجها وهي تدرك حياة التّشرّد الّتي ستدفعها مقابل قرارها هذا. لعبت دورًا مهمًّا في ترسيخ المنارة في ذاكرة أبنائها. فيقول الأعفم مخاطبا نفسه: “ألم تكن المرأة هي السّبب؟ ألم تكن أمّك هي المرأة التي غرست المنارة في كيانك وقبل أبيك! أججت حبّ المنارة في قلبك؟” (ص 93). ويتماهى حبّ الأمّ مع حبّ المنارة لأنّها رابطه الأوّل بالحياة وبالمنارة كذلك (ص 168). إذًا هي المرأة، منبع الحياة ورحمها.
ثمّ تظهر حمدة، حمدة هي تلك الشابّة الفاتنة الّتي حملته إلى المنارة فزارها معها لأوّل مرّة في حياته. كانت حمدة في العشرين من عمرها، وكان هو صبيًّا. لم يكن يعرف المنارة، كانت ما زالت في مخيّلته مجرّد خيالٍ، لكنّها غدَتْ معها حقيقة. منذ ذلك اليوم الّذي حضنته حمدة باتت المنارة لا تفارقه. وليس جسد حمدة إلّا رمزًا للمنارة. ففي هذه التّجربة تتجسّد في نفسه تلك العلاقة الّتي ستربط عمره بالمرأة والمنارة معًا.
ثمّ تظهر سلوى الأعفم، سلوى هي امتدادٌ للأمّ وحمدة، ساحرةُ الجمال، تشبهه بالأفكار وبعشقها للمنارة. هي نموذجٌ للمرأة المثقّفةِ، الجريئة، القادرة على الفعل وصنع القرار. فلا يقدّم هيبي صورةً نمطيّة للمرأة المقموعة، بل يقدّمها شخصيّة أملت مكانتها واحترامها على الرّجل، ولا تقلّ عنه صبرًا وتضحية ووعيًا وإبداعًا، مؤكّدًا أنّ عدم نسيان المنارة لا يقتصر على النّضال الذّكوريّ، بل إنّ للمرأة دورًا في تثبيتها في الذّاكرة. وكأنّه يقول: ليست ذاكرتي مثقلةً بثقافة قمعيّة ضدّ المرأة، فها هي في روايتي تتربّع على عرش الثّقافة والجرأة، وفقط في حضنها يكون الخلاص، ومعها يتحقق الحلم. الأعفم بحاجة إلى جرأتها. وفي سبيل تحقيق حلم المنارة لا بدّ لنصف المجتمع، أي المرأة أن يكون حرًّا وقويًّا ومشاركًا. كما أنّ امتلاك المرأة لمستوى ثقافيّ جامعيّ عالٍ يؤهّلها كي تنخرط في قضايا مجتمعها، ويمكّنها من الدّفاع عن طموحاتها ومشاعرها.
إنّ شهرزاد هنا لا تخاف ولا تخشى السّيف، بل تنافس الرّجل وتقتحم مملكته في حقّ الكلمة والتّعبير، وهيبي لا يريدها في صراع مع شهريار أو أن تسرق قلمه، بل هي، كالأعفم، مبدعة وكاتبة ومعلمة للموضوع ذاته الذي يعلمه. هكذا يسعى ليؤكّد أنّ شهرزاد الفلسطينيّة تشارك شهريار في حمل السّيف في وجه الهزيمة والنسيان. هي نجمة النمر الأبيض، سحرها لا يقاوم، والنمر لا يروّض كما يقول البروفيسور طه نقلًا عن الكاتب زكريّا تامر، ولذا هي لا تروّض، ولا تقمع، ولا تنسى.
يكثر الأعفم من تساؤلاته حول سلوى وعلاقتها بالمنارة، كتساؤله عن دور المرأة في وطن مفقود: “هل يستطيع الحبّ أن يجعل الوطن امرأة؟”، “هل يصبح الوطن امرأة؟”، و”هل يكون الحبّ مشروعًا بعيدًا عن هذا الوطن/ المنارة؟ لكنّها أسئلة تؤكّد أكثر ممّا تسأل، تعلن لا تصرّح، ولا تمنح القارئَ فرصةَ المشاركةِ في عمليّة التواصل الأدبيّ، بل سرعان ما يقدّم الكاتب الإجابات جاهزة، مؤكّدًا أنّ سلوى هي الملاذ، وأنّ حبّ المنارة وحبّ المرأة شيء واحد. ألم تعلّم والدة الأعفم ابنها، أنّ “المرأة تكون كلّ شيء حين يفقد الانسان كلّ شيء” (ص 187-188).
والأعفم الذي تجاوز السّتين يعتبر نفسه مشروع عجز وضعف، لكنّه لم يفقد الأمل في لقاء سلوى، فهو الأمل الذي لا يضيع ولا يروّض. والسّتون هنا ما هي إلّا إشارة إلى عمر نكبة المنارة. إذًا المنارة، وإن طال انتظارُها، لم تفقد الأمل. وسلوى الّتي تجاوزت الثلاثين هي مشروع حماس وقوّة شباب، معها سيكفّ عن الصّمت، ويخطو خطوته الأولى في الطريق. هناك سيُختصر الزمن في عمر واحد، ويقترب الحلم من الحقيقة. “فما جدوى المرأة إن لم تكن حلما أو مشعلا ينير طريق الرجل إلى فردوسه المشتهى؟”(ص 74). هكذا يؤكّد الأعفم.
سلوى هي المرأة التي ستلهيه وتنسيه وجع المنارة، ستحييه من جديد. إذًا، سلوى المرأة تعادل الحياة، والمنارة. ولذا يختار الكاتب لقاءهما في آذار، “لأنّه شهر المرأة والأمّ والأرض” (ص33). كما يقول الراوي. من هنا، المرأة رمز الوطن والخصوبة والحياة.
وسلوى كانت بحاجة كالأعفم إلى من ينير طريقها، “أنا بحاجة إلى رجل يحبّني” (ص 120). تقول له. سلوى ما زالت تنتظر حبيبًا تتوق إلى الأمان على صدره. هي كالمنارة تنتظر فارسًا يجعلها حقيقة، الوطن الّذي ينتظر من يحييه. هكذا يمسي المكان امرأة، وتغدو المرأة مكانًا.
ويتحقّق الحلم في الفصل الأخير، لقد رأيا الحلم ذاته في اللحظة ذاتها في غفوة واحدة (ص 360-364). وفي الحلم يكون الاتّحاد، يحملها إلى المنارة ويتعانق الجسدان إلى أن يزهر الربيع في المنارة”(ص 364). ولا تنتهي الرواية قبل أن يطلب الأعفم من سلوى أن تتزوّجه. وفي هذا إشارة إلى أنّه إذا تحقّق الاتّحاد مع سلوى فلا بدّ أن تتحقّق عودة المنارة. هكذا تنتهي الرواية من الاقتراب من حدود الفعل والأمل. وليس عبثًا أن يجعل الكاتب ترتيب الفصول على هذا النّحو. فإذا كان الأعفم قد عانى بصمت طوال الفصول الأولى. فها هي اللحظة قد حانت ليتفجّر الكلام بعد دهر من الصّمت، ويصبح ما قبل الكلام كلامًا في فصل “فيض الكلام”، وهو الفصل قبل الأخير، منطلقًا نحو الفعل في الفصل الأخير “الحلم”. وهذا تأكيد على تمرّده على صمت بني الأعفم طوال الستين عامًا. فالطريق إلى الغاية تبدأ بالحركة، والحركة هي فعل، والفعل مسبوق بالفكرة، والفكرة ما هي إلا كلمة صامتة يسمعها صاحبها، يحكيها لنفسه. وفي البدء كانت الكلمة. والفكرة من سلطة الوعي، وحلم هيبي عن وعي، والحلم بداية الفعل والأمل.
هكذا زرع الكاتب التفاؤل في روايته، فالأعفم عنده لا يموت، والمنارة هي الأمل الّذي لا يضيع. حتّى في علاقة الأعفم مع المحاضرة اليهوديّة جعل الأعفم يحقّق هدفه بالحبّ، منتصرًا عليها. فهذه المرأة الّتي لا تنفصل عن رمزيّتها للمكان، تشتهي أن يأخذها الأعفم ليعيد إليها إنسانيّتها الّتي سرقت منها، ويروي ظمأ روحها وجسدها. إنّ الحبّ حالة تتجاوز الحواجز المكانيّة. الحبّ هو القادر على رفع الإنسان إلى مرتبة تتحقّق فيها إنسانيّة الإنسان بغضّ النظر عن هويّته أو جنسه أو قوميّته. وعندما تعترف له المحاضرة أخيرًا بشرعيّة المنارة وحقيقة وجودها يتفاءل الأعفم شاعرًا أنّ دفء كلامها يدفعه بقوّة نحو المنارة (ص263- 273).
وفي ملاحظة أخيرة أقول: يستمرئ غروري، وأنا الأنثى، أن تكون المرأة هي المعادل هنا للغاية الأسمى، وأن تكون الخلاص للرجل، لكنّي أتساءل: هل يفكّر العاشق في لحظات عشقه للمرأة بالوطن؟! هل يفكّر العاشق لحظة يسكنه الشوق والحبّ بغير المحبوب؟! كنت أفضّل أن يكون الحبّ لسلوى غير مقرون بشرط المنارة إلى هذا الحدّ من التورّط. كنت أبحث عن علاقة حبّ مشحونة بالقول العاطفيّ لا بالقول السياسيّ، أو إلى هذه الدّرجة الّتي تغيب فيها الأحاسيس العاطفيّة والإنسانيّة تحت سلطة الالتزام المباشر. كنت أريده عشقًا لذاتها، لأنوثتها، وبطبيعيّة خالصة، دون أن تُمسّ فكرة الرواية، ودون أن تجرّد سلوى من رمزيّتها للوطن. وكان بإمكان زميلي د. هيبي أن يفعل لو جعل الرواية أقلّ مباشرة وأكثر غموضًا وحداثة، لكنّه انشغل جدًّا في أدلجة الرواية، وفي تأكيد التزامه، وفي تثبيت حضور المنارة، حتى سخّر كلّ شيء لها، فطغت على النّصّ، وبتكرار إلى حدّ الإفراط. ولعلّ البرفيسور طه قد أشار إلى هذه النقطة في مقالته، لذا لن أطيل الحديث فيها. أمّا زميلي د. هيبي فحين أخبرته بملاحظتي هذه برّر ذلك بأنّه يخشى على المنارة من الضياع، إن تغافل عنها قليلًا، واعدًا بأن تكون روايته التّالية حداثيّة رمزيّة، تعتمد التلميح لا التصريح، وبعيدًا عن الالتزام السّياسيّ المباشر القاتل للإبداع والخيال الأدبيّ.
(مداخلة ألقيت في أمسية إشهار الرواية في نادي حيفا الثقافي، 6/10/2016).
الأربعاء 2/11/2016

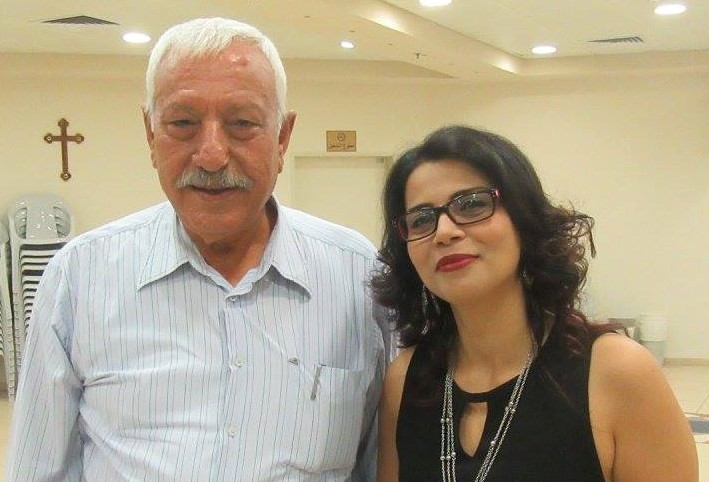
.jpg)