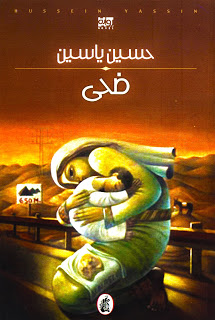ليس عبثا يلجأ الإنسان إلى الكتابة عامة، وإلى السرد خاصة. الكتابة فعل حرية وحافظ للذاكرة، والسرد يبني الرواية، وهي تعادل الحياة، ربما تلك الحياة التي افتقدها الإنسان في السجن أو في المنفى، في الوطن أو خارجه، في حياته الخاصة أو العامة، أو تهدّمت لسبب ما، فصارت همّا شخصيا أو جمعيا راح يضغط عليه جسدا وروحا، فدفعه إلى محاولة التغيير أو البناء من جديد. لذلك، يستعين الكاتب بالكتابة ليستفزّ ذاكرته أو يحفظها من الضياع، أو ليُفعّل وعيه ويستفزّ لاوعيه، يُكمّل أحدهما الآخر في عملية بناء جديدة لحياته، أو ترميم ما تهدّم منها، أو يستعين بالكتابة للخلاص من ألم وهمّ زرعهما السجن، أو ليتعايش مع جرح نكأه المنفى، أو ليستعيد حريته التي قيّدها هذا أو ذاك. ويلجأ الكاتب إلى الكتابة لمقاومة الغربة والاغتراب أو الضياع والخراب، أو كلها مجتمعة، في واقع لم يبقَ له فيه من ملاذ إلّا الكتابة. بها فقط يستعيد ذاكرته وحريته، وربما أكثر من ذلك، إنسانيته. ولذلك، الرواية عند حسين ياسين هي عملية إفراغ، حيث لم يستطع حمل ما يجيش به صدره وما سبّب انفصاله عن ذاته، فأفرغه على الورق، إذ لم يجد وسيلة أخرى يكسر بها قيوده ويستعيد بها حريته وإنسانيته. من هنا تحوّلت الكتابة عنده إلى عملية رفض للحاضر الموبوء والمزيّف، وعملية بناء للمستقبل الموعود.
في رواية تعيدنا إلى أجواء السرديات العربية القديمة، من ملاحم الراوي الشعبي إلى “ألف ليلة وليلة” و”كليلة ودمنة” وغيرها، وتمتح من فرائد اللغة والتراث والأدب، وتمزج أجزاء من التاريخ العربي الفلسطيني بأجزاء من تاريخ الأمم المناضلة التي قاومت القمع فنجحت أو فشلت. وتجمع بين التاريخي والاجتماعي والفلسفي، الذاتي والجمعي، وبين جمال الوصف والسرد رغم ضعف البناء أحيانا، في مثل هذه الرواية وتلك الأجواء يجد حسين ياسين نفسه كاتبا عاش المنفى والاغتراب، في الوطن وخارجه، يقف أمام واقع فلسطيني ينهشه الضياع والخراب، فقاومها جميعا بالكتابة، وحملنا معه كاتبا وراويا وبطلا، في رحلة قوامها الاغتراب والضياع والخراب الفلسطيني الذي لم يبقَ منه إلّا موضع قلم وشريط شفاف من الأمل يُدعى “ضحى” حسين ياسين، دافعه حبُّ الحياة بما فيه من ضعف يبلغ حدّ الهوان أحيانا، وقوة تقاوم الموت في الحياة بجرأة تصل حدّ الوقاحة (بمفهوم إيجابي) أحيانا أخرى، وعماده الكتابة التي لم يبقَ لحسين ياسين غيرها ليثبت وجوده ويمنع انتهاء الرحلة إلى المطلق من الضياع والخراب. وتأتي روايته قبل كل شيء للتكفير عن هروبه بادئ الأمر من مواجهة واقعه، ذلك الهروب الذي يعترف به وإن لم يقل ذلك صراحة. ولكن، لأجل الاعتراف به والتراجع عنه كرس أحداث ليلته الأولى؛ الأمر الذي يدفعني للحديث عن مبنى الرواية أولا.
الشكل الفنّي
عن قصد، أبدأ الحديث عن الشكل الفني محاولا الكشف عن مواطن قوته وضعفه، وعن مساهمته في توصيل المضمون بما فيه من رسائل للقارئ عامة والفلسطيني خاصة. وذلك، لإنّ الشكل الفنيّ الذي اختاره حسين ياسين، رغم إشكاليته، له أهميّته ودلالاته في التعبير عن وعيه بتمزّق الواقع وبحجم الضياع والخراب الذي آل إليه الكاتب وواقعه الفلسطيني في آن معا. وقد جاءت رواية “ضحى” لتعكس تمزّق عالم كاتبها الخاص، وتمزّق الواقع الفلسطيني عامة.
الرواية، هي تجربة واعية تُحرجها أحيانا طيّات اللاوعي وانقباض تلافيفه، ولكنها عندما تكون عملية حفر جريء في طبقاته، تفضّ ذلك الانقباض وتجعل من السرد عملية بوح تفرز مكنونات لو ظلّت في دواخل الكاتب لقتلته. ولأنها كذلك، ولأنّ حسين ياسين غير ملمّ بهندسة الرواية وضرورة تصميم معمارها، فقد نفث مكنونات صدره بشكل فنيّ واعٍ أحيانا وعفويّ غالبا، تنقصه معرفة الروائي العالم بأسرار الرواية. والحقيقة، إنّ التجريب وكون الرواية فنّا قابلا للاختراق مفتوحا على أشكال لا حصر لها، أنقذا حسين ياسين رغم أنّ حركة التجريب عنده لا تبدو حركة واعية كما ينبغي لروائي عالم بأسرار البناء الروائي، فهي لا تظهر معرفته بتلك الأسرار التي سبقه إليها أعلام الرواية عربيا وعالميا، والذين صاروا يهتمّون بالشكل أكثر من المضمون. ومع ذلك، فقد كان لبناء الرواية وتقسيمها نفعه في تجسيد الضياع والخراب الذي أراد الكاتب أن يُشركنا فيه وأن يُحذّرنا من عواقبه، سواء كانت حركة التجريب لديه واعية أو غير واعية. ومع ذلك، كان ينبغي لحسين ياسين أن يهتمّ أكثر ببناء روايته وشكلها الفنّي، لأنّ الهمّ الفلسطيني الذي تعالجه، سواء كان فرديا أو جمعيا، هو همّ واحد تختلف فيه زوايا الرؤية فقط. وهذا بدوره، أمر يستدعي البحث عن أشكال جديدة ومقنعة لتقديم ذلك الهمّ أو تلك القضية. ولكن، إذا أخذنا بالحسبان أنها التجربة الروائية الأولى للكاتب، فسوف نغفر له هنّات البناء، خاصة عندما نقف على مدى وعيه بتمزّق الواقع الذي عاشه وما زال يعيشه، وكيف كان له دوره الواضح في تمزّق وعيه الخاص، وفي خلخلة مبنى روايته، وكيف ساهم كل ذلك في توصيل رسائله.
تقسيم الرواية وطريقة السرد
“ضحى”، رواية في ثلاثة فصول هي عبارة عن ثلاث ليالٍ منفصلة تبدو وكأن لا صلة بينها إلّا “عبد الباقي”، البطل اللابطل، والراوي الذي يسرد حكايات الليالي الثلاث التي تبدو كثلاثة مقاطع منفصلة من سيرته الذاتية. ولذلك فإنّ الصلة بين الفصول تبدو واهية من حيث ترابطها، إلّا أنها ليست كذلك من حيث المضمون، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما أراد الكاتب توصيله من خلخلة الواقع عبر خلخلة البناء الروائي. وقد استعان لذلك بالجنوح إلى الشكل السيري الذي تُنتقى فيه الأحداث سواء ترابطت أو لا، إلّا أنّه رغم هذا الجنوح، تتخذ روايته شكل الرواية البوليفونية (Polyphony) لأنها تعتمد تعدّد الأصوات، حيث تتقاسم السرد “مع عبد الباقي” في كل ليلة، أصوات لشخصيات أخرى اختارها الكاتب إيمانا منه بالحرية والتعدّدية من جهة، ومن جهة أخرى تساعده على استكمال أفكاره ورسائله التي لا تتسع لها شخصية البطل، “عبد الباقي”. ومن جهة ثالثة، ليُجسّد التركيب والتعقيد والتشظّي الذي يلازم الراوي ويُلازم الواقع الفلسطيني الكائن والذي كان، حيث يُلاحظ داخل الحكايات التي يرويها “عبد الباقي”، وكأنّ الذات الفلسطينية ليست هي المهيمنة على الرواية أو السرد، وهذا بدوره يُساهم في تجسيد تلك الحالة من الضياع والاغتراب، التي يعيشها الفلسطيني أرضا وشعبا.
ترتيب الليالي وتوزيع الأحداث عليها، وكذلك تعدّد الأصوات، أمر له دلالته التي سأبيّنها في حديثي عن الشخصيات. ولكن، يُلاحظ في الليالي الثلاث أنّ الكاتب مهّد لحكاية كل ليلة بنصّ هو ملمح ميتاقصيّ يُشكّل من حيث المضمون، مفتاحا يُعين القارئ على فهم نص تلك الليلة، بينما من حيث المبنى، يترك القارئ في حيرة يتساءل: لماذا بدأ تمهيد الليلة الأولى بعبارة “قال الراوي”؟ ويتضح لنا بعد ذلك أنّ الراوي هو “عبد الباقي”، بينما في الليلة الثانية، بدأ التمهيد بعبارة: “قال عبد الباقي”، أما في الليلة الثالثة فقد بدأه بعبارة “يُحكى أنّ”. هل مردّ ذلك هو ضعف حسين ياسين في ضبط مبنى الحبكة؟ هذا جائز بما أنها تجربته الروائية الأولى! أم مردّه تمزّق الواقع الذي أدّى إلى خلخلة المبنى الروائي؟ وهذا جائز أيضا، لأنّ الهمّ الذي يحمله حسين ياسين، لا شكّ أنه يضغط على وعيه ولاوعيه بقوة تكفي لتمزيقهما، وهو أمر انعكس على مبنى روايته.
في الليالي الثلاث يتقاسم السرد مع “عبد الباقي” راوٍ يبدو كأنه عالم بكل شيء، ولكنه قليل الكلام والتدخّل، يُعرّفنا ببعض جوانب شخصية “عبد الباقي” التي لا يفصح عنها في سرده. ويبدو لي أنّ الكاتب وظّف هذا الراوي ليختبئ وراءه ويوهمنا بأنّ “عبد الباقي” الراوي والمروي عنه، ليس هو الكاتب حسين ياسين نفسه. ورغم وجود ذلك الراوي، يظلّ حضور “عبد الباقي” كراوٍ، مسيطرا في الليالي الثلاث، سواء عندما يُلقي بمهمة السرد على عاتق شخصية أخرى، أو إن كان حضوره يتجسّد في غيابه، أو في الهزّات العنيفة التي تصيبه وتسبّب له ذلك الغياب، خاصة في الليلتين: الثانية والثالثة.
في الليلة الأولى يقدّم “عبد الباقي” منصة السرد، وعن طيب خاطر، لشخصيات أجنبية يستمتع بحوارها وسماع حكاياتها. وهو يُعبّر بذلك عن تقبّله وتقبّل الإنسان الفلسطيني عامة للآخر، الآخر الذي هو أيضا يحترم الآخر ولا يسلبه حقّه أيّا كان. ولكن، لتقاسم السرد هنا، وهيمنة شخصيات أخرى عليه، دلالات أخرى أهمّها هروب الفلسطيني من واقعه ومن الجغرافيا التي أخذت تُحاصره. سأبيّن ذلك أكثر في حديثي عن المكان.
ما يحدث في الليلة الثالثة، التي أنتقل إليها عن قصد، لا يختلف كثيرا عمّا حدث في الليلة الأولى. فالراوي عندما أتاح فرصة السرد لـ “ألفيي” الألماني وأمه، يتابع هروبه من واقعه الخرِب رغم عودته إلى الوطن، التي كانت تشبه عودة من عاد ليتفقّد جثة لعله يجد فيها بقايا نفس أو روح يستبقيهما، وهو ما تقوم به “ضحى”، الرواية. ولكن من جهة أخرى، يظلّ الآخر، الألماني هنا، مقبولا عليه، حيث يتقاسم “عبد الباقي” السرد مع “ألفيي” الألماني الأصل الذي ظلّ وفيّا للقدس بعد اقتلاع جذوره منها. والذي يمتح قصة حبّه للقدس من ذاكرته، حيث تقبع هناك الحكاية التي روتها له أمه التي جاء لزيارة ضريحها وضريح والده في القدس. إنها حكاية الجالية الألمانية التي عاشت في فلسطين، تختزلها “ماري تريز”، أم “ألفيي”، في سرد حكايتها الشخصية والظروف التي دفعتها إلى فلسطين والاستيطان فيها. صحيح أنّ أهداف القادمين الألمان إلى فلسطين لا تخلو من تفكير كولونيالي لم تنكره “ماري تريز”، إلّا أنّ الدافع الأساس هو دافع ديني. يؤكّد ذلك أنّ الألمان لم يغتصبوا فلسطين ولا أنكروا على عربها أنهم سكانها الأصليون وأصحابها الشرعيون. لقد كان لقاء الألمان مع الفلسطينيين لقاء وديا، يقوم على الاحترام المتبادل، وفيه تعاطف ومساعدة. فقد تقبّلت “ماري تريز” العيش معهم، وكانت تسعد بصحبتهم وتتعاطف مع أوضاعهم الصعبة بشكل عام، وتساعدهم على مواجهتها والتغلّب عليها، في حين كان اليهود يتعاملون بحذر وريبة مع الألمان ويناصبون الفلسطينيين العداء. تُؤكّد ذلك أحداث الليلة الثانية.
الأمر مختلف تماما في الليلة الثانية، حيث تتولى السرد فيها إلى جانب “عبد الباقي”، شخصيتان هما اليهوديّان: “قاطن الدار” و”شمعون حسون”. والمفارقة هنا، أنّ هذا الأخير لا يعتبره “عبد الباقي” أجنبيا أو غريبا بل جارا ورفيق صبا، دليلا على أنه لا يُنكر الوجود اليهودي في فلسطين. هاتان الشخصيّتان لا يصحّ أن نقول إنهما تتقاسمان السرد مع “عبد الباقي”، بل نجد أنّ أولاهما، والتي عن قصد لم يُعطها الكاتب اسما بل نعتها بـ “قاطن الدار”، لأنها تُمثل جمعا وليس فردا، نجدها تستغلّ السرد لفلسفة الاغتصاب واعتباره تحوّلا طبيعيا. أما الشخصية الثانية، “شمعون حسون”، بعنجهية واستعلاء، تغتصب منصة السرد من “عبد الباقي”، كما اغتصبت منه كل شيء: بيته وقدسه وفلسطينه وتراثه المتجذّر والمتراكم فيها جميعا، ودمّرت حياته وحوّلت سعادته وأحلامه إلى كابوس.
هاتان الشخصيتان، “قاطن الدار” و”شمعون حسون”، باغتصابهما للسرد، تمثلان الاغتصاب الصهيوني لفلسطين. “قاطن الدار” يفلسف الاغتصاب بأنه تغيير طبيعي، عندما يقول: “لا شيء يدوم … كل الأمور تتبدل” (155).[2]و”حسون” يُمثل الاغتصاب بكل بشاعته. وهذا بالضبط ما فعلته الصهيونية في فلسطين: اغتصبت وشرعنت الاغتصاب وشرّدت صاحب الدار أو حوّلته إلى غريب فيها.
من هنا، نجد حضور “عبد الباقي” يظلّ مهيمنا وصوته مسموعا في الليلتين الأولى والثالثة، رغم كثافة حضور الأصوات الأخرى، بينما يتزعزع حضوره وصوته في الليلة الثانية، إذ تصطدم الروايتان: الأضعف والأقوى، رواية “عبد الباقي” ورواية “حسون”، لتجسّدا ما جرّته النكبة وما بعدها من خيبات وخراب، عليه وعلى قدسه وشعبه.
في الليالي الثلاث يكتب حسين ياسين لقارئ ضمني يستتر خلف من يروي لهم “عبد الباقي”. وهم يُمثلون صاحب القضية كلها، الشعب الفلسطيني. والقارئ الفعلي، الفلسطيني بشكل خاص، مهما تسطّحت ثقافته ومهما ضعف انتماؤه لن يجد صعوبة في اكتشاف أنّ السرد موجّه له بالأساس، أيّ للفلسطينيين أنفسهم، خاصة لأولئك الذين بدأ اليأس يتسلل إلى نفوسهم التي أخذت تستسلم، وأخشى ما يخشاه حسين ياسين، أن نفوسهم أخذت تطمئن لواقع الضياع والخراب. ولذلك فهو من خلال روايته، والراوي “عبد الباقي” من خلال لياليه، يصرخ بهم، يستفزّهم ويحرّضهم أن يعملوا بما أشارت به العرافة حين قالت له: “أطلب حقّك بإلحاح … ولا تساوم … المشكلة فيمن اغتصب الحقّ، كيف يؤدّيه، وليست فيمن يطلبه … لا تحمل مشكلة غيرك. يكفيك من الهمّ مشكلتك” (11).
الزمكانية
الزمن الموضوعي في الرواية لا يتعدّى زمن القصّ في الليالي الثلاث التي يروي فيها “عبد الباقي” حكاياته. ولكنّ الزمن الداخلي يتشعّب ويتشظى عبر الذاكرة لأزمنة مختلفة في الوطن وخارجه، في كل ليلة بمعزل عنه في الليلتين الأخريين. العلاقة بين الأزمنة الداخلية في الليلتين: الأولى والثالثة مترابطة تساهم في ترابط الحبكة في كل منهما، بينما تتخلخل العلاقة بين الأزمنة الداخلية التي تتشظّى في الليلة الثانية تعبيرا عن تشظّي الشخصيات والواقع الفلسطيني بفعل النكبة وما تلاها. أما المكان في الرواية، فهو في الليلة الأولى، المنفى الاختياري في الاتحاد السوفييتي الذي هرب إليه الراوي لأنه لم يعد يطيق ضيق المكان في القدس المغتصبة. أما في الليلتين: الثانية والثالثة، فهو القدس نفسها التي تحيل إلى فلسطين كلها، والتي عاد إليها الراوي من منفاه الخارجي ليجد نفسه في منفى داخلي قسريّ أشدّ قسوة من الأول، يعكس منفاه النفسي وانفصاله الداخلي عن ذاته.
في الليلة الأولى الزمن هو زمن الغربة والاغتراب في منفى اختاره الراوي هربا من زمن معادٍ ومن جغرافيا ضاقت عليه في الوطن، فلسطين التي اغتصبت منه. ولذلك بحث “عبد الباقي” في المنفى عن زمن حميمي يعوّضه عن الدفء الذي افتقده، وعن جغرافيا مفتوحة ينفث في مجتمعها المفتوح أيضا، ضيق صدره الذي سبّبه الزمن العدائي وضيق المكان في الوطن الذي لم يعد يتسع لأحزانه وهمومه وضياعه بعد النكبة عام 1948، وكذلك بعد النكسة عام 1967، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أنّ كليهما: الكاتب والراوي الذي يتماهى معه، رحلا للدراسة في الاتحاد السوفييتي بعد هزيمة حزيران عام 1967. ولكنّ المنفى يظلّ مكانا عدائيا مهما كان حميما. يؤكّد ذلك إخفاق الراوي في استبقاء حبيبته التي تركته بشكل حازم ولم تلتفت إلى احتياجاته التي هرب من أجلها.
الراوي في الليلة الأولى طالب يتعلم في إحدى جامعات الاتحاد السوفييتي “قبل أن يتفرفط” (13)، على حدّ تعبير الراوي نفسه. ولعل ذكر “فرفطة” الاتحاد السوفييتي وتشرذمه، يُمهّد لما سيواجهه الراوي من خيبة في المنفى، فشل قصة حبه مع “تانيا”، ولما سيأتي في الليلة الثانية من حديث عن “فرفطة” الشعب الفلسطيني وحالة التشرّد والتشظّي والخراب التي أصابته أفرادا وجماعات. ولذلك، فالزمن في الليلة الثانية هو زمن فلسطيني يتشظّى بواسطة الاسترجاع والمتح من الذاكرة، إلى زمنين فلسطينييْن مختلفين، أحدهما منتهٍ يعيش في ذاكرة الراوي، وهو زمن الرخاء وطيب العيش في القدس قبل النكبة، والآخر قائم ومستمرّ، من جهة هو زمن الاغتصاب والاحتلال، ومن جهة أخرى هو زمن التشرّد والضياع في القدس وفلسطين وخارجهما بعد النكبة. ولذلك، من الطبيعي أن يكون المكان في الليلة الثانية هو القدس التي نُكبت وقُسّمت عام 1948، واحتلّت كلها عام 1967، والتي عاد إليها الراوي كالغريب ليبحث عن الزمان والمكان اللذين أضاعهما لعله يجد في القدس ما يُعوضه، إلّا أنه خرج من رحلته إليها بهمّ يفوق الهمّ الذي خلّفته النكبة والنكسة. فقد صدمته رواية الغاصب التي هيمنت على روايته، وحملته شخصيتا “قاطن الدار” و ” حسون” اللتان تُمثلان الغاصب، إلى أزمنة وأمكنة تُكرّس الضياع والخراب الفلسطينييْن وتعمل على دوامهما.
في الليلة الثالثة تختلف الأحداث والأبطال، ولكن يظلّ “عبد الباقي” هو الراوي، في زمن فلسطيني ومكان فلسطيني هو القدس، وإن تشظّى الزمان وتشعّب المكان، لأزمنة وأمكنة أخرى تحكمها في الرواية علاقتها بالزمن الفلسطيني قبل النكبة والاحتلال وبعدهما. أما هيمنة “ألفيي” وأمّه على السرد في هذه الليلة، فقد كانت تقنية نجح الكاتب في توظيفها كرواية أجنبية تدعم روايته التي اغتصبت في الليلة الثانية، رغم أنّ هذه الرواية اغتصبت كذلك.
يدّعي حسين ياسين أنّ القدس كمكان، ومن خلالها القضية، هي بطل روايته، ولكنّ ذلك ليس صحيحا في الرواية على الأقلّ، وإن كان له ما يُبرّره. صحيح أنّ القدس تلاحق “عبد الباقي”، خاصة في الليلة الأولى، ليعود إليها في الليلتين اللاحقتين، ولكنها تلاحقه كهمّ، أو كقضية هي قضية كل فلسطيني يحملها أينما رحل. والبطل عادة، يحمل في كل رواية همّا أو يعرض قضية ويدافع عنها. ولذلك، القدس هي قضية تحتاج إلى بطولة للدفاع عنها، لتحريرها كوطن مغتصَب، أو لحلّها كقضية تؤرّق البطل. لا شكّ أنّ للقدس تأثيرها القوي على “عبد الباقي”، الفلسطيني الذي قد يكون هو الكاتب، أو أيّ فلسطيني آخر، فهي همّه الذي يقضّ مضجعه. إذن هي قضيته، والقضية لا تستطيع أن تكون بطلا، القضية تحتاج إلى بطل، ولكنّ المشكلة هي أنّ البطل، “عبد الباقي”، عاد إلى القدس مهزوما، في زمن لم يعد للبطولات موضع فيه. وقد تكرّست هزيمته بهزيمة روايته أمام رواية الغاصب، فلم ينتج عن عودته إلّا تكريس للضياع والخراب، ومضاعفة للهمّ الذي يعيشه أصلا. ولذلك، يظلّ “عبد الباقي” هو بطل الرواية بغضّ النظر عن نوع بطولته، وإن كنت أجزم أنه “لا بطل”، ولذلك دلالته، ولكنّ هذا موضوع آخر سأبيّنه لاحقا في حديثي عن الشخصيات.
الشخصيات
من الصعب النظر إلى الرواية كوحدة واحدة إذا استبعدنا شخصية “عبد الباقي”، بطلاً أو راوياً. عندها سوف تنفرط الحبكة وسنقف أمام ثلاثة نصوص روائية مختلفة منفصلة، لكل منها حبكته المستقلة، حتى لو التقت الليلتان: الثانية والثالثة، بشكل أو بآخر في الزمان والمكان. وسوف تفقد شخصيات كل ليلة، الهدف الذي خُلقت من أجله، وهو خدمة البطل وقضيته. أقول هذا الكلام لأنّ بعض القراءات النقدية للنص، وهي قراءات سريعة، وبعضها متسرّع أحيانا، ادعى أصحابها أنّ الرابط بين الليالي الثلاث كان واهيا يقتصر على “عبد الباقي” الذي رأوا فيه مجرّد راوٍ لأحداثها، ولم يُفكّروا بما أراده الكاتب من خلقه لشخصيته بهذا الشكل: أولا، “عبد الباقي” الراوي، خلقه الكاتب لكيلا يكون نصيب قضيته الضياع المطلق، فهو من خلال “عبد الباقي” يريد حفظها في ذاكرة الأجيال، خاصة ذاكرة الأجيال الشابة التي نعتها بـ “السواعير” (61)، لأنّ هؤلاء، عادة لا يفكرون إلّا بأنفسهم، وبالجنس أو متع الدنيا على اختلافها، ولذلك فهو يخاف، منهم وعليهم، أن ينسوا قضيتهم، ما يوحي بأنّ “عبد الباقي” ومن خلفه الكاتب، يُريد أن يترك وراءه من يحمل القضية، ولا يتركها تضيع على الأقلّ من الذاكرة. وهذا يتّفق مع ما يراه الناقد الفلسطيني د. فيصل دراج، أنّ السيرة الذاتية تستحضر خبرة منقضية، يعتقد صاحبها أنها مفيدة لبشر في مستهلّ تجاربهم، وتشكّل بوحاً يطرد الإنسان فيه جزءاً من حياته، لازمه حتى ضاق به. كما يعمد الإنسان إلى السيرة الذاتية في أزمته، عند اشتداد حالة التأزم والحيرة والقلق، مصرحاً باغتراب شديد ومعلناً عن أزمته الوجودية والوجدانية، بعد أن برهنت له الحياة أنه اطمأن إلى طريق لا يفضي إلى شيء.[3] وتلك كانت حالة “عبد الباقي” ومن خلفه الكاتب.
وثانيا، “عبد الباقي”، البطل “اللابطل”، خلقه الكاتب لعدّة أهداف أهمّها: أولا، ليجسّد هروب الفلسطيني من همّه وقضيته بعد أن لم يعد يحتمل ضعفه وعجزه. وقد جعل هروبه إلى المنفى لا يجدي نفعا إلّا التأكيد على ضرورة المواجهة. وثانيا، ليجسّد هزيمته وضياعه، متمثلا بهزيمة روايته الضعيفة، وإن كانت هي الصحيحة، أمام الرواية القوية رغم كونها ملفّقة. وثالثا، ليجسّد الخراب الذي آل إليه عالمه الشخصي، أو الخراب الذي لحق بالقدس، متمثلا بما حدث لـ “ضحى” وغيرها من الشخصيات الفلسطينية في الليلة الثانية.
لذلك، صحيح أنّ شخصية “عبد الباقي” هي رابط وحيد بين الليالي الثلاث، ولكنها رابط قوي، حقّق بها الكاتب أهدافه من رسمها. فقد استطاع من خلالها أن يصوّر ضياع الإنسان الفلسطيني والخراب الذي لحق به فردا وجماعة ووطنا، والخيبات المتوالية التي تلاحقه. في الليلة الأولى هرب “عبد الباقي” من القدس التي ضاقت عليه، هرب إلى المكان الشاسع والمجتمع المفتوح الذي ذاق فيه حلاوة العيش، إلّا أنها لم تسعفه أيضا. من جهة، قصة الحبّ التي عاشها فشلت، وذلك لضعفه في تحمّل مسؤولياته التي تحتاج إلى الحزم الذي ينقصه. وهو نفس السبب الذي جعله يهرب من القدس. ومن جهة أخرى لأنّ القدس ظلّت تلاحقه إلى أن عاد إليها في الليلة الثانية. إذن لم يحقّق هدفه من هروبه. وفي الليلة الثانية هُزمت روايته الصحيحة لضعفها أمام الرواية الملفّقة لأنها تمتلك ما يفتقده هو: القوة. وفي الثالثة استعان برواية أجنبية لتدعم روايته فلم تصمد الروايتان لضعفهما أمام الرواية الملفّقة ولكن القوية، أو لأنّ “إلْمَيّ (الماء) الغريبة ما بتدير طواحين”، أو لأنّ العالم يعيش زمنا انقلبت فيه الموازين، فانهزم فيه الحقّ أمام اباطل.
تظلّ شخصية “عبد الباقي” هي المركزية والأهمّ في الرواية. أما الشخصيات الأخرى، كل في ليلته، فقد رسمها الكاتب لطرح أفكاره التي لا تتسع لها شخصية البطل، وكذلك استكمالا لبناء شخصيته وبيان ظروفه في الليالي الثلاث. تلك الشخصيات تستمدّ أهميتها من علاقتها بـ “عبد الباقي” والدور الذي تلعبه لخدمته سلبا أو إيجابا.
في الليلة الأولى تبرز الشخصيات: الغجرية و”تانيا” وأمّها. وكلها تذكّر “عبد الباقي” أنه هروبه في المنفى يُضاعف أزمته، وأما ما يسعفه فهو المواجهة فقط. وفي الليلة الثانية هناك شخصيات كثيرة لكل دورها ولكن تبرز منها اثنتان: “شمعون حسون” كتجسيد للغاصب المحتلّ أو للجلاد، و”ضحى” الذبيحة من الوريد إلى الوريد، تجسيد للضحية على المستويين: الذاتي والجمعي، إذ تتماهى محنتها مع محنة القدس الذبيحة هي أيضا من الوريد إلى الوريد. أما في الليلة الثالثة فتبرز الشخصيتان، “ألفيي” الألماني وأمّه، من خلال حكايتها المسترجعة. تلعب الشخصيتان دورا مهما في إنارة الطريق لـ “عبد الباقي” والأجيال التي يروي لها. فكما احتضنت شخصيات الليلة الأولى “عبد الباقي” ولكنها أكّدت له المنفى وضرورة المواجهة وكون الحلّ يكمن فيها وليس في الهروب، فإنّ هاتين الشخصيتين تملكان رواية تدعم رواية “عبد الباقي”، إلّا أنّ روايتهما لم تصمد هي الأخرى، وحدث لها ما حدث لروايته. وهنا أؤكّد أنّ ترتيب الليالي وتوزيع الأحداث عليها له دلالته التي تدعم العلاقة بين فصول الرواية. أولا، لولا الهروب في الليلة الأولى لما كانت العودة في الليلة الثانية. وثانيا، وضع الكاتب أحداث اللقاء بين الضحية والجلاد، الغاصب والمغتصب وروايتيهما: القوية والضعيفة، عن قصد في الليلة الثانية التي هي المركز وحلقة الوصل بين الأولى والثالثة، وفي ذلك رسالة إلى القارئ عامة والفلسطيني خاصة، مفادها أنّ الهروب كما في الليلة الأولى لا يجدي، والاعتماد على الغير، كالاعتماد على رواية أجنبية غريبة لا يُجدي أيضا كما في الليلة الثالثة. ما يجدي هو المواجهة فقط، ولو بعد حين، وإلّا فسوف تظلّ رواية الغاصب هي الرواية المهيمنة كما في الليلة الثانية. هذه الرسالة، تقوّي العلاقة بين أحداث الليالي الثلاث، ولولاها لكان تقديم أحداث ليلة على أخرى لا يقدّم او يُؤخّر من حيث الشكل أو المضمون.
اللغة
لا تطمح وقفتي مع لغة الرواية إلى كشف جماليتها، سواء كان ذلك في السرد أو الوصف، فهي مسألة لا ينتطح فيها عنزان. وهي لغة تُمسك بتلابيب القارئ فلا يجد له فكاكا من الغلاف إلى الغلاف. لغة غنية وجميلة تُمتّع القارئ بسلاسة عباراتها وبما تمتحه من فرائد التاريخ والتراث والأدب. كثيرا ما تعلو مستوياتها فتبلغ حدّ الشعر، وتهبط أحيانا فتبلغ القاع و”سواعير”[4]المروي لهم. ولكنّها تطمح إلى كشف أسباب تقعّرها أحيانا، والأهمّ من ذلك، كشف مساهمتها في تجسيد ضياع الكاتب وبطله من جهة، وفي ترابط حبكة الرواية من جهة أخرى.
تتقعّر لغة الرواية في أكثر من موضع، خاصة حين يُوظف الكاتب عبارات فصيحة متحها من الأدب العربي القديم، أو عبارات فصيحة أو عاميّة متحها من التراث العربي القديم أو الحديث، يجريها على ألسنة شخصيات أجنبية. والأمثلة لذلك كثيرة سأستعين ببعضها لاحقا. ولكن المثير هنا هو أنّ الكاتب في روايته، أبدى من المعرفة والثقافة ما يجعلني أستبعد ضعفه في معرفة مطابقة اللغة للحالة التي تعبّر عنها. وهو السبب الذي يدفعني إلى تفكير آخر في توظيف الكاتب لهذا التقعّر. وهو في رأيي السبب نفسه الذي يدفع الراوي إلى متح تلك العبارات من الأدب والتراث خاصة وهو في المنفى، يعيش مع شخصيات أجنبية لا يربطها رابط بتراث الكاتب أو الراوي.
أعتقد أنّ الراوي، الذي يتماهى مع الكاتب، الهارب من ماضٍ وواقع يضغطان عليه نفسيا، ينفصل عنهما جسدا فقط، إلّا أنّه في وعيه ولاوعيه يرفض ذلك الانفصال، فيستعين بتاريخه وحضارته وثقافته ولغته كذلك، ليحافظ على علاقته بتاريخه وحضارته، ومن خلالهما على علاقته بالواقع الذي هرب منه وانفصل عنه. وتقديم تلك العبارات على ألسنة شخصيات أجنبية إنما يساعده على ربط حياته كلها بذلك الواقع، ليعوّضه عن الانفصال عنه. وإلّا، فما هو السبب الذي يجعله يدفع شخصية أجنبية، مثل الغجرية، إلى تعبير مثل “بيّض كفّي، بيّض الله أيامك والليالي”( 10)، أو يجعلها تستعين بـ “طرفة بن العبد” الذي لا تعرفه، لتعبّر عن سلوك زوجها فتقول: “يقصّر يوم الدجن” (12)؟ والكاتب يفعل ذلك عن وعي لأنه يضع العبارة بين مزدوجين. وما الذي يجعل “تانيا” الروسية تُخاطب أمها بلهجة ينعتها الكاتب بأنها “لهجة يطغى عليها الإخفاق”، تزاوج فيها بين العربية الفصحى ولهجتها الأصلية واللهجة الفلسطينية، أو العاميّة المقدسية تحديدا، عندما تقول: “مامْ!! لويش هذا!!! لويش هذا الحكي!!! هو متزوّج … متزوّج، من القضية” (117)؟ ألا يُعبّر كل ذلك عن ضياع الكاتب وبطله، وفي الوقت نفسه عن رفضه الواعي أو اللاواعي للانفصال عن تاريخه وحضارته وواقعه ووطنه وقضيته التي هو متزوّج منها؟
لا شكّ أنّ مثل هذا التوظيف للغة يُسيء للرواية ولغتها وكاتبها، ويُبعدها عن واقعيتها. ولكن، إذا سلمنا بعدم جهل الكاتب بأهمية اللغة بالنسبة للرواية، وبمعرفته الأكيدة بضرورة مطابقة اللغة للحال، سنجد أنفسنا مضطرّين للبحث عن تفسير آخر لهذا التوظيف. وذلك ما جعلني اتّجه نحو التفسير الذي طرحته، وأنا أعلم أنه قابل للنقاش.
مساهمة اللغة في تجسيد ضياع الكاتب والراوي، وانفصالهما عن واقعهما، لا تنحصر فيما ذكرت فقط، وإنما نجد في لغة الرواية الكثير مما يُثبت ذلك. استخدام الكاتب المتكرّر لأسلوب معيّن في بنائه لبعض العبارات، خاصة عندما يكون الحديث لـ “عبد الباقي” أو عنه. وتكرار ذلك الأسلوب الذي يؤكّد أنّ الكاتب يفعل ذلك عن وعي، فيه تعبير واضح عن الانفصال، اللاواعي على أقلّ تقدير، وما تلاه من ضياع عاشه الكاتب وبطله. لو أخذنا نموذجا مثل عبارة “بيّض الله أيامك والليالي”(10) وتساءلنا: لماذا لم يقل “بيّض الله أيامك ولياليك”؟ ألا يوجد في حذف الضمير من “لياليك” قطعٌ لوصلٍ شعرنا به وعشناه في “أيامك” لاتصالها بالضمير؟ ربما تبدو الفكرة مضحكة لو استخدم الكاتب هذا الأسلوب في تلك العبارة فقط، ولكن لا، فأنا أتحدّث عن ظاهرة تنتشر في الرواية كلها فتعطي الشرعية لتساؤلي: “لماذا لجأ الكاتب إلى مثل هذا الأسلوب الذي أصبح ظاهرة في روايته؟ أليست “ضحى” كلها قطع لوصل ومحاولة لوصل الوصل؟ كما قال الراوي في الليلة الثانية، في فصل عنوانه “بلاد بلا وطن”: “باقون هنا … باقون نصل الوصل … نستقبل العائدين. نحن باقون، شهادة على الجريمة” (130). أليس هذا، أي “وصل الوصل في بلاد بلا وطن”، تجسيدا لضياع الكاتب الذي يستعين باللغة، كما استعان بغيرها، للتعبير عن ضياعه؟”. وإليكم بعض النماذج المشابهة التي تُؤكّد انتشارها كظاهرة في الرواية. في الليلة الأولى: “بيّض الله أيامك والليالي”(10)، “أغرق في بركة أحلامي وماضيّ والذكريات” (23). العبارة نفسها تتكرر ص 226، على لسان “ماري تريز” حين كانت في رحلة ضياعها في القطار، المشابهة لرحلة ضياع “عبد الباقي” بعد أن أضاع حبيبته “تانيا”)، “طاب المكان وصفا الزمان يرتّلان عشقنا والوجد” (49)، “استمع إلى دقّات قلبها وشهيقها والزفير … فهذه الدرع درعك والحسام” (53)، “تقوم على ذراعيها والركبتين” (59). في الليلة الثانية” “فهل نشطب تاريخنا والذاكرة؟” (128)، “في هنائنا وفي الشقاء” (141)، “جلست في مأتم أيامي ومآل المصير” (146)، “أنظّم دقّات قلبي، أرتّب الشهيق والزفير. أرنو إلى جدرانه العتيقة وشبابيكه المشنوقة والشرَف المتدلية” (149)، “بدأت آتيه في أحلامي والأماني” (162)، “تتيه وتميد في اهتزازها وفي غنجها والدلال” (198). وفي الليلة الثالثة: “شيوخنا وعلية القوم” (207)، “من أخمص قدمه حتى الرأس” (210)، “أغرق في بركة أحلامي وماضيّ والذكريات” (226)، “تسيطر على وجداننا والحواس” (258)، “على جسدي مرارتك وحسرة أبي وشقاء العمر وهول الخسارة” (271).
لغة الرواية المباشرة أيضا، مليئة بالعبارات التي تحيل إلى الاغتراب والضياع والخراب. وهي تنتشر في جسد الرواية كلها. “تعذّبني تساؤلاتي الكثيرة. لعل النهار يأتي بجديد … خاب الرجاء. أغرق في السراب … سأجد فيها جوابا لتساؤلاتي وحيرتي واضطرابي …” (39). “رُحتُ ألملم نفسي من بعثرتها … سقطتُ صريع عذاباتي في عذوبة الذكريات، التي راحت تفيض من قلبي” (40). “ينتابني شعور استسلام أمام علامات الهزيمة. في داخلي تتعزّز الخيبة ويسود التشاؤم …” (43). “البلاد التي شنقت وطني” (134). “ماذا بقي لنا سوى شفق الوكالة؟؟؟” (141). اختفى كله … لهفي كيف راح؟ وكيف ارتحل؟” (144). الخسارة تمشي معي، في منتهى بؤس عُريها، أنا العائد! أقف ضائعا في شارع من شوارع وطني، أشعر بالغربة والوحدة” (145). “رِجْل تجرّ الخسارة وأخرى تنوء بثقل الضياع” (152). “كيف يهون عليك خراب بيتك؟” (153). ويعمّ الضياع والخراب خاصة في الليلة الثانية، لدرجة أنّ الراوي يشعر أنّ ذكرياته تتحوّل إلى متاهات تخنقه، وتتحوّل إلى نوع من جلد الذات، فيقرّر ألّا يتابعها، “لن أقسو على ذاتي أكثر … لن أجلد روحي أكثر” (153)، لأنه رغم كل ضياعه والخراب الذي حلّ بعالمه، ليس من أجل جلد الذات عاد.
في الوقت نفسه، تشكّل اللغة رابطا قويّا بين ليالي الرواية، ربما لم يلتفت له أولئك الذين يعتقدون بهشاشة الرابط بين أجزائها. يظهر ذلك في تكرار بعض العبارات، التي تتكرّر لتعبّر عن تشابه مصائر بعض الشخصيات بمصير “عبد الباقي”. “فعلا نحيبها يذبحني من الوريد إلى الوريد” (59)، هذه العبارة ترد في الليلة الأولى على لسان “عبد الباقي” لتحدّد مصير علاقته مع “تانيا”، أو لتشعرنا به على الأقلّ. وتتكرّر في الليلة الثانية: “ثم انثنى إليها يذبحها بسكينه … من الوريد إلى الوريد” (202)، والذبيح هنا هو “ضحى” نفسها. أليست مأساة “ضحى” هي مأساة “عبد الباقي”؟ أما عبارة “أغرق في بركة أحلامي وماضيّ والذكريات” (23)، فتُذكر في المرة الأولى في الليلة الأولى على لسان “عبد الباقي” الذي يغرق في ذكرياته في القطار الذي استقلّه إلى “لنينغراد” للبحث عن “تانيا” التي سيكتشف لاحقا أنه أضاعها وأصبحت ماضٍ تولّى وأصبحت أحلامه هموما. وفي المرة الثانية في الليلة الثالثة، تُذكر العبارة على لسان “ماري تريز” في ظروف مشابهة، فهي كذلك كانت في القطار، هاربة من واقع مؤلم إلى مستقبل مجهول. تقول بعد أن قطع لها بائع التذاكر تذكرة” “وتركني أغرق في بركة همومي وماضيّ والذكريات” (226). الاختلاف بين عبارتها والأولى هو لفظة هموم بديلا للأحلام. ألم تتشابه المصائر وتتحوّل أحلام “عبد الباقي إلى هموم؟
عبارة “سفينة بلا هدف لمرفأ، لا تعنيها اتجاهات الرياح” (51)، ذُكرت في الليلة الأولى على لسان “تانيا” تستشرف بها نهاية علاقتها بـ “عبد الباقي” إذ تغني له: “أهدني للوداع تذكرة لقطار يسافر! لا يهمّني إلى الشمال أو الجنوب”، وتطلب منه ألّا يتركها “كسفينة بلا هدف لمرفأ، لا تعنيها اتجاهات الرياح”. وطلبها يُفهم حين تتابع: “أرض لا تكون أنت فيها، كلها عندي سواء … لا يطيب لي فيها المقام” (51). ما يهمّنا من العبارة أنه يمكن إسقاطها بسهولة على حالة الضياع التي يعيشها “عبد الباقي” والإنسان الفلسطيني عامة. وهي نفس الحالة التي مرّت بها “ماري تريز” عندما هربت من بيت خالها وظلم زوجته. فهي تقول عندما خرجت من محطة القطار: “أتسكع كخشبة تنساق مع الموج من جهة إلى أخرى … من يعنيه الاتجاهات؟ سفينة بلا هدف لمرفأ محدّد لا تعنيها اتجاهات الريح” (51). وتُذكر العبارة مرة ثالثة بشكل مقتضب، لتجسّد ضياع “عبد الباقي” في الليلة الثالثة بضياع “ماري تريز” نفسها؟ ولكن، هناك فرق جوهري بين ضياع “عبد الباقي” وضياع “ماري تريز” وابنها “ألفيي” بعدها. وهو أنه لم يفقد الحلم الذي فقداه. يُؤكّد ذلك ما يقوله الراوي: “من يفقد حلمه لا تعنيه اتجاهات الرياح … من يقبض على حلمه فسيشهد تفتّح البراعم”، وما يقوله “ألفيي” لـ “عبد الباقي”: “نعم، لك ما ليس عندي. لك حلم تقبض عليه وأحلامي تقشّفت” فيُؤكّد ذلك “عبد الباقي”: “نعم. لي قدسي هي صبوتي! تعيش في عواطفي …” (318).
ما ذكرته هو عيّنات قليلة من لغة مشحونة بألم الفصل ولذّة الوصل، بالغربة وقسوة الاغتراب، بالضياع وشهوة الخلاص بالقبض على الحلم إلى أن يتحقّق، وبالخراب وصعوبة الإصلاح، لأنّ الذين اجتمعوا على الخراب، بطشهم وقسوتهم أعظم من أن يحتمل الراوي مواجهتهم، خاصة وأنّ الغاصب مدعوم من ذوي قربى “عبد الباقي” نفسه.
مضمون الرواية
يحاول الكاتب في روايته أن يوجّه أكثر من رسالة إلى العالم عامة، وإلى شعبه الفلسطيني بشكل خاص، متخذا من سيرته الشخصية نموذجا للفلسطيني الذي لا بدّ له من مواجهة واقعه ووضع حدّ لهروبه ومعاناته.
السيرة الذاتية والمنفى
“ضحى” حسين ياسين هي “رواية منفى” تحمل الهمّ الفلسطيني بامتياز. فالفلسطيني عامة، والكاتب وبطله خاصة، عاشوا وما زالوا يعيشون تجربة المنفى بكل بشاعتها داخل الوطن وخارجه. وهي رواية فيها الكثير من ملامح السيرة الذاتية أيضا. والمنفى كما يقول دراج، “تجربة ذاتية أولاً، وفي كل سيرة ذاتية منفى، يختلف بين إنسان وآخر، دون أن يتخفّف من حرقة زمن مرغوب، لا تمكن استعادته”.[5] وقد انتقى حسين ياسين أحداث روايته، كلها أو بعضها، من أحداث حياته التي تعبّر غالبا عن حياة أيّ فلسطيني. وقد طعّمها بتعدد الأصوات لأسباب سبق ذكرها. ويرى دراج أيضا أنّ “رواية السيرة الذاتية والمنفى تغيّب الاحتفال بالزمنالذاتي/الشخصي/الحميمي للمنفيّين في سِيَرهم، إذ وجد أنّ هذه الفترة (الزمن الذاتي) تعتبر بمثابةالزمن المهمّش في السيرة الذاتية العربية، بسبب ما أسماه بـ “التحرّش“ أو “الرقابةالذاتية”. وعليه، فالزمن الذاتي الحميمي يبدو زمناًحقيراً أمام زمن الجماعة التي تحتلّ مكانة محترمة وموقرة”.[6]إذا أخذنا هذه الملاحظة بعين الاعتبار سنجد أنها تنطبق، وإن لم يكن بشكل دقيق، على رواية “ضحى”. فالزمن الذي يحتفل به حسين ياسين هو زمن الجماعة أصلا، وقضيته هي قضية شعبه ووطنه، إلّا أنه يحتفل في روايته كثيرا بالزمن الذاتي، الحميمي، ولكنّه الزمن الذي فقد حميميّته منذ الليلة الأولى، فوصل به إلى ما يُشبه جلد الذات. كأنه يريد أن يحمّل نفسه شخصيا مسؤولية ضياعه وهروبه، ومسؤولية ما حلّ بعالمه وعالم شعبه وأرضه من خراب. ولذلك، الكاتب وبطله أيضا يعيشان في داخلهما منفى ذاتيا، لأنّ انفصالهما عن القدس، أو الوطن عامة، سواء كان داخله أو خارجه، هو انفصال نفسي قسري قبل أن يكون انفصالا جسديا اختياريا أو قسريّا. ولكن في كل الأحوال، يظلّ الهمّ الفلسطيني همّا واحدا وقضية واحدة، سواء عالجه الكاتب والرواية كهمّ فردي أو جمعي.
“ضحى” حسين ياسين، هي رواية انشراخ الذات الفلسطينية فردا وجماعة. هي رواية الاغتراب والضياع: ضياع الكاتب، ضياع الراوي، ضياع المقدسي، ضياع القدس، ضياع الفلسطيني وضياع فلسطين. وبالتالي، فهي رواية ضياع الوطن والهوية. ولكنها في الوقت ذاته، وبفعل الكتابة على الأقلّ، هي ثورة تقاوم الاغتراب والضياع والخراب، ولكن بالكتابة فقط، لأنها ثورة الخاص بعد إخفاق العام، أو ثورة الفردي والذاتي بعد إخفاق الجمعي والوطني، وبعد انكشاف عجزهم جميعا.
الهروب إلى المنفى
تبدو الليلة الأولى كاسترجاع لماضٍ جميل في الاتحاد السوفييتي، رحل إليه الراوي للدراسة، أو استعادة لذكريات جميلة عاشها هناك. وهي فعلا رحلة جميلة وممتعة، ذلك لو أخذناها بشكلها المجرّد، كحياة لطالب عادي، رحل فيها فنهل ما شاء من العلم، وذاق فيها حلاوة الحبّ والجنس، في مجتمع مفتوح لا يُعاني من العُقد الشرقية، الاجتماعية والدينية، ومارس متعة السفر في المساحات الشاسعة والمسافات المترامية للاتحاد السوفييتي بجمال تضاريسه وتعدّد شعوبه وتنوّع عاداتهم وتقاليدهم. ولكن في تلك الرحلة الجميلة والممتعة، الكثير مما يُثير التساؤل: ما الذي جعل الراوي يُمهّد لرحلته تلك بلقائه مع الغجر الذين نعرفهم في بلادنا، فلسطين، فيُذكّرونه بنساء بلاده، القرويات في القدس يبسطن بقولهن في باب العامود، وبقهوة أمّه التي يحبّها صباحا؟ ولكن على وجه الخصوص، لقاؤه مع تلك الغجرية التي ذكّرته باقتلاعه إذ قالت له: “متى اقتلعوك من أصولك وغرّبوك عن ذاتك؟” (11). تلك العبارة تختصر الفاجعة التي حلّت بالراوي وشعبه، وتلقي بظلالها عليه وعلى ما يُحدث له في منفاه الحميمي، وكذلك على القارئ الذي يحتار بين عذوبة ذكريات “عبد الباقي” ومرارة خيباته، في الليلة الأولى وفيما تلاها أيضا.
ذلك في التمهيد فقط. ولكن الرحلة كلها مليئة بتلك الإشارات التي تعيد الراوي إلى فلسطين. لماذا يُذكّرنا بـ “فرفطة” الاتحاد السوفييتي وتغيير أسماء مدنه بعدها؟ أليس هذا ما حدث في فلسطين بعد نكبتها واحتلالها و”فرفطة” أهلها؟ لماذا يُعيدنا إلى “عرابة” قريته التي “بيوتها بلا كهرباء ولا مياه” (30)؟ لماذا يتذكّر العدوان الثلاثي الذي “كانت فيه إسرائيل رأس الحربة وفتيل الانفجار” (35)؟ وغير ذلك إذ يقول: “كانت “تانيا” أجمل شيء في حياتي. فلماذا خسرتها؟” (47). ألا تُعيدنا خسارة الراوي لها وعجزه عن استبقائها، إلى خسارته للقدس وعجزه عن استبقائها أيضا، وتُبيّن لنا رعبه من العجز عن استعادتها؟ و”تانيا” نفسها تذكّره بخسارته لوطنه الذي سيفرش لها فيه “زنود السريس وأوراق الميرمية” (61)، تقول له: “تذكرة سفري وطن … لن أجيء إلى بلاد ليس فيها وطن” (61). ألا يعني ذلك أنها تقول له “أضعتني كما أضعتها، ولن تستردّني إن لم تستردّها؟”. ولماذا يُذكّرنا الكاتب بالهزائم العربية المتلاحقة، وبذلك البصيص من الأمل الذي سرعان ما ومض وخبا، عين جالوت ونصر المسلمين فيها على التتار (76-77)؟ ولم ينسَ أيضا تذكيرنا بأطفال الحجارة (115). ويختم الليلة الأولى بما تنعته “تانيا” به: “هو متزوّج، متزوّج، من القضية” (117). ألا يقودنا ذلك كله، إلى أنّ كل ما يحدث للراوي في المنفى فيه إسقاط على حالته النفسية وعلاقته بوطنه، وبالقدس بشكل خاص. وهناك أكثر من عبارة تُؤكّد ذلك. لنقرأ مثلا ما تقوله “تانيا” في رسالة الانفصال عنه: “لم يعد حبّنا مفاجأة ولا هدية، لن أعيش في حيرة السؤال “إن كنت أمينا على غيابي؟”، … إذا أحببت فتاة فلا تتردّد … إذا تردّدت، ستكون الفتاة حزينة” (40). أليس هذا هو حال الراوي مع القدس التي تربطه بها علاقة حبّ أقوى من علاقته بـ “تانيا”، ويقتله في تلك العلاقة التردّد بل ما هو أشدّ وأقسى منه أضعافا. وإلّا، ما معنى قوله بعد ذلك مباشرة، “رُحت ألملم نفسي من بعثرتها … سقطت صريع عذاباتي في عذوبة الذكريات، التي راحت تفيض من قلبي” (40). أليست القدس هي الجزء الأساسي في ذكرياته العذبة التي سقط صريع عذاباته فيها؟
أمام هذا الحشد الهائل للحضور الفلسطيني في الليلة الأولى، وبشكل خاص أمام التماهي بين قصة الراوي مع “تانيا”، وخسارته لها، وبين قصة خسارته للقدس، ندرك أنّ الكاتب لم يرسل بطله للدراسة والمتعة في الاتحاد السوفييتي، وإنما حمله على الهروب الذي سبقه إليه. الهروب من واقعه الذي أخذ يضغط عليه، ومن وطنه الذي ضاق عليه أيضا، القدس التي لم يعد يحتمل رؤيتها تُغتصب يوميا أمام ناظريه، وهو لا يملك ما يُنقذها به. ولذلك، تبدو الليلة الأولى تجسيدا لهروب الفلسطيني من المواجهة، وتمهيدا لفاجعة الضياع والخراب التي ألمّت به وبالقدس بشكل خاص، وبشعبه ووطنه فلسطين بشكل عام. ذانك الضياع والخراب اللذيْن سيستقطبان الحديث في الليلتين التاليتين. ولذلك، صحيح أنّ الليلة الأولى مليئة بعسل الذكريات، ولكنه العسل المرّ الذي أضاع حلاوته علقم الاقتلاع من الجذور والهروب من الواقع. وهذا ما يجعل المنفى، رغم الأيام السعيدة التي قضاها الراوي فيه، مكانا عدائيا لا يألف المنفيّ ولا المنفيّ يألفه. ولكن، رغم أنّ المنفيّ لم يمت، إلّا أنّ نهايته وخيبته تُذكّران بنهاية شخصيات غسان كنفاني في روايته “رجال في الشمس” التي كانت فاجعة أكثر لأنّها تحمل تحذيرا للفلسطيني لا يقبل أكثر من تأويل، “الهروب لن يسعفك، وإن لم تواجه عدوك داخل وطنك فسوف تموت”، ولم يكن كنفاني حينها يتوقّع الضياع والخراب أكثر مما حدث في النكبة، بل كان يُخطّط للمواجهة التي تدفع الفلسطيني إلى الوقوف والبناء من جديد. أما حسين ياسين فهدفه مختلف تماما، لأنّ كنفاني واجه مشكلته كإنسان رأى في نفسه وشعبه القدرة على الوقوف من جديد وعلى المواجهة. أما حسين ياسين فقد واجه مشكلته كإنسان مهزوم، لأنه عاش الضياع وشهد الخراب، خاصة ذلك الذي تلا النكبة وجاء بهزيمة حزيران 1967 وما تلاها، ووقف عاجزا أمامهما. ولمّا لم يستطع المواجهة هرب إلى المنفى الذي بدوره، أكّد له ألّا سبيل للخروج من محنته إلّا بالمواجهة. فجاءت روايته “ضحى” كبداية لتلك المواجهة، ولكنها مواجهة تختلف عن مواجهة “حامد” في رواية كنفاني، “ما تبقّى لكم” التي تلت “رجال في الشمس”. مواجهة حسين ياسين وبطله “عبد الباقي”، جاءت لتحمي قضيته من الضياع، وذلك بحفظها في ذاكرة الأجيال. وفي ذلك استشراف للمستقبل وإن كان غامضا، لعلّ جيلا فلسطينيا سيأتي فيه ويقوم بما عجز عنه حسين ياسين ومن عاصروه. ولذلك، يمكن أن نرى إلى رواية “ضحى” كاعتراف بالعجز الفلسطيني، وفي الوقت نفسه، كدعوة للمواجهة والتخلّص من الهروب، لأنّ المنفى نفسه، لم يرفض هروب الفلسطيني فحسب، وإنما حثّه على المواجهة، كما جرى ذلك على لسان تلك الغجرية، التي أعجبت بتصرّف الراوي النبيل حين قال لرفيقه “ادفع بالتي هي أحسن” (11)، فخاطبته باحترام كلّي خطاب المجرّب والعالم بمأساته: “متى اقتلعوك من أصولك وغرّبوك عن ذاتك؟”، ولكنّ خطابها له لم يكن مجرّد تذكير، وإنما أشارت عليه بالإلحاح في طلب حقّه وعدم المساومة فيه، “أطلب حقّك بإلحاح … ولا تساوم … المشكلة فيمن اغتصب الحقّ، كيف يؤدّيه، وليست فيمن يطلبه … لا تحمل مشكلة غيرك. يكفيك من الهمّ مشكلتك” (11).
استنادا إلى ما تقدّم، تصبح تجربة المنفى لدى حسين ياسين، تجربة هاربة استبدل فيها مكانا كان أليفا ولكنه لم يُعد كذلك، بمكان آخر رغم حميميته لم يُخلّصه من الشعور بالاغتراب الذي يُشير إلى ذات لم يتبقّى لها إلّا الكتابة. وهو ما حوّل اللجوء إلى المنفى إلى هروب واضح، من واقع افتقد فيه الكاتب وبطله الألفة التي نعِم بها زمنا.
وعلى ما تقدّم أيضا، اعتراف الرواية وكاتبها بالعجز يُشكّل خطوة أولى توازي الاعتراف بوجود المشكلة الذي لا بدّ منه كنقطة انطلاق لحلّها. هذا ما تعلّمه من المنفى، حيث “ماريا بترفنا” تريده أن يتزوّج ابنتها “تانيا”، التي تشترط مهرها وطنا لا يملكه “عبد الباقي”، فتنوّره “ماريا ” وتبيّن له الفرق بين الأمم المقهورة والأمم الحية: “الإنسان المقهور يستجيب لقاهره … يجترّ أيامه الغابرة … يؤجل المستقبل … المقهور ينيخ في ساحة التمنّي وأحلام اليقظة … يستجدي قاهره … يبحث عن نجاته في موقع هلاكه … (بينما) الأمم الحيّة تقتحم مجاهل الغد … تبحث في مغامرات محسوبة عن حلول أفضل … تسكن الماضي بقدر ما تستخدمه أداة من أدواتها في بحثها عن المستقبل” (132).
ولا بدّ من إشارة أخيرة حول منفى الكاتب بالذات، حيث أنّ وصفه للزمن الحميمي السعيد الذي قضاه هو أو بطله في المنفى، خاصة ذلك الذي انعكست فيه الذكريات الجميلة بما فيها من حلاوة الجنس ومتعة السفر وكرم الضيافة، هو نوع من اعتراف الكاتب بفضل الاتحاد السوفييتي الذي احتضنه في فترة عصيبة من عمره وتاريخ وطنه، وهو الذي علّمه أنّ حلّ مشكلته لا يمكن أن يكون في هروبه منها.
الوصية: “ديّتي وطن”
في الليلة الثانية قبل العودة إلى الوطن، وفي حواره مع “ماريا بترفنا”، أم حبيبته “تانيا”، يُؤكّد “عبد الباقي” عدم قدرته على الزواج من “تانيا”، لا لأنه يرفضه ولكن لأنه عاجز عن مهرها، فهو “فقير لا يملك مهرها. فمهرها وطن” (126). ولكنه يُؤكّد أيضا على وصية الأجداد الذين حصدتهم جريمة النكبة، للآباء والأبناء الذين حملوا وزرها. “قال جدّي لوالدي، وقال لي أبي ما قاله له جدّي، وقد أقول لأولادي: “وصيتي! ديّتي وطن، هذا كل إرثي، فلا تفرّطوا بإرثي واطلبوا ديّتي، ولا تهجروا بقايا الوطن” (126). وتشي عبارة “قد أقول لأولادي” بضعف “عبد الباقي” وعجزه، لدرجة تجعل حفظ روايته في ذاكرة الأجيال بطولة. وأحداث الليلة الثانية وحكاياتها تُؤكّد ذلك.
في الليلة الثانية، كل محاولة للتسوية مع الغاصب، لفرط بطشه وعنجهيّته، باءت بالفشل: التقسيم، السلام، المساواة، ما تبقّى من أرض، قبور الأجداد، حتى طلب الرحمة قابله الغاصب بغرور لم يُبقِ لـ “عبد الباقي” وشعبه إلّا “اللجوء المؤقت حتى نتدبر أمركم” (129)، ولم يَعِد إلّا بـ “وصمة الإرهاب وبطش المطاردة” (129)، فبدأ الضياع والخراب نتيجة الضعف والعجز. ولكن، ظلّت الوصية قائمة تتداولها وتتوارثها الأجيال، ذلك ما يُفهم من تساؤلات “عبد الباقي” الإنكارية: “هل نعقّ؟ هل نخون العهد؟ هل نشطب تاريخنا والذاكرة؟ هل نرحل” (127-128). ظلّت الوصية قائمة رغم أنّ “ميراث الألم يتعمّق ويزداد مرارة عندما ينتقل من جيل إلى جيل” (130). وقد بلغ الألم حدّا يفوق قدرة الفلسطيني على الاحتمال. ضاق عليه الوطن فلاذ بالهرب إلى المنفى الذي أكّد له أنّ الهروب لا يحلّ المشكلة، المواجهة فقط هي الكفيلة بذلك.
هزيمة الرواية الأصلية أمام الرواية الملفّقة
في الليلة الثانية أيضا، يعود الراوي إلى القدس عودة الغريب عنها. يعود إلى بلاد فقد وطنه فيها، ليسرد ضياعه وضياعها، من خلال ما اقترفه الغاصب المحتلّ بحقّه وحقّ الفلسطينيين عامة، متمثلين بالشخصيات المقدسية في هذا الفصل من الرواية، وخاصة من خلال الضياع والخراب الذي لحق برفيقة صباه، “ضحى”، التي يختزل الكاتب بمأساتها مأساة القدس وفلسطين عامة.
لأحداث هذه الليلة أيضا، يُمهّد الكاتب بملمح ميتاقصي يتمثّل بحكاية “حكمية والغول”، التي ينقلها عن كاتب فلسطيني عريق، هو محمد نفاع الذي يعرّفه بأنه “يجمع المجد من طرفيه: بقل الأرض وسياسة البلاد” (121)، أي بمعرفته العميقة بهما.
كما أكل الغول وليد حكمية، في حكاية نفاع، أكل الغاصب فلسطين وروايتها، في رواية حسين ياسين، ما يُؤكّد ضياع الرواية والراوي، والخراب الذي حلّ بهما. ولكن الكاتب والراوي لا يفقدان الأمل، ففي وجود نفاع وياسين ومعرفتهما العميقة بالأرض والقضية، ومعرفتهما بالسياسة التي تشرعن اغتصاب الأرض وتحاول قتل القضية، بوجودهما ضمان لبقاء الصراع مفتوحا، ولبعد النهاية التي يطمح إليها الغاصب.
المضحك المبكي، بعد عودة الراوي إلى القدس، والمفارقة التي تُؤكد الضياع والخراب، أنّ الراوي يقف على تطوّر الأحداث التي عصفت به وبشعبه، من خلال رواية الغاصب التي تُهيمن على أحداث الليلة الثانية.
من الصعب أن أذكر هنا كل الأسماء التي يذكرها الراوي في أول زيارة له بعد المنفى لبلاده، “البلاد التي شنقت وطني” (134) كما يصفها. في طريقه إلى القدس وإلى البيت الذي كان يوما ما بيته، يذكر أسماء كثيرة للقرى والمدن المحيطة بالقدس، وأسماء أحياء القدس وشوارعها وشجرها ومقاهيها وفنادقها ولا يترك معلما من معالمها، ويذكر أيضا أسماء أصحاب بيوتها الأصليين وأيام السعادة والشقاء التي قضاها معهم. كل تلك الأسماء والذكريات تُؤكّد أنه ابن هذه المدينة، وابن هذا الوطن، الذي يقول عنه متسائلا: “كم كان الوطن جميلا وكبيرا! فلماذا يضيق بنا الآن؟” (136). إنه الشعور بالمنفى والاغتراب، ولكن في الوطن بعد ما حلّ به من اغتصاب واحتلال وتغيير للكثير من معالمه وأسمائه. ولذلك ليس غريبا أن يشعر وهو في طريقه إلى بيته، أنّ “الخسارة تمشي معي، في منتهى بؤس عُريها، أنا العائد! أقف ضائعا في شارع من شوارع وطني، أشعر بالغربة والوحدة” (145). إنه الشعور بالضياع والخراب المستمرّ، فكأنّ الراوي يستشعر بأنّ القادم أقسى، وما ينتظره من ألم وضياع وخراب يفوق ما أحسّ به في طريقه إلى بيته الذي لم يعد بيته.
المصيبة لا تتأخّر لتأتي حين يصل البيت، حيث يستقبله “قاطن الدار”، الساكن الجديد، الذي كان يتوقّع حضوره، فيدخل وحاله “رِجْل تجرّ الخسارة وأخرى تنوء بثقل الضياع” (152)، ليجد أنّ البيت ومعظم أشيائه بقيت على حالها كما تُركت: “في الركن نملية أمي. لا يزال يعيش فيها: الإبريق النحاسي، وصينية القهوة والفناجين الصينية، في غرفتي لا يزال يعيش سريري، ورفّ الكتب! فقط بدّل مقتنياته، وصورة غريبة دخيلة على المكان لصبي بزيّ إفرنجي” (152-153). كل ما يراه يُؤكّد السطو على عالمه، وأنّ “كل شيء الآن برهان على الخسارة والنقصان ومقارنة موجعة مع ما كان” (154). كل ذلك ولم يكن حوار الروايات قد بدأ، حوار الرواية الفلسطينية مع الرواية الصهيونية. ولمّا بدأ وجد الراوي أنّ الرواية الجديدة تهمّش روايته، وتفلسف التغيير وتشرعن الاغتصاب، وتعتبر ما حدث تحوّلا طبيعيا، “لا شيء يدوم، كل الأمور تتبدّل” (155)، وتعزو التغيير وتشويه المعالم إلى “أيديولوجيات كبرى، وسياسات عليا، وتخطيط مدن، واستغلال أنجع للحيّز المتاح” (161). ويبدو الأمر طبيعيا، فالرواية الصهيونية قامت على نوايا الاستيطان والتوسّع، واعتمدت وما زالت تعتمد فلسفة القوة والبطش وآلة الحرب. ولكن، رغم عسف هذه الرواية وجبروتها، فهي لا تخفي اهتزازها والشعور بالخوف الملازم لها، ما يُؤكّد أنّ أصحابها ليسوا أصحاب حقّ. يظهر ذلك من تساؤل “قاطن الدار”: “متى تنتهي مخاوفنا؟ متى تنتهي حروبنا؟” (163). وأكثر من ذلك فرواية “قاطن الدار” تعرف أنّ مصيرها إلى زوال رغم غموض الزمن، وأنّ أصحابها ليسوا أصحاب أرض ووطن. يؤكّد ذلك أيضا تساؤل “قاطن الدار”: “من سيرث ما لم أرثه؟ … نحن عابرون في هذا الوجود” (164).
وإذا كان هذا الكلام فيه نوع من العزاء للراوي، وفيه دافع كاف لحفظ الرواية، إلّا أنه ما زال يستشعر أن القادم أخطر، وأنّ هذه ليست النهاية، وأنّ هناك مزيدا من البعثرة والضياع. وإذا كان “قاطن الدار” اكتفى بالتلميح الموجز ولم يكشف عن تفاصيل المؤامرة وتعدّد الوجوه البشعة لروايته، فإنّ “شمعون حسون”، جار “عبد الباقي” من “رحافيا” (أحد أحياء القدس) وزميله من أيام الدراسة، بغروره واستعلائه وقلة أدبه وساديته وتعطّشه للدماء، كان كفيلا بالكشف له عن تفاصيل المؤامرة وعن أكثر وجوه روايته بشاعة.
يقول “عبد الباقي” بعد فراغه من لقاء “قاطن الدار”: “في حيرتي واضطرابي وسخطي وتعثّر خطاي وتهدّج أمري، لاقيته، شمعون حسون” (167). “حسون” هذا، في لقائه مع “عبد الباقي” هيمن على السرد، واجتهد أن يعلو صوته ويطغى على صوته. لبس في بداية اللقاء قناع إنسانيته المزيفة. أظهر شفقته على حال “عبد الباقي” وأعرب عن سعادته بلقائه، ثم أخذ بنعومة أفعى يسحب البساط من تحت قدميه، ليؤكّد بعد ذلك على رواية “قاطن الدار”: “ما هذه النفس المترعة بأحزان الدنيا؟ ما بالك محتقنا ومكدودا؟ أتراها شجون الذاكرة عصفت بك؟ أم لواعج أيام خوالٍ هدهدتك؟ أو لعلها صدمة تغيّر المكان وتحوّل الزمان؟ هون على روحك قليلا، فالتغيّر والتخلّق نواميس الوجود” (168-169). ولمّا أيقن “حسون” بضعف “عبد الباقي”، تغيّرت نبرته وأخذ ينفث سمومه في وجهه ونفسه، مطالبا إيّاه بقبول الواقع الذي تبدّل. “ما كان قد مضى، الواقع قد تبدّل، أفق صاحبي واصح، الوجود في تبدّل وتجدّد. فإما أن تتبدّل وتتجدّد معه أو تبقى خارجه” (169). ومن غير أن يفسح مجالا لـ “عبد الباقي” للكلام أو الاعتراض، ولا حتى للتعليق أو الملاحظة، وإذا علّق أو لاحظ، لم يكن يعير تعليقاته أو ملاحظاته أيّ اهتمام، كان “يتدثر بشموخ المنتصر. كعادته، يتغاضى عن كلامي، كأنه يشطب وجودي” (180). في البداية اختزل الجريمة التي اقترفتها يداه بجملتين: “نحن لا نترك الأمور للأقدار، إذا قتلت، فرصاصتان: واحدة تقتل والأخرى تؤكّد القتل” (171). ثم راح يقصّ على “عبد الباقي” تفاصيل الجريمة وهو يعرف أنّه يذبحه بسكين غروره ساديته.
بدأ “حسون” بقصة بائع السوس المقدسي، “عمو الياس”، الذي جنّده لخدمته كبائع سوس لمدة خمسة وعشرين عاما في مخيّم “اليرموك”، ما يعني استغلاله ضعف الناس وفقرهم للهيمنة على مصائرهم وعلى السياسة والاقتصاد في فلسطين والمنطقة العربية، وحيث لا يُفلح في السياسة والاقتصاد، يضمن الخراب على الأقلّ. فالسوس، خاصة ذلك الذي يُصدّره “حسون” هو ليس عصيرا، وإنما هو رمز للخراب. وقد نخرت جواسيس إسرائيل جسد فلسطين والعالم العربي كما ينخر السوس الخشب.
ينتقل “حسون” في روايته من المؤلم إلى الأشدّ إيلاما، يتعمّد الإساءة الجارحة لـ “عبد الباقي”، إذ دفعه غروره للتلذّذ بالسخرية من حكاية “إسكندر المجدلاني”، أي من شقاء الناس وفقرهم وكفاحهم من أجل لقمة العيش، ومن بقائهم، بعد أن خرّب ديارهم، على حبّهم لـ “فلسطين والخلفة والعلم” (174).
انتقل “حسون” إلى المقاومة الفلسطينية فحوّلها إلى إرهاب، ورجالها إلى إرهابيين، ليمتلك بذلك شرعية تصفيتهم. ذلك ما حدث لـ “سلمى”، تلك الفتاة المقدسية التي شرّدها الاحتلال إلى العراق فدفعها حبّ العلم إلى جامعة بغداد حيث تخرّجت طبيبة، ودفعها حبّ فلسطين لالتحاق بالمقاومة. ولكنها المقاومة في عرف “حسون” إرهاب، و”سلمى” خاطفة طائرات يحقّ له قتلها، فاغتالها. يقول “لم تعش طويلا. جاءها الموت قبل الغسق” (175).
وما يُؤكّد وحشية الغاصب وحبّه للسيطرة والبطش، ولكن في الوقت نفسه، خوفه من العقل الفلسطيني وحبه للعلم والتطوّر، قصة “قاسم”، ابن الخياطة جميلة. ذلك العالِم الذي كان يدير مركز أبحاث له شهرته في الغرب، رفض التعاون مع الغاصب والعمل لخدمته، ورفض العودة إلّا إلى وطن محرّر، لذلك “انهار مركزه وثقلت عليه مديونيته وفُتحت المحاكم ضدّه. وهو اليوم منبوذ من الجالية الأكاديمية، يعيش على هامش المجتمع” (177). حكاية “قاسم” لا تشير فقط إلى ملاحقة المجرم لضحيّته، وإنما إلى سيطرة الغاصب على محافل كثيرة في المجتمع الدولي. وهذا يقودنا إلى حكاية / مأساة “ضحى” التي كانت لـ “عبد الباقي” كالقشّة التي قصمت ظهر البعير.
“ضحى” فتاة مقدسية متمرّدة، تحبّ الحياة والعلم وتحمل الأمل بمستقبل جميل، شرّدها الغاصب في متاهات العالم، فمن الأردن إلى العراق حيث فقدت عذريّتها في “خمارة البصرة” ومارست فيها البغاء، ثم رحلت إلى الخليج مع “جاسم الربيعي”، هربا من استغلال “فؤاد العجمي” الذي ألحّ على شرائها من “صاحبة الخمارة”، لتجد نفسها قد هربت من الرمضاء إلى النار. ومن الخليج إلى لبنان حيث الحرب الأهلية وصراع الفصائل الفلسطينية والقتل المجّاني. هناك التقت “ابن الساحل”، الشاعر الفلسطيني الذي أعاد لها رائحة الحنين إلى القدس (192) وجدّد لديها الأمل فأحبّته، إلّا أنّ أملها اغتيل باغتياله، “جلس يشرب قهوة الأصيل، ويكتب القصيدة. جاءته رصاصة طائشة. اقتنصوا ابن الساحل، وسُجّلت الجريمة ضد مجهول” (201). فانتقلت إلى تونس “وعادت إلى مهنتها القديمة” (202). هناك زارها بحار غربي يحترف العنف والغدر، وبعد قضاء وطره منها كشف لها حقيقة نقده لها بالدولار المزيّف فكشفت له حقيقة إصابتها بمرض “السفلس” المعدي، فثار وعربد “ثم انثنى إليها بسكينه، يذبحها من الوريد إلى الوريد” (202).
من الصعب أن يلتفت القارئ إلى كل عناصر هذه القصة ويفهمها على أنها قصة شخصية فقط. وإذا كان الرمز ينتشر في الرواية كلها، فإنه يطغى على حكاية “ضحى” أكثر من غيرها، ويعطيها أهمية ليست لغيرها. يُؤكّد ذلك أنّ الكاتب اتخذ من هذه القصة عنوانا لروايته، وإن لم يكن هذا هو الدافع الوحيد، إذ في الاسم “ضحى” إشارة إلى النور والأمل، “ففي آخر عتمة النفق لا بدّ من ضوء، فقط علينا أن نسير ونكمل المشوار” (199). وقد أشار إلى ذلك من بداية الحديث عنها إذ قال: “لا، أبدا، ضحى لا تموت، لها الغد المشرق الجميل” (179).
ذكرت سابقا أنّ الكاتب يختزل بمأساة “ضحى”، مأساة القدس وفلسطين عامة. واجتماع الأشخاص الذين تسبّبوا بضياع “ضحى”، ما هو إلّا رمز لاجتماع العناصر التي اجمعت على ضياعهما. الغاصب يتحكّم بالخيوط كلها، ويهيّئ الظروف لخدمة مصالحه. وإذا كان “حسون” يُمثل الصهيونية، فإنّ بعض الشخصيات العربية في حكاية “ضحى”، تمثل الرجعية العربية التي طالما رقصت على الجرح الفلسطيني. أما البحّار الغربي فهو امتداد للإمبريالية الغربية التي طالما ادّعت المساعدة، ولكنها كانت السبب الأول في المأساة الفلسطينية وعامل ذبحها من الوريد إلى الوريد.
هذا الاجماع والاجتماع الثلاثي على تشريد “ضحى” واغتصابها ثم ذبحها، له دلالته الرمزية، فهو أمثولة لاغتصاب القدس وتشريد أهلها وقتل القضية الفلسطينية برمّتها. أمّا شخصية “حسون”، والشخصيات العربية مثل “جاسم الربيعي” و”فؤاد العجمي”، وكذلك شخصية البحار الغربي، فتمثل اجتماع الصهيونية والرجعية العربية والإمبريالية الغربية وإجماعها على تشريد الشعب الفلسطيني وقتل قضيته، خدمة للمصالح الإمبريالية السياسية والاقتصادية التي اتخذت من فلسطين وقضيتها وسيلة للهيمنة على الشرق العربي كله. وقد دفعت الشعوب العربية الثمن ظلما وقهرا، إلّا أنّ الشعب الفلسطيني كان كبش الفداء بما تعرّض له من تشريد وضياع وخراب. ذلك يُؤكّد أنّ “ضحى” ليست مجرد شخصية فلسطينية شُرّدت، وإنما مأساتها هي معادل لمأساة القدس التي يريدها الغاصب عاصمة تاريخية أبدية له بعد هيمنته على فلسطين كلها. ولكنّ ما زاد نزيف الجرح الفلسطيني والحزن اتساعا وألماً، هو دخول “الإخوة” العرب شركاء في اللعبة / المؤامرة، واستغلالهم للهمّ الفلسطيني، لقضاء مصالحهم السياسية والاقتصادية، وحتى الشخصية، بحيث أصبحوا لا يقلّون سادية وبشاعة عن سادية الغاصب الصهيوني وبشاعة ممارساته.
أمام المعرفة الواسعة التي يتمتّع بها “حسون”، والقدرة على تحريك الأمور داخل فلسطين وخارجها، وتأكيده على أنّ مشروعه يقتضي ألّا يترك شيئا للصدفة والأقدار، لذلك “دلق وحل أفكاره” (203) في وجه “عبد الباقي”، وعاد وأكّد له سياسته: “نحن لا نترك الأمور للأقدار، إذا قتلت، فرصاصتان: واحدة تقتل والأخرى تؤكّد القتل”، لأن ذلك، كما اعترف بكل صراحة ووقاحة وغرور، “شرط وجودي ومقومات بقائي” (203)، أي أنّ ذلك هو الهدف الحقيقي الذي خُلق له المشروع الصهيوني، خدمة المشروع الإمبريالي كضمان لبقائه، وكلاهما لا يتورّع عن ارتكاب أيّة جريمة، صغيرة كانت أو كبيرة، لضمان بقائه واستمرار هيمنته.
أمام كل ذلك، لم يجد “عبد الباقي” مكانا لروايته، ولا حتى لتعليقاته أو ملاحظاته. فقد هُزمت روايته، الرواية الفلسطينية، رغم كونها الأصلية الصادقة، ولكن في الوقت نفسه، الضعيفة المغتصبَة، لضعف أصحابها وفقر مواردهم المادية والمعنوية، فبدت الرواية الأصلية وكأنها فقدت مصداقيتها، هُزمت أمام رواية الغاصب “حسون” المختلقة والمزيّفة، التي لفّقتها الصهيونية وأعوانها، لأنها تتمتّع بالقوة، منها تستمدّ مصداقيتها المزيّفة، من قوة البطش والباطل التي يمتلكها الغاصب، وكذلك من ضعف الحقّ الذي تزعزعت ملكيته لدى الضحية، فحلّ عليها الضياع والخراب.
كل ما عرضه “حسون” كان ترغيبا حقيرا وترهيبا رذيلا لـ “عبد الباقي”، لينسى الماضي ويقبل بالواقع كما يرسمه “حسون”، وإلّا، ما ينتظره لا يختلف عمّا لاقاه غيره ممن لم يضعوا رؤوسهم في الرمل. ولذلك، في نهاية الليلة الثانية، وقد كانت ليلة غاية في الظلم والظلام، يصوّر الكاتب حالة الإنسان الفلسطيني وقد أطبقت عليه الدنيا، “وكأنّ الله خلق الشجر ليصنع منه الجلادون عصيا يضربونه بها!” (203). ولذلك، من جهة لا بدّ للفلسطيني مهما طال به الزمن، أن “يتعلم طرق جدران الخزّان” (203)، ومن جهة أخرى، من بقي في الأرض لا بدّ له، مهما اشتدّ عليه الظلم، أن يتشبّث بها، لأنّ “ألم البقاء في حيفا أرحم من دموع العودة إليها” (203). ومجرّد التذكير بـ “غسان كنفاني” هنا، هو سلاح ذو حدّين، فيه تحذير صارم للفلسطيني، فإمّا التشبّث بالوطن والنهوض من جديد، وإمّا الاستسلام للخراب واستمرار الضياع. ولذا يطالبه بعدم اليأس والاستسلام. ذلك لأنّ تغيير معالم القدس، وتغريب أهلها عنها وفيها، لا يُعطي للرواية المزيّفة، القوة الكافية لطمس القديم الأصيل. والماضي العريق لا بدّ أن يهزم الحاضر المزيّف. ولذلك، حتى إن صارت “الطالبية” “كوميموت”، و”القطمون” “غونين”، و”البقعة” “غيؤوليم”، و”القدس” “يروشلايم”، “لا بدّ في نهاية المطاف من أن تنتصر الرواية المقهورة المدحورة على الرواية المنتصرة” (145).
الخطّاب كُثر والعريس واحد
يُمهّد الكاتب لأحداث الليلة الثالثة بقصة يرويها عن “أطلس”، ذلك الإله الإغريقي العملاق الذي يحمل قبة السماء على كتفيه، عقابا له، لوقوفه مع من وقفوا ضدّ “زيوس” كبير الآلهة. هل الشعب الفلسطيني هو “أطلس” الذي حقّ عليه العقاب لوقوفه مع قضيته ومع من تفهّموا تلك القضية ودعموها، ولم يخضعوا لسلطة كبير الآلهة / النظام الإمبريالي؟ وهل التنكّر له في وطنه هو نتيجة خيانة “حادي العير” الذي آثر مصلحته على المهمة السامية التي انتدب لها: الحفاظ على السماء عالية ريثما يشفى “أطلس”، أو الحفاظ على فلسطين ريثما يعود إليها أهلها؟ أليس “حادي العير” هو “الإخوة” العرب الذين باعوا مبادئهم وباعوا فلسطين والفلسطينيين من أجل مصالحهم السياسية أو الاقتصادية؟ أليس توجّه “عبد الباقي” إلى الرواية الغريبة في الليلة الثالثة، هو نتيجة لهزيمة روايته في الليلة الثانية، وانقلاب ذوي القربى عليه وعليها؟ ذوو القربى الذين يتظاهرون أنهم معه يناصرون قضيته، ولكنهم في الحقيقة يعملون ضدّه وضدّها، ويعيقون تقدّمها الذي يتناقض مع مصالحهم. أحداث الليلة الثالثة، ولجوء الكاتب والراوي إلى الرواية الغريبة لدعم روايته، يُؤكّد ذلك.
ضياع “عبد الباقي” الذي ظلّ وفيا للقدس ولانتمائه الفلسطيني، يلتقي في الليلة الثالثة بضياع “ألفيي” الألماني الذي ظلّ هو أيضا وفيا للقدس. يتجسّد ضياع “عبد الباقي” في هذه الليلة بكونه مجرد مستمع يصغي لرواية “ألفيي”. وهي رواية لا تختلف في خيباتها وهزائمها وضياع أصحابها عن الرواية الفلسطينية. ولكنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا اختار حسين ياسين أن يُنهي روايته بمثل هذه الرواية، خاصة وأنها رواية لم يُكتب لها النجاح، وأصحابها أرغمهم المشروع الصهيوني على الجلاء عن القدس وفلسطين كلها بعد أن أحاقت بهم الهزائم من كل جانب، داخل فلسطين وخارجها؟
السبب في رأيي، له علاقة بما أورده الكاتب في الليلة الثانية، التي شهدت ضياع الفلسطيني روايته، حيث أكّد حسين ياسين أنّ القدس لها “عتق يمنحها سحرا عميقا” (166)، يجعلها تجذب الطامعين بها، لذلك تعاقبت عليها شعوب وتسميات وروايات لا حصر لها. ولكنّ من مرّوا عليها جميعا، رحلوا ولم يتركوا وراءهم إلّا “بقايا سيوف وقلاع وآلهة ودماء” (165) وأسماء جديدة. وآخر احتلال لها، قبل الوضع الراهن، كان على أيدي الأتراك والإنجليز. وفي فترة هؤلاء ظهر الوجود الألماني الذي لم يُخفِ نواياه الكولونيالية، ولكنه في الحقيقة، يختلف عن بقية الطامعين بها، إذ لم يقم على اغتصاب الأرض وتشريد أصاحبها العرب وإنكار وجودهم أو كونهم أصحاب الأرض الأصليين والشرعيين، بل قام على أساس تحكمه علاقات حسن الجوار والمساعدة والاحترام المتبادل. ولذلك كانت العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الطرفين تتّسم بكثير من التفاهم والانسجام. ولكنّ الأعناق التي تشرئبّ إلى السيطرة على فلسطين، بدءا بالمشروع الإمبريالي وانتهاء بالمشروع الصهيوني، قوّضت تلك العلاقات وقضت على الوجود الألماني، وعملت جاهدة لتقضي كليا على الوجود الفلسطيني، ولكنها لم تُفلح رغم ما ألحقته بهذا الوجود من دمار وخراب. ولكن، عبَر الأتراك كغيرهم، أما الإنجليز فقد خلّفوا وراءهم الوجود الصهيوني الذي يؤمن الكاتب وبطله أنه لن يختلف عن غيره مهما طال الزمن. فهو وجود زائل، بدليل أنّ روايته، رغم عسفها وجبروتها، لم تُخفِ اهتزازها وشعور أصحابها بالخوف. يظهر ذلك من تساؤل “قاطن الدار”: “متى تنتهي مخاوفنا؟ متى تنتهي حروبنا؟” (163)، وكذلك من روايته التي تهجس أنّ مصيرها إلى زوال رغم غموض الزمن، وأنّ أصحابها ليسوا أصحاب أرض ووطن. يؤكّد ذلك أيضا، شعوره وتساؤله: “من سيرث ما لم أرثه؟ نحن عابرون في هذا الوجود” (164).
كل وجود غريب مرّ على القدس وفلسطين، مهما كان حجمه ونواياه، اصطدم بالوجود الفلسطيني، صاحب الأرض والتاريخ والتراث. كل وجود غريب طامع بهما، مهما اشتدّ استبداده، واتّسع استيلاؤه على الأرض، لم يستطع القضاء على الوجود الفلسطيني فيهما. وذلك لأنّ الوجود الفلسطيني هو صاحب الأرض، وله عليها تاريخه وتراثه وحلمه المرتبط بها وبالتاريخ والتراث، الأمر الذي يفتقده الآخرون. وهنا يكمن الفرق بين الوجود الألماني الذي قُضِيَ عليه واقتلعت جذوره من فلسطين بسهولة. فهو رغم حبّه لفلسطين، لا يملك ما يملكه الفلسطيني. بالضبط كما قال “ألفيي” الألماني لـ “عبد الباقي” الفلسطيني: “نعم. لك ما ليس عندي، لك حلم تقبض عليه وأحلامي تقشّفت” (318). ولهذا يؤمن الراوي “عبد الباقي”، ومن خلفه الكاتب حسين ياسين، أنّ استمرار الفلسطيني بالقبض على حلمه، حتى لو كان عبر الذاكرة، كفيل بتغيير الوضع الراهن، وبأن يجعل الوجود الصهيوني، مهما طال به الزمن، عابرا كغيره لأنه يقوم على القوة التي تتغيّر، ولا يملك رابطا ثابتا يربطه بفلسطين، لأنّ ما صنعته الإمبريالية ومشروعها هو مجرد قشرة، وكذلك هو الوافد الجديد ومشروعه، لا علاقة أصيلة تربطهما بالقدس وفلسطين. فهو ليس من سلالة أبنائها وعائلاتهم، ولا يعرف أحياءها وشوارعها وبقولها وأشجارها وطيورها، فهو لم يذهب مرّة مع أمه إلى سوق الدباغة، أو إلى خان الزيت، أو سوق العطارين، ولا شمّ رائحة التوابل، ولا نقّل خطاه في طريق الآلام أو حارة النصارى، ولا شاهد طيورا صغيرة تحطّ في ساحة الأقصى ومؤمنين يغتسلون عند الميضأة (165). ومهما كثر المارّون تغيّرت الأسماء سيظلّ القدس هو اسمها الحقيقي. من هنا يشعر “قاطن الدار” بالخوف، وبأنه عابر في هذا الوجود.
من هنا أيضا، إذا كانت القدس هي تلك المرأة الجميلة إلى حدّ الإغواء، التي تمثلها “تانيا” أو “ضحى” أو ماري تريز”، أو كلهن مجتمعات، فلا عجب أن يبذل الرجال أموالهم ونفوسهم في سبيلها، يتناوبون على خِطبتها، ولكنّ الخطّاب كثر والعريس واحد. هو من كتب كتابها (تاريخها)، وبنى فيها، وحافظ على نسلها وتراثها، وأكل من بقولها، وشمّ روائحها. “هو شبل من أشبال فلسطين، سيأتي ويملأ بالبابونج والميرمية سلال الفلاحات المنحنيات على قصاعهن … سيُسمِع الطرشان أنّ هذه قدسي، ويقول للعميان ما أجملها القدس” (167).
البرزخ والذاكرة
رغم سعة هذه الدراسة، فهي لا تتسع لكل ما يُمكن قوله حول “ضحى”. لذا أخلص إلى تراه الرواية، من أنّ الحاضر برزخ. والبرزخ له طبع الوصل والفصل وله طبع المؤقّت. الحاضر برزخ متحوّل بين قطبين ثابتين: الماضي والمستقبل. الماضي ثابت بغيابه وحضوره في الذاكرة، والمستقبل ثابت على وعده بالحضور لا محالة. ولذلك، يرى حسين ياسين أنّ الواقع الراهن هو مجرد برزخ لا ثبات له. حاضر ينتزعه الماضي من أحضان المستقبل، فيلقيه المستقبل في أحضان الماضي. وقد خلق الكاتب بطله “عبد الباقي”، في الراهن، في البرزخ، وطالبه بالصمود والبقاء، لذلك أسماه “عبد الباقي”. وطالبه أن يكون بطلا في زمن اللابطولة، الزمن الذي يتلاشى فيه صوت الحقّ أمام “جعير” الباطل. فجاء “عبد الباقي” لابطلا، أضاع الماضي: القدس وتانيا”، وضاع هو في الحاضر، حيث هُزمت روايته وضاعت هويته. إنه يعيش في البرزخ الذي له خصوصية الوصل والفصل، ولكنه عاجز عن وصل الحاضر بالماضي، وعاجز أيضا عن فصل نفسه عن كليهما، ما أدّى إلى اغترابه وأسلمه للضياع والخراب. ولكن، رغم عجزه وخراب حاضره، ما زالت عنقه تشرئبّ إلى مستقبل يعود فيه للحقّ صوته وسطوته، وللوطن بهاؤه ولذة العيش فيه. ولأنّ “عبد الباقي” عاجز عن تحقيق ذلك، فهو يعقد الأمل على أشبال المستقبل، يغرس روايته المهزومة في ذاكرتهم، لأنها لا محالة ستورق في بساتين مستقبلهم.
(كابول – 5.3.2014)

[1]. حسين ياسين، كاتب فلسطيني شيوعي ولد في قرية “عرابة البطّوف” الجليلية، ترعرع في أزقتها الترابية وفيها تلقّى علومه الابتدائية، ثم انتقل للدراسة الثانوية في قرية “الرامة” الجليلية ثم في مدينة الناصرة. كان من الرعيل الأول الذي أرسله الحزب الشيوعي للدراسة في الاتحاد السوفياتي، حيث درس الاقتصاد الماركسي، وعاد عام 1973 إلى الوطن يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد السياسي. وفي العام نفسه التحق بجامعة حيفا فدرس المحاسبة. قبل ربع قرن عبر إلى القدس وهناك عمل مديرا ماليا في شركات التأمين الفلسطينية. أصدر حتى الآن:
· “مصابيح الدجى“، كتاب صدر عام 2006 عن دار “الأسوار” في عكا، يستعرض فيه الكاتب تاريخ “عرابة” وأهاليها وعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم الأصيل وتمسّكهم بالأرض. تفوح من هذا الكتاب رائحة القرية الفلسطينية بطوابينها وأزقّتها ومزابلها وبيادرها وحواكيرها وقطعان ماعزها وغنمها. والكتاب، كما يقول حسين ياسين نفسه: “مساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الفلسطينية”، كتبه اعترافا بفضل “عرابة” التي يقول عنها: “إذا ضقت ذرعا بمتاعب الدنيا تبقى “عرابة” ملاذي والصدر الحنون الذي أضع عليه رأسي المثقل بالهموم وألقي بجسمي المنهوك في أحضانها … سمعت رجالها وشيوخها يتحدثون ويتجادلون ويغضبون ويضحكون فشاركتهم في غضبهم وضحكهم، فكانوا لي “مصابيح الدجى”، قبل أن “تتهجّن وتتبندق” القرية الفلسطينية”.
· رواية “ضحى” الصادرة عام 2012، عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر” في بيروت. يقول حسين ياسين أنه كتبها للقدس التي يراها بطل روايته. وقد تُرجمت إلى اللغة الروسية وستصدر قريبا عن ناشر روسي تحت عنوان “ثلاث نساء في القدس”.
· وأخيرا، يقول حسين ياسين إنه يعمل الآن على كتابة رواية عن العرب الفلسطينيين الذين تطوعوا بين الأعوام 1936-1939 لمحاربة الفاشية في إسبانيا.
[2]. الأرقام بين قوسين تشير إلى الصفحات التي أخذ منها الاقتباس.
[3]. من ورقة بعنوان “دلالة المنفى في السيرة الذاتية العربية” شارك فيها الناقد د. فيصل درّاج في مهرجان الدوحة الثقافي السادس الذي أقيم في آذار عام 2007. لم أجد مصدرا ينشر الورقة كلها، فاقتبست من بعض ما جاء منها في مواقع الشبكة.
[4]. بحثت عن معاني مفردة “سواعير” جمع “ساعور” فوجدتها. وأكثر ما همّني منها: “النار والتنّور” لعلاقتها بالمعنى الذي أراده الكاتب للمفردة في روايته والذي لم أجد مصدرا يذكره، ربما لأنها مفردة يستعملها العامة في فلسطين أو بعض نواحيها. “سواعير” في الرواية (ص 61)، تعني ذكور الماعز التي بلغت سنّ الجماع، ولها سلوكها الخاص والمميّز الذي يُعبّر عن استعار الشهوة الجنسية عندها. وقد استعار الكاتب هذا المعنى للفتيان المراهقين الذين دخلوا مرحلة البلوغ الجنسي.
[5]. انظر الملاحظة رقم 3.
[6]. انظر الملاحظة رقم 3.