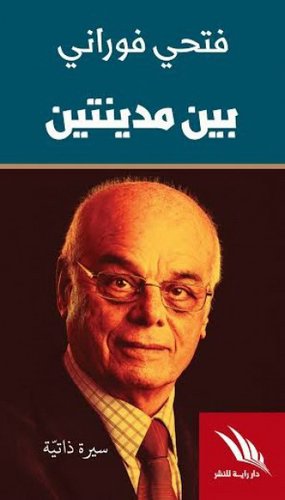قراءة في سيرته الذاتية، “بين مدينتين”!
قدّم الكاتب فتحي فوراني لسيرته بعتبة من عتبات النصّ، تحدّث فيها عن “بنت الكلب”، الجلطة الدماغية التي أقعدته فترة مضت. وأنا سأبد مقالي بالحديث مضطرا، عن عشيقها “ابن الكلب”، الموت، لأفعل ما فعله فتحي، لأركله كما ركلها. وأتمني له العمر العريض المديد، وأبارك له مولودته “بين مدينتين”، متمنيا أن تكون فاتحة جديدة لسلسلة طويلة من الإنتاج الإبداعي الذي عوّدنا عليه.
صديقي العزيز، الكاتب المبدع، فتحي فوراني، وأنا، وغيرنا من عباد الله الذين يُفكّرون بغيرهم، عندما نفكر بـ “ابن الكلب”، لا نخافه، ولكننا نعرف طبعه، فنخاف أن يفاجئنا في لحظة لا نكون فيها قد أتممنا واجباتنا نحو مجتمعنا وشعبنا والإنسانية، فنحتاط له بما نستطيع من إنتاج نعتقد أنّه من واجبنا أن نُرسّخه في ذاكرة أجيالنا القادمة، خاصة وأننا أشرفنا على زمن صارت الذكريات فيه لها دورها ونكهتها، رغم إحساسنا المستمرّ بشبابنا وتدفّق عواطفنا على الحياة. التفكير بـ “ابن الكلب”، يفتح شهيتنا على الحياة والنشاط والإبداع. ومن هذا المنطلق تأتي “بين مدينتين”، ليسدّ بها أخي العزيز، الشاب فتحي فوراني، الطريق على “أولاد الكلب” جميعا.
مُنظّر الرواية الكبير، ميخائيل باختين، في أبحاثه في مجال السرديّات والخطاب الروائي وجماليّاته، شكّلت روايةالسيرة الذاتية أحد مجالات اهتمامه، فذكر في أبحاثه ما يتوفر فيها من خصائصأساسية دقيقةتُميّزهاكفنّ سردي يقوم في النصّ على مركزية الأنا الكاتبة، بحيث لا نرى أو نسمع أو نفكر في شيء مما تسرده أو ترويه إلاَّ من منظور تلك الذات الفردية الخلاقة، منظور صاحب السيرة وراويها.
ومن هنا نجد أنّ كاتب السيرة الذاتية، صحيح أنّه مخيّر في منظوره، إلّا أنّه ليس مخيّرا في أمور أو عناصر أخرى كثيرة، مثل الأزمنة والأمكنة والشخصيات التي سيتولّى الحديث عنها في سيرته. صاحب السيرة يكتب بالأساس عن شخصية مفروضة عليه. ولكن، ما تتميّز به تلك الشخصية، هو أنّ الكاتب أو الراوي عادة يُحبّها ويطمئنّ لها، وإلّا لما كان من الممكن أن يكتب عنها، ولذلك فهو منحاز لها دائما. وهذه الشخصية عادة، كما اسلفت، ترتبط بمجموعة من العناصر التي يُفرض على الكاتب أن يتعامل معها، مثل الأزمنة والأماكن والأحداث، وتفرض عليه أحيانا، وإلى حدّ ما، شكل بنائها. ويقيّده أيضا أنّ كل تلك العناصر تنتمي إلى الماضي، الماضي القريب أو البعيد، ويكاد لا يكون رابطها بالحاضر والمستقبل إلّا فعل الكتابة الذي يُمثل الحاضر (حاضر الكتابة) ويرنو فيه الكاتب إلى المستقبل من خلال توثيق الذاكرة أو تخليدها، لما قد يكون لها من تأثير على شخصيات وأحداث أو حقب تاريخية، قادمة.
سيجموند فرويد، أبو علم النفس الحديث، عندما طُلِب منه أن يكتب سيرته الذاتية لقاء مبلغ كبير من المال، رفض قائلا “هذا الأمر مستحيل الحدوث”، لأنّه كما أضاف: “يتطلّب الكثير من التهوّر الطائش للبوح الفضائحي عن شخصي فضلا عن الآخرين”، وكلّنا نعرف أنّه صادق فيما قاله، إذ لا بد في حياة كلّ واحد منّا من فضائح صغيرة كانت أو كبيرة، من الصعب عليه أن يكشفها. أقول هذا الكلام لأبيّن مدى الصعوبة التي تواجه كاتب السيرة الذاتية. ولكنّ الكتاب المبدعين استطاعوا أن يجدوا مخرجا من هذه الإشكالية. خرجوا منها بواسطة الانتقائية، وقدرتهم على الاختيار داخل الأزمنة والأماكن، بمعنى تحديد الفترة المناسبة والبقعة المناسبة أيضا والحدث المناسب، اختيار الأحداث والشخصيات المناسبة التي تستحقّ أن تكون جزءا من عالم شخصية الأنا الراوية أو المروي عنها، العالم الذي تُريد أن تبنيه ليبقى في الذاكرة. ولذلك أجد أنّه ليس من السهل على شخص ما، سواء كان كاتبا مبدعا، أو شخصا عاديا، أن يُقرّر أن يكتب سيرته الذاتية إلّا إذا كانت لديه أهداف يرجوها من عمله ويسعى لتحقيقها، وهي في حالة فتحي فوراني، ليست أهدافا ذاتية فردية بقدر ما هي جمعية وطنية وإنسانية.
ومع ذلك، ورغم وجود الدوافع غير المباشرة للكتابة، التي يمكن أن نستشفها من الأهداف، إلّا أنّه لا بدّ من دافع مباشر يُرغم الكاتب على الكتابة، ما يعني أن كتابة السيرة الذاتية لا تختلف عن الحرب، لها أسبابها غير المباشرة، وهي الأهمّ، ولكنّ الحرب لا تندلع إلّا بتوفّر سبب مباشر سواء كان مقنعا أو لا. وكتابة السيرة الذاتية هي حرب نفسية تدور رحاها في ذات الأنا المتكلمة المبدعة. ولهذا يحتاج الكاتب أحيانا إلى “بنت الكلب”، كما أسماها كاتبنا، أو إلى ما يشبهها، فإن لم تأتِ هي إليه، فليس من المستبعد أو المستغرب أن يذهب هو إليها. بمعنى أنّ “بنت الكلب” هذه، قد تأتي اختيارا، وقد تأتي “فارعة دارعة” لا تستأذن أحدا، كما جاءت معذبة فتحي فوراني. ولكنّ الأهمّ، لا يحدث كثيرا أن تصطدم “بنت الكلب” بشخص قوي يعرف من أين تؤكل الكتف، مثل فتحي فوراني، يتلقّى ضربتها الأولى فلا تقصم ظهره، يمتصّها ويستعيد توازنه، يقف على رجليه، يركلها ويتصدّى لها بطرق شتى، قد تكون الكتابة أهمّها. ولذلك، ليس عبثا نجده يمنح “بنت الكلب” بابي روايته، الأمامي والخلفي، الفاتحة والخاتمة، الأمامي دخلته قسرا فصارت، أراد أو لم يُرد، جزءا من المشهد لا بدّ من التعامل معه، لذلك بعد دخولها الغادر، كما دخلت واقترفت جريمتها، وبعد تصدّي فتحي لها، واستعادة قوته وتوازنه، فتح الباب الخلفي وركلها ولسان حاله يقول: “يا ابنة الكلب! دخلت ككلب يُلوّح بذيله ويرجو النصر، والآن أخرجي كما دخلت، ولكن ككلب ذليل لفّ ذيله بين ساقيه بعد أن ركله صاحبه. اخرجي من الباب الخلفي، فأنت يا “بنت الكلب” غير مرغوب بك هنا، ولن نقبل بعودتك.
أما من الناحية الفنية، فالحديث عن “بنت الكلب” في بداية الرواية وخاتمتها، فهو توظيف للأسلوب الدائري الذي يشي بأنّ الكاتب أدرك أنّ “بنت الكلب”، تُريد هي أن تكون من يُغلق الدائرة، فركلها فتحي فوراني ليغلق بركلتها دائرة ويفتح دائرة أخرى جديدة لا مكان فيها لـ “بنات الكلب”. كما أنّ الحديث عن “بنت الكلب” قبل الدخول إلى النصّ السيري أو الروائي، هو استثمار مقنع وموفّق لعتبة من عتبات النصّ، فقد استطاع الكاتب المبدع، فتحي فوراني، شدّ القارئ به إلى القراءة، والقارئ بالتأكيد لم يندم، فالوجبة كانت تستحق: جميلة وجذابة وشهيّة منظرا، وطيبة لذيذة طعما ومذاقا، ودسمة صحة وعافية، جسدا وفكرا.
وعلى ما تقدم، يمكننا النظر إلى سيرة فتحي فوراني على أنّها الضربة الذكية الصائبة، الركلة التي وجّهها لـ “أولاد الكلب” جميعا. وحين نتلمّس إبداعه، سنجد أنّ “بنت الكلب” لا ترمز فقط إلى تلك الجلطة التي ضربت دماغ فتحي فوراني فضربها وكال لها الصاع صاعين، وإنّما ترمز لكل العقبات التي واجهها فتحي فوراني في حياته، التي هي جزء حيّ من حياة مجتمعه العربي في هذا البلاد، وجزء حيّ أيضا من حياة شعبه الفلسطيني وأمتّه العربية. وبهذا العناق يجد أهميّة حياته وسيرته وجدوى إبداعه.
وإذا كان الأمر محفوفا بصعوبة كبيرة بالنسبة للكاتب، فهو لا يقلّ صعوبة بالنسبة للقارئ عامّة وللناقد الموضوعي خاصة، وربما لكاتب هذه السطور بشكل شخصي، ذلك لأنني لا أقف في مواجهة النصّ فقط، ولا أكتب عن نصّ أبدعه إنسان لا أعرفه، أو أعرفه معرفة قليلة أو سطحية، بل أكتب عن أخ وصديق أعرفه وأعتزّ بصداقته منذ عقود. وأكثر من ذلك، أردنا أم لم نرد، أنا وهو، أحسّ بنفسي امتدادا له وجزءا لا يتجزّأ من سيرته الذاتية. وهذا بحدّ ذاته يفرض عليّ صعوبة عند الكتابة وتوخّي الموضوعية. ذلك إلى جانب أنّه يروي في سيرته حيوات أخرى لأناس عاشوا معنا وعشنا معهم، آباء وأمّهات، أخوة وأصدقاء، استطاعت “ابن الكلب”، أو إحدى أخواتها، أن تطوي صفحة أجساد بعضهم، ولكنّها لم تتمكن من أرواحهم وذاكرتهم التي ظلّت تعيش معنا وفينا. والبعض الآخر منهم، أمدّ الله في أعمارهم، إخوة لنا من المبدعين والناس العاديين، نحن جزء لا يتجزّأ منهم، ما زلنا نتقاسم معهم اللقمة والكلمة والكتاب واللقاء الأخوي العادي، والنضال السياسي، والأدبي والثقافي عامة، على المستوى الوطني والإنساني. ما زلنا نحمل معهم هموم شعبنا، بقدر ما يستطيع كل منا. كل ذلك يجعل الكتابة صعبة، ولكن فتحي فوراني ومولودته الجديدة، يستحقّان المغامرة.
يكتب فتحي فوراني سيرة عبد الله الذاتية، فمن هو هذا العبد الله؟ هل هو فتحي فوراني؟ إذن لماذا عبد الله؟ الأمر له علاقة وثيقة بفنية الرواية وبمضامينها. فمن الناحية الفنية، يميل كاتب السيرة إلى كتابة سيرته في سنّ يتمتع فيها بالنضج، ولذلك نجد من الصعب أن يضع قياد سيرته وإبداعه بيدي طفل أو صبي، لذلك وظّف الراوي كلّي المعرفة، الراوي بضمير الغائب، كما فعل طه حسين في “أيامه” مع صبيه الذي لا يستطيع أن يتكلم عن نفسه بعقلية ناضجة، وهذا هو حال فتحي فوراني مع عبد الله، فتحي الصغير، الطفل أو الصبي الذي لا يستطيع أن يتحدّث عن نفسه بموضوعية، أو بانتقائية تحتاجها رواية السيرة. واختيار الكاتب للراوي العليم كلّي المعرفة مكّنه أيضا من أن يجوب الضمائر كلّها، فتجده في بعض الصفحات يتنقّل بين الضمائر بسلاسة تُعطي للكتابة رونقها وللأبداع قيمته. تجد الراوي كلّي المعرفة، وكدليل على ثقته بعبد الله، خاصة بعد نضوجه، يترك السرد بضمير الغائب، ويُقدّم منصّة الكلام له، لعبد الله، ليسرد بضمير المتكلم. وأحيانا أخرى تجده يختار من يخاطبه، بضمير المخاطب، “أنت”، محاولا بذلك الاقتراب من عالمه والغوص في ذاته وطبقات نفسه وشعوره. ولا بدّ أنّكم تعرفون أنّ تعدّد الأصوات في الرواية، إلى جانب أنّه تقنية فنيّة تضفي الكثير على جماليتها، إلّا أنّه أيضا، تعبير عن موقف أيديولوجي، فالتواضع ونبذ الأنا لدى فتحي فوراني ليس مجرد تزيّن ليبهرنا، وإنما هو موقف أيديولوجي يُعبّر عن إيمانه بالديمقراطية والتعدّدية الفكرية والسياسية، وغيرها. ففي العالم الذي يبنيه فتحي، إخوة له، قد يتفق معهم وقد يختلف ولكنه يؤمن بحقّهم ودورهم بالضبط كما يؤمن بحقّه ودوره، إن لم يكن أكثر. يؤكّد ذلك الكثرة الكاثرة من الشخصيات التي ينتقيها فتحي فوراني، يعطيها دورها الذي يليق بها، ويتحدّث عنها في الرواية أكثر مما يتحدّث عن نفسه، بتحمّس وانحياز، كثيرا ما يفوق تحمّسه وانحيازه لعبد الله.
أما من حيث المضمون فالمفروض أنّ عبد الله هو فتحي فوراني، ولكن، إذا تعمقنا الرواية وبُعْدَ الكاتب عن الذاتية الفردية، ونبذه لاسمه واختياره لعبد الله، نجد أنّ عبد الله قد لا يكون فتحي، ولولا كون الرواية سيرة ذاتية لجزمنا بذلك، وبأنّه رمز لأي فلسطيني تنطوي حياته على صفحات مشرقة كصفحات حياة فتحي فوراني التي نتمنى لها إلّا تنطوي. ولكنّه تواضعُ فتحي الذي يُفكّر بغيره، وبُعده عن النزعة الذاتية الفردية، وعن النرجسية التي تقتل الكثير من كتّابنا، واعترافه أيضا بدور غيره الذي يُضاهي دوره ويزيد. وإن لم يكن الأمر كذلك، فما معنى هذا الانحياز لهذا العدد الكبير من الشخصيات الأدبية والثقافية وحتى العادية البسيطة؟
قيود المكان تفرض نفسها على الكاتب، ولكنها لا تمنعه من التحليق في أرض فلسطين كلّها، ببحرها وسمائها، والانطلاق منها إلى خارجها إذا اقتضت الضرورة. وكذلك الأزمنة، وخاصة زمن النكبة وما تلاه من أزمنة ناكبة ومنكوبة. ولهذا نجد لدي الكاتب قدرة عجيبة على انتقاء الأزمنة والأمكنة والأحداث والشخصيات. ما يؤكّد وعيه بالكائن والذي كان، وإدراكه لحاجتنا إلى نوعية ما يجب أن يكون. فهو لا يرهق المتلقّي بماضيه إلّا لأنّه يعرف أنّ فيه ما يُحبّ المتلقّي الناضج فكريا وثقافيا ووطنيا، أن يتعرّف عليه، كجزء ناضج من نسيج تاريخي واجتماعي وأدبي وثقافي ووطني، قد تكون له مكانته في ضبط هذا النسيج لاحقا أو مستقبلا.
ومما يُؤكّد انعدام النزعة الذاتية الفردية لدى فتحي أيضا، وأنّ الذات الفردية الراوية ما هي إلّا صورة عن الذات الجمعية، هو أنّ فتحي فوراني لم يكتب عن كثير من أحواله الشخصية، عن زواجه مثلا، ولا عن أسرته التي كونها، وعندما ذكر نجله، نزار، فقد وظّف شخصيته لمعالجة قضية جمعية تهمّنا جميعا، قضية لغتنا وانتمائنا، لغتنا العربية وما تتعرّض له من عدوان شرس في المدارس وفي كتب التعليم ومناهجه، لأنّ نظرة واحدة إلى تلك الكتب والمناهج، كافية لأن نرى أنّ القيّمين على هذه الكتب وهذه المناهج هم من أعداء لغتنا العربية وشعبها، والمؤسف أنّ هؤلاء يتكئون في عداوتهم لها وله، على بعض أبنائها الذين يدّعون حبّها ولكنّهم في الحقيقة جيش من المرتزقة المأجورين والمنتفعين.
ومن هنا، ومن منطلق الوعي بالحاجة الجمعية، وضرورة الحديث عن الأنا أو الذات الراوية والمروي عنها، التي لا تزيد عن كونها جزءا ينخرط في الذات الجمعية، يُسلط فتحي فوراني الضوء على جوانب معينة من حياته، تلك التي لها علاقة بالذات الجمعية، بالمجتمع والشعب بكافّة دوائره. يُسلّط الضوء على عدّة مستويات ويُركز من خلالها على عدد من الثيمات، تقف في مقدّمتها ثيمة النكبة والتشريد وما جرّه ذلك على فتحي وعائلة فتحي، والأهمّ، على شعب فتحي، من منفى واغتراب.
ثلاثة فصول في الرواية، هي ثلاث مراحل حاسمة في حياة عبد الله. وهي تعبير عن الذات المتشظية في الزمان والمكان، سواء كانت ذات الكاتب نفسه، أو الذات الفلسطينية عامة. هذه الذات تتشظّي في المنفييْن: الداخلي والخارجي، زمانا ومكانا. فإذا كان أشدّ ما في النكبة هو ترك الوطن إلى المنافي خارجه، ذلك لا يعني أنّ الإنسان، كائنا من كان، سيقبل بمنفى أصغر، مثل الانتقال القسري داخل الوطن، من الناصرة إلى حيفا في حالة عبد الله. فحتى هذا المنفى الصغير، يُذكّر بالكبير ويُكرّسه. وفي كلّ الأحوال، عندما تطول فترة المنفى يجد المنفيّ نفسه مضطرّا للتأقلم مع مكوّنات المنفى الجديد، حتى لو كان غريبا، فما بالك بحيفا، عروس البحر ومسقط رأس عبد الله.
الفصل الأول أو المرحلة الأولى، “من اليرموك إلى “حارة الصواوين”، تجود بهما الذاكرة، وعودة الأحباب من الغربة إلى أرض الوطن، ولكنّها عودة مؤقّتة، كزائرين، الأمر الذي يُثير نوستالجيا يألفها المنفي في حنينه إلى زمن مضى، ويُعمّق الشعور بالغربة والاغتراب، ولذلك في هذه المرحلة تسيطر ثيمة الغربة والاغتراب التي يفرضها المنفى، ويفتح بها الشهية على الذكريات والبحث عن الخلاص، فتأتي الكتابة.
في الفصل الثاني أو المرحلة الثانية، “من صفد إلى الناصرة”، تسيطر ثيمة النكبة والتشرّد والمنفى، حيث يغلب على المرحلة، المشهد الفلسطيني بما فيه من حزن وتشرّد، ولكن من عزم وصمود أيضا. وأقول المشهد لأنّ فتحي فوراني بلغته البسيطة والسلسة التي ترقى بجماليتها إلى مستوى إبداع الحدث، يجعلنا نشعر كأننا نعيش اللحظة المروي عنها رغم بعد زمانها. وأقول العزم والصمود، لأنّ الحياة الاجتماعية التي ينقلها الكاتب، رغم بساطتها وهول مآسيها، فيها من الحميمية والألفة وحسن الجوار والعشرة الحميمية الطيّبة، والتعاضد والتكافل ما يجعل المنكوب يصمد ويتحدّى. وهذا هو هدف سام من أهداف فتحي فوراني الإنسانية والوطنية، التي يُريد أن يُرسّخها في ذاكرة أجيالنا، لإبعادها عمّا يُحاول أعداء شعبنا دفعها إليه: اليأس والنسيان. ولهذا السبب أيضا، نجده يعطي للمرحلة الثانية مساحة أكبر من الأولى، فإذا كانت النكبة قاسية والتشرّد بعدها لا يُحتمل، فإنّه لا يريد لهذ المرحلة من التشرّد والغربة أن تطول، يريدها أن تنتهي النهاية المنشودة بالعودة الدائمة إلى الفردوس المشتهى، ويرفض بها تلك النهاية المؤقّتة رغم حاجتنا إليها أحيانا.
وإذا لاحظ القارئ أنني لا أختار أمثلة من الرواية تدعم أقوالي، فإنّما يرجع ذلك إلى سببين: الأول، دفع القارئ لقراءتها إن لم يفعل بعد، والثاني، لأنّ المراحل التي قطعها عبد الله هي ليست شخصية بالضرورة، بل هي رمز للمراحل التي قطعها كل واحد منا تقريبا، لا تختلف إلّا باختلاف أسماء الأشخاص، وأسماء الأماكن العينية في فلسطين. فأنا من ميعار المهجرة، لم يسقط رأسي فيها ولكنّ أبي الذي تشرّد مع أمي وأخي الأكبر منها، عاش عامين في المنفى الخارجي، في مخيمات لبنان، وعاد إلى أرض الوطن متسللا ليستقرّ في كابول، منفاه ومنفاي الحبيب، بعد تشرّد في بقاع كثيرة من الوطن. فإذا وجد عبد الله في بعض أهل حيفا أهله، فحيفا وكابول كفلسطين كلّها، كلّها أهلي وأهله، أهلنا. ولذلك لا أعتقد أنّ هذه الصورة التي يرسمها فتحي هي صورة شخصية، بل فلسطينية جمعية. وفتحي فوراني يُدرك ذلك جيّدا، ما يعني أن كل شعبنا مرّ بشكل او بآخر بهذه المراحل التي مر بها عبد الله وأمّه وأبيه فذكرها فتحي فوراني ليس كحدث شخصي فقط، وإنما كحدث وهمّ جمعي. ولذلك، وخاصة بسبب بُعد فتحي فوراني عن الذاتية الفردية، يمكننا رؤية عبد الله وغيره من شخوص الرواية رموزا فلسطينية، أبعد ما تكون عن الدلالة الشخصية الضيّقة.
وأكثر من ذلك، فإنّ القارئ قد يظنّ لأول وهلة أنّ فتحي فوراني على علاقة سيئة بالمرأة ولا يقدّر دورها كحبيبة أو زوجة أو كليهما، وقد يتساءل عندما يُفاجأ بأنّ الكاتب لم يتحدّث في الرواية عن أيّة علاقة كهذه. ولكنّها أحوال شخصية أستبعدها الكاتب لكيلا تقف حجر عثرة أمام الذات الجمعية. وأنا على ثقة أنّ القارئ الواعي سيتراجع عن موقفه عندما يرجع إلى الشخصيات النسائية الكثيرة التي ذكرها الكاتب: الأم والجارة، والجارة التي هي بمثابة أم أخرى، وما أكثر هؤلاء الجارات في سيرته وسيرة غيره من أبناء الوطن المخلصين. كذلك الأمر في ذكره لطالباته، وللشاعرة الفلسطينية الكبيرة، فدوى طوقان، والاحتفاء بها في حيفا. سوف يتغيّر موقف القارئ ويفهم أنّ المنبر هنا ليس ذاتيا فرديا، وإنّما هو ذاتي جمعي، وفتحي فوراني يحتفي بعبد الله كجزء من هذه الذاتية الجمعية، ويجده لا يُساوي شيئا بدونها.
ولكي يضمن فتحي فوراني تحقّق أهدافه المرجوة، يُعطي للفصل الثالث أو للمرحلة الثالثة، المساحة الأوسع في الرواية، وفيها يُطلعنا على المشهدين الأدبي والثقافي عامة، اللذين اجترحهما فتحي ورفاقه وانتزعاهما من مخالب الذئب ودعاة الخراب والنسيان والعدمية القومية.
ما يُقدّمه الكاتب لنا في الفصل الثالث، من مشهد أدبي وثقافي فلسطيني خالص، يسعى به على ترسيخ الثوابت في الذاكرة الفلسطينية عامة، وفي ذاكرة أجيالنا هنا بشكل خاص، ذاكرة الفلسطيني الذي بقي منزرعا في أرضه رغم ما مرّ عليه من أهوال.
في الفصل الثالث أو المرحلة الثالثة، “من مدينة البشارة إلى عروس الكرمل”، يتألق فتحي فوراني المتسلّح بالأمل. لذلك لم يقل من “من مدينة الناصرة إلى مدينة حيفا”، رغم الموسيقى العذبة للاسمين، وإنما اختار لهذه المرحلة عنوانا ينطوي عل كثير من الحبّ والتفاؤل، “البشارة والعروس”، قرنهما ضمنا بالمدينتين. وتألّق في هذه المرحلة أيضا، فتحي الإنسان، الإنسان المتواضع البعيد كل البعد عن الذاتية الفردية، الأنسان الذي يحبّ ويحترم الآخر، ويُقدّره حسب فكره وإنتاجه ودوره وتأثيره في وعي مجتمعه وشعبه، لذلك لا يُضير فتحي أن يُقدّم هذا الغير على نفسه، ففي هذا الفصل من الرواية، لا نكاد نعثر على عبد الله، أو فتحي فوراني صاحب السيرة وراويها، إلا كرابط بين رموز وطنية، أدبية وثقافية، تركت بصمتها في ذاكرته وذاكرة الشعب والوطن. يظهر ذلك جليّا عندما يٌفرد مساحة واسعة للحديث عن غيره من أصدقائه المثقّفين والمبدعين. فهو مثلا يُفرد صفحات واسعة لذكرياته مع صديق عمره الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي سحرته حيفا فخلّدها، خطفها من البحر وجعلها عروس شعره.
وفي الختام، وتأكيدا لكل ما تقدّم، يقول الناقد والمفكّر الفلسطيني، فيصل درّاج، في حديث له عن السيرة الذاتية والمنفى، إنّها لا تأتي إلّا بعد أن يكون الإنسان مؤمناً بأنّ لا جديد سيأتيه، مشيراً إلى أنّ كتابة السيرة لا تكون إلّا عن زمن مضى إلى غير رجعة، وتتضمن غالبا، موضوعات على شاكلة النضال السياسي والحّب والمنفى، وهذا واضح في سيرة فتحي فوراني، وإن كنت أجزم أنّه يؤمن أنّ جديدا إن لم يأته هو فسوف يأتي من يكتب لهم. ومن أهمّ الملاحظات التي أوردها درّاج حول “رواية المنفى”، وسيرة فتحي فوراني يُمكن أدراجها في هذا المجال، هي أنّها غالبا ما تغيّب الاحتفال بالزمن الذاتي، الشخصي، الحميمي للمنفيّين في سِيَرهم، فقد وجد درّاجأنّهذهالفترة، فترة الزمنالذاتي، (يقصد الذاتي الفردي) تعتبر بمثابة الزمن المهمّشفيالسيرةالذاتيةالعربية، لأسباب عديدة تتعلق غالبا بالرقابة الذاتية.ولهذا، نجد أنّ الزمن الحميمي، الزمن الذاتي الفردي، يبدو زمناً حقيراً ومهمّشا، لذلك تتجه السيرة وبشكل مباشر إلى زمن الجماعة التي تحتلّ في السيرة مكانة محترمة وموقّرة، على حدّ تعبير درّاج. وهذا ما فعله وأكّده فتحي فوراني في سيرته التي تصلح أن تكون سيرة فلسطينية عامة، وبكل المقاييس: التاريخية والوطنية، والأدبية والثقافية.