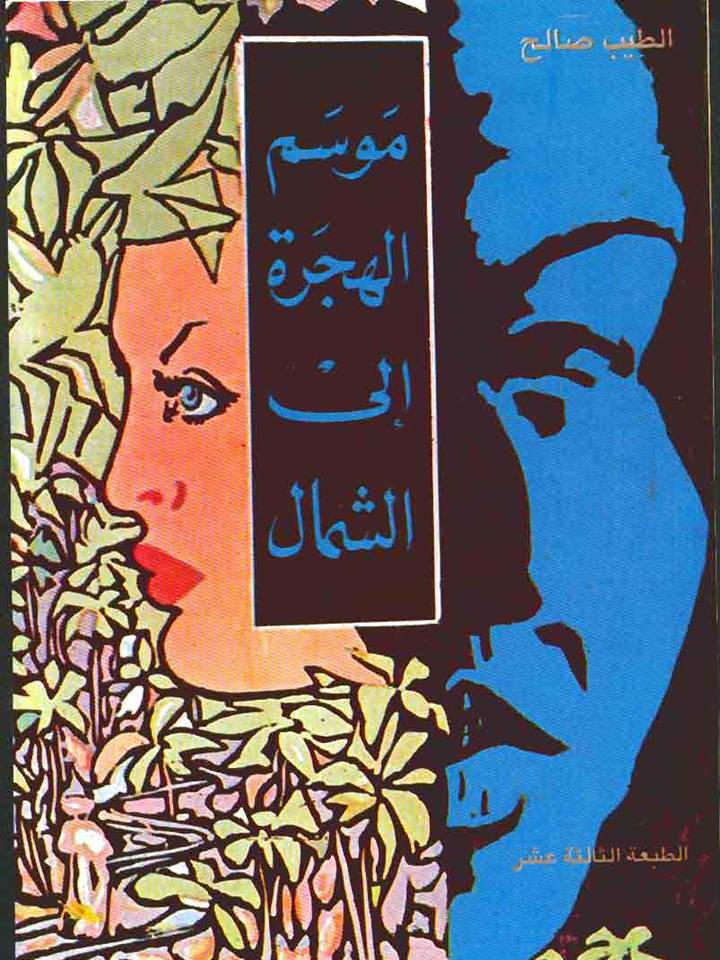مقدمة
عام وبضعة أشهر مضى من الزمن على رحيل الكاتب الكبير الطيب صالح، ولكن أكثر من أربعين عاما مضت على صدور رائعته “موسم الهجرة إلى الشمال”. وفي رأيي لم يخطئ أولئك الذين نعتوه بعبقري الرواية العربية، فقد قفز من خلال هذه الرواية، الثانية بين أعماله الروائية، إلى مستوى العباقرة وإلى العالمية في آن معا. فعلى مدى أكثر من أربعين عاما، أكسبته هذه الرواية شهرة اخترقت حدود العالم العربي إلى العالم كله وبلغاته المختلفة. وهي تمتاز، كما يجمع كل النقاد، بتجسيد ثنائية التقاليد الشرقية والغربية واعتماد صورة البطل الإشكالي الملتبس على خلاف صورته الواضحة الشائعة في أعمال روائية كثيرة قبله. وقد وصفتها، وبحقّ، الاكاديمية العربية في دمشق عام 2001 بأنها أهم رواية عربية في القرن العشرين. فقد ظلّ بطلها، مصطفى سعيد، يتحدّى كل أبطال الروايات العربية التي عالجت الازمة الحضارية بين الشرق والغرب. وعليه، فإنه يحقّ القول أنّ الطيب صالح أظهر فيها فهما شموليا لمجتمعنا العربي وحاول أن يطرح في روايته رؤية ورؤيا شموليتين، تاريخيا، اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا، لمشاكل هذا المجتمع، على مستوى الفرد والمجتمع كله، ومجمل علاقاته مع ذاته ومع الآخر. مع ذاته في مواجهة جيوش الظلام والتخلف في المجتمع العربي وكيفية الخلاص منها. ومع الآخر، مع الغرب الاستعماري وضرورة مواجهته ليتسنى له العودة إلى ذاته ومواجهة مشاكلها.
ويقول د. جابر عصفور، (2009). “لا أزال أذكر مشاعر الإعجاب الغامرة التي انتابتني عندما قرأت (موسم الهجرة إلى الشمال) للمرة الأولى، فقد كانت حدثًا استثنائيًا في تاريخ الرواية العربية، وانطلاقًا في آفاق جسورة لإنطاق المسكوت عنه في الثقافة العربية التي لا تزال تقليدية في مجملها، فموسم الهجرة رواية بعيدة عن التقليد أو التصنع أو التزمت أو الخوف”. ويتابع عصفور: “لقد طرحت (رواية موسم الهجرة) قضايا الهوية والعلاقة بالآخر والأصالة والمعاصرة ومكانة المرأة”.
وإذا كان ما يهمنا هنا، في هذه الدراسة، هو موضوع الآخر، ففي رأيي، إنّ هذا الكاتب العربي السوداني، في روايته “موسم الهجرة إلى الشمال” أظهر عبقرية فائقة في فهم الـ “أنا” في مفهومها الفردي وفي مفهومها الجمعي، الـ “نحن” مقابل الـ “هو / الآخر كذلك في مفهومه الفردي والجمعي. أي أنّ هذا الفهم الذي أظهره الطيب صالح لم يكن على مستوى الأنا / الفرد / الطيب صالح أو بطله “مصطفى سعيد” بطل روايته “موسم الهجرة إلى الشمال” فحسب، في مقابل الآخر أي الشخصيات الأخرى في الرواية بما تمثله كل شخصية على مستواها الشخصي، وإنما كان الأنا الجمعي / السودانيين / الأفارقة / الشرق العربي / العالم الثالث / المستعمَر في مقابل الآخر / الغرب / الامبريالي / المستعمِر. ولكن يجب إلا تنقصنا النظرة الموضوعية إلى الأمور لنرى أن الآخر ليس هو الغرب / الامبريالي / المستعمِر وحده، وإنما الآخر يمكن أن يكون جزءا من الذات، يظهر أو يختفي في الأنا الفردي أو الجمعي، الـ “نحن” / أي جزءا من المجتمع الذي ينتمي إليه الطيب صالح أو بطل روايته مصطفى سعيد / المجتمع السوداني / المجتمع العربي / الشرقي / أو أي مجتمع في العالم الثالث. ذلك لأن شخصيات الرواية بريطانية / غربية كانت، أو سودانية / أفريقية / شرقية / عربية فإنها جميعا شخصيات رمزية لها دلالاتها التي لا بد من فهمها وكشف أسرارها لكي يتسنى لنا الفهم الصحيح لقضية الأنا والآخر في هذه الرواية، “موسم الهجرة إلى الشمال”. وفي رأيي فإنّ الطيب صالح قد رسم بإحكام كل شخصيات روايته، وفي مقدمتها “مصطفى سعيد” لكي تؤدي الدور الذي رسمت من أجله، وهو دور يبرز الأنا أو الآخر بالمفهوم الذي سنحاول الوصول إليه في فصول هذه الدراسة.
هذه الدراسة، وبعد هذه المقدمة، ستطرح، في ثلاثة فصول، ثلاثة أسئلة في غاية الأهمية:
1. “من هو الأنا ومن هو الآخر؟” وذلك على مستوى التعريف العام للأنا وللآخر.
2. “من هو الأنا وماذا يمثل في “موسم الهجرة إلى الشمال”؟ تتبعا للأنا مقابل الآخر في العالمين الشرقي والغربي.
3. “من هو الآخر وماذا يمثل في “موسم الهجرة إلى الشمال”؟” تتبعا لصورة الآخر الذي يناصب الأنا العداء ليس في الغرب فقط وإنما في الشرق أيضا.
الإجابة عن الأسئلة المذكورة ستعبّر عن فهمنا لهذه القضية، ولكن يظلّ فهمنا لها رأيا أو محاولة من الممكن أن تصيب ومن الممكن إلّا. وفي الحالين يبقى هذا الرأي أو تلك المحاولة قابلين للنقاش في طرحهما للأسئلة وفي محاولة الإجابة عليها كذلك. بعد طرح الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها لا بد لنا من خلاصة نستعرض فيها بإيجاز ما قد توصلنا إليه من نتائج لعلها تضيف شيئا إلى الكثير الذي قيل في هذه الرواية، سواء في القضية التي نحن بصددها أو في غيرها من القضايا التي تعالجها وهي كثيرة.
من هو الأنا ومن هو الآخر؟
سأحاول هنا طرح بعض من مفاهيم “الآخر” سواء كان ذلك على المستوى العام أو المستوى الخاص. ومما تقدّم يتضح أنّ لـ “الآخر” مفاهيم كثيرة، وعلينا أن نختار من هذه المفاهيم ما يعنينا خاصة عندما نريد دراسة قضية بعينها كالقضية التي نحن بصددها في هذا البحث.
على المستوى العام، قبل تحديد ما يعنيه مصطلح “الآخر” (The Other)، لا بد من تحديد ما يعنيه مصطلح “الأنا” (Ego)، وقد نحتاج في مكان ما من هذا البحث إلى ما جاء به فرويد عن مكونات الشخصية: الهو، الأنا، والأنا الأعلى، حيث الأنا هو ما يضبط طاقات الـ “هو”، ويوجهها نحو أكبر إشباع بقدر ما تسمح به ظروف الحياة، ودون أن يهدم نفسه، ويحطمها، لأنّ خطورة الـ “هو” أنه يمكن أن يحطم نفسه إذا تـُرك لأساليبه الخاصة، فهو بحاجة إلى الأنا لضبط طاقته حتى لا يحطم نفسه، والأنا تتبع مبدأ الواقع. أما الـ “هو” فهو ذلك الجزء من النفس الذي يحتوي كل ما هو موروث، أو غريزي، كما يحتوي على العمليات العقلية المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن الحياة النفسية، كما يزوّد العمليات التي يقوم بها النظامان الآخران (الأنا والأنا الأعلى) بطاقتهما، والـ “هو” يخضع لمبدأ اللذة ولا يقوم بأيّ شيء آخر. (عبد الله، 1995، ص، 21). وما أرمي إليه هنا هو أنّ الـ “هو” يمكن أن يكون جزءا من الشخصية ذاتها، وهو ليس مبحثنا على مستوى شخصية الفرد ولكن، كما ذكرت، يمكن أن نلجأ إليه في دعم بعض ما سنورده لاحقا باعتبار المجتمع الواحد ذاتا لها مكوناتها المشابهة لذات الفرد.
الأنا الذي يعنينا هنا هو الذات، أو الشخصية بكليتها التي هي نقيض للآخر سواء كان ذلك بمفهومها الفردي (الأنا) أو الجمعي (الـ “نحن”) الذي يمثله “الأنا” على المستوى الشخصي أو القومي، الفكري، الثقافي، الاجتماعي، السياسي أو الاقتصادي.
أما الآخر فهو هو الضد، النقيض، المختلف، الغريب، اللامنتمي أو العدو. إذن هو ضد الأنا أو النقيض للأنا، أو المختلف عن الأنا، أو الغريب بمفهوم ما عن الأنا، أو اللامنتمي بشكل من الأشكال للأنا، أو عدو الأنا.
وفي جميع هذه الأحوال، الآخر له مفهومه الفردي أو الجمعي، الجمعي الذي تمثله المجموعة فعلا أو يمثله الفرد الذي يحمل صفات المجموعة ويتكون من مكوناتها، وذلك على المستويات السابق ذكرها: المستوى الشخصي أو القومي، الفكري، الثقافي، الاجتماعي، السياسي أو الاقتصادي. إذن، ما يعنينا هنا ويخدم بحثنا هو الآخر الجمعي، في المجموعة أو خارج المجموعة. الآخر المختلف فكريا، ثقافيا، اجتماعيا، سياسيا واقتصاديا.
إذن الآخر هو غير الأنا، ومثل هذه الغيرية تقتضي أن تنقسم الإنسانية إلى مجموعتين: إحداهما هي التي تملك القواعد والمعايير والقيم ذات القيمة والتي يجب أن تسود، وتملك كذلك الهوية ذات القيمة، بينما الأخرى التي تُعرف أو تُعرّف بعيوبها ونواقصها وتكون عرضة للتمييز (العنصري مثلا) على أساس العرق واللون وغيرهما، فينظر إلى أفرادها على أنهم برابرة متوحّشون مما يحط من قيمتهم وما يعطي للآخر، القوي، المستعلي، “الحقّ” في السيطرة عليهم أو إبادتهم أو دفعهم إلى هامش الانسانية. وفي هذه الحالة تشكل المجموعات الغربية الكولونيالية نموذجا للطرف القادر على فرض مقولاته (الطبقية) على الآخر (وهو من منظورها لا حقوق له، ولا يمكن الاعتراف به كندّ أو شريك، والعلاقة معه تبنى على أساس تصادمي بغيته فرض الهيمنة عليه وقبوله لها وتقديمه فروض الطاعة). وعليه، فأن الفرد لا بد أن ينتمي إلى إحدى هاتين المجموعتين: هم ونحن. وكل من هو خارج المجموعة (الأولى) ينظر إليه كملتحم مع المجموعة الأخرى خارج الأولى وذلك نتيجة لمعارضته لما ولمن هم فيها أو لفقدانه الهوية ضمنها. (Staszak, 2008, pp. 1-2).
من الواضح وبناء على ما تقدّم فإنّ النظرة إلى الآخر في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” تنضوي تحت هذا المفهوم، خاصة عندما ننظر إلى الصدام بين الشرق والغرب متمثلا في الصدام بين الشخصيات الغربية في الرواية من جهة، وبين مصطفي سعيد (الشرق) من جهة أخرى.
ولكن هذا الصدام بين مجموعتين لا يكمن في الصدام بين الشرق والغرب فقط، وإنما يمكن أن يكون بين مجموعات المجتمع الواحد على أساس فكري، ثقافي وعقائدي كصدام مصطفى سعيد والشخصيات التي تحسب على مجموعته وبين العادات والتقاليد والفكر الديني المكرِس للقديم والثابت، متمثلا بالشخصيات السودانية المختلفة في الرواية والتي ترفض كل ما هو جديد وإن كان نافعا. بالضبط كما يمكن أن يحدث الصدام داخل النفس أو الذات البشرية الواحدة عندما تتصادم مكوناتها خاصة ذلك الصدام المستمر بين الأنا والـ “هو” حول ما نريد وما يجب أن يكون.
“الأنا” وما يمثله في الرواية
أن أية دراسة لهذه الرواية الرائعة لا بد لها أن تأخذ بالحسبان الظروف والأوضاع الاجتماعية، التاريخية، السياسية والاقتصادية التي مرّ ويمرّ بها العالم العربي خاصة والعالم الثالث والشرق (أو الجنوب) المستعمَر عامة، خاصة عندما يكون محور هذه الدراسة هو الآخر، أو الأنا والآخر كما ينعكس في الرواية. ولذلك لا بدّ للدارس أن يكون مطّلعا بشكل أو بآخر على هذه الأوضاع ليتسنى له فهم طروحات الطيب صالح التي يقدمها في روايته.
وفي رأينا، استطاع الطيب صالح من خلال عمله الفني المتكامل أن يظهر قدرة فائقة في فهم كل هذه الظروف متفرقة ومجتمعة في آن معا، مكنته من تحليل منظومة العلاقات المتشابكة بين الشرق المستعمَر والغرب المستعمِر (الجنوب والشمال). وتأتي شخصيات الرواية، سواء تلك الشخصيات التي تمثل الأنا (الشرق) أو الشخصيات التي تمثل الآخر(الغرب)، تأتي لتؤكد تلك القدرة وذلك الكم المعرفي الهائل وتلك البراعة المنقطعة النظير، التي تمتّع وتميّز بها الطيب صالح في رسم شخصياته بشكل يجعلها قادرة على تأدية الغرض الذي رسمت من أجله. ولا يختلف اثنان أنه أصاب نجاحا باهرا في رسم تلك الشخصيات من الجانبين.
أما على صعيد “من هو الأنا؟” في الرواية، فهنالك ثلاث شخصيات هي مصطفي سعيد، الراوي وحسنة. مصطفى سعيد في مواجهة الغرب، والراوي في مواجهة مصطفى سعيد والغرب من جهة ومجتمعه من جهة أخرى، وحسنة أرملة مصطفى سعيد في مواجهة مجتمعها. إذن هذه الشخصيات هي التي تمثل الأنا بمستوياته المختلفة. وسواء قصد الطيب صالح ذلك أو لم يقصده، لا يختلف اثنان أيضا إنّ حق الصدارة بين هذه الشخصيات الثلاث هو لمصطفى سعيد بدون منازع، رغم ما بين شخصيته وبين شخصية الراوي المغيّب الاسم من التماهي.
بالنظر إلى الرواية على مستوى السرد والدلالة، يقول محمد عزام: “الرواية مبنية على مستويين فنيين، يمثل كل منهما مرحلة زمنية، وبالتالي وعيا متتابعا لإشكالية العلاقة بين الشرق والغرب. المستوى الأول تمثله شخصية مصطفى سعيد، بطل الرواية الذي يروي حكاية سفره إلى أوروبا، … والثاني تمثله شخصية الراوي الذي يلتقي بمصطفى سعيد، ويشكل استمرارا له، فهو ايضا يسافر إلى أوروبا للدراسة، ويعود إلى قريته ليعيش حياة عادية، ولكن بدون إشكالية (محمد عزام، 1992، ص 26). ورغم أنّ حسنة بنت محمود لا دور لها على مستوى السرد، إلا أنّ لها دورا بالغ الأهمية على مستوى الدلالة، فهي تلعب دورا مهما يضمن الاستمرارية لمشروع مصطفى سعيد الذي عاد من أجله، والذي يخرجه في رأيي من دائرة البطل الإشكالي السلبي.
مصطفى سعيد
يجدر بنا هنا أن نسجل بعض الآراء حول شخصية البطل تفيدنا في فهم شخصية مصطفى سعيد، بطل الطيب صالح في روايته. يرى أفنان القاسم أنّ البطل هو “إنسان عادي، بسيط، … بجذور طبقية عميقة، ولا بدّ لنهوضه هذا النهوض المادي أن يأخذ معناه من ارتباطه بزمانه ومكانه، من تحول العلاقات الاجتماعية القائمة، وعوامل الصراع الطبقي الدائر، تلك العوامل الموضوعية لا تنفي العامل الذاتي ضمنا، والذي يمكن أن يلعب دورا اساسيا في العملية التاريخية والاجتماعية التي هي شرطه دوما، ولكن ليس الدور الأول والأخير. إنّ وعي المهمات التاريخية والاجتماعية من طرف الإنسان العادي … والذهاب بها إلى طورها الأعلى، طور ممارستها في الواقع، ما سيضفي عل هذا الإنسان العادي، البسيط … صفة البطولة” (أفنان القاسم 1984، ص، 22).
أما اعتدال عثمان، فلا تبعد عندما تقول: “البطل الروائي صورة خيالية تخلقها بنية الكاتب الفكرية متضافرة مع موهبته، وتستمد وجودها من مكان معين وزمان معين. وتعكس علاقات البطل المتشابكة في العمل الروائي ظروفا اجتماعية وسياسية واقتصادية بعينها، تؤثر تأثيرا حيويا في تحديد هوية البطل ومصيره (اعتدال عثمان، 1982، ص 91).
هذه الرؤية للبطل تتفق جزئيا أو كليا مع بطولة مصطفى سعيد، ولكن لا بدّ أن نزيد أنّ هذه البطولة إشكالية تواجه قوى مضادة فلذلك لا بدّ لبطلها أن يتصف بحصانة فكرية ونفسية تسنده في مواجهة بؤس الواقع وتناقضاته، ولذلك فإنّ بطلنا، مصطفى سعيد، بطل مسكون بهاجس الفعل ورفض الاستكانة لإملاءات الواقع، فهو حركي يرفض السكون والثبات والتسليم بالأمر الواقع. إنه البطل الإشكالي الذي يبحث عن قيم حقة في مجتمع منحط. يواجه قوى القهر السياسي، من الداخل والخارج. ولذلك فهو يعبّر عن شريحة من مجتمعه، ترفض الخنوع وتتشبث بحقها في الكرامة والعيش الحر. وهنا لا بدّ أن نرى امتداده في الراوي، لتكتمل صورة المناضل الذي يضمن استمراريته بشتى الظروف. ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ بطلنا هنا ليس بسيطا بمفهوم أنه ولد من رحم الطبقات المسحوقة، ولكنه ينتمي للطبقة البرجوازية الوطنية أو التي تحولت إلى وطنية في مرحلة ما بعد أن كانت برجوازية رجعية.
في الحقيقة، إنّ شخصية مصطفى سعيد هي شخصية بالغة التركيب والتعقيد. وبما أننا أمام شخصية روائية مختلفة، لا أناقض نفسي إذا قلت إنّ في هذه الشخصية من الغموض ما يساعد على فهم تركيبها وتعقيدها وما يساعد كذلك على كشف ما تمثله، إذا أخذنا في الحسبان الظروف الاجتماعية، التاريخية، السياسية والاقتصادية التي تقدّم ذكرها. إنها تمثل الأنا الفردي والجمعي. أي تمثل المثقف العربي الشرقي، الفرد أو الشخص في صدامه مع الغرب وثقافته وحضارته ونزعته الاستعمارية الاستعلائية من جهة، وتمثل كذلك الصدام الثقافي والحضاري بين الشرق المستعمَر والغرب المستعمِر. فمصطفى سعيد لا يمثل نفسه فقط بل يتعدى ذلك إلى التركيب والتعقيد في تمثيله للمجتمع السوداني، الأفريقي (اللون الأسود)، العربي، المسلم، الشرقي والمنتمي إلى العالم الثالث المضطـَهد والمستعمَر.
كل هذه السمات المتداخلة نجدها في شخصية مصطفى سعيد الذي يضطر إلى شنّ هجوم مضاد على الغرب وكل ما ومن يمثله، مصرحا بذلك علنا “إنني جئتكم غازيا” (موسم، ص 63). فكأنه خلق محكوما بهذا الصدام مع الغرب لينتقم بطريقته الخاصة لما حدث، أياما معدودة بعد ولادته (2، أيلول 1898)، لمحمود ود أحمد الذي جيء به وهو يرسف بالأغلال بعد أن هزمه كتشنر مستخدما الرشاشات مقابل السيوف والبنادق القديمة فأسقط أكثر من عشرين ألفا من المسلحين في موقعة (تبر). والأمرّ من ذلك أنّ كتشنر قال لمحمود ود أحمد المقيّد “لماذا جئت بلدي تخرّب وتنهب (عزام، 29-30). في بادئ الأمر قصد مصطفى سعيد الغرب لينهل من ثقافته وعلومه، ولما أتقن علوم الاقتصاد، فهما وممارسة من خلال محاضراته عنه، كإشارة لفهم الغرب وحضارته، “كتب عن اقتصاد الاستعمار” (موسم، 61)، ولكنه راح أيضا “يكتب ويحاضر عن الاقتصاد المبني على الحب لا على الأرقام” (موسم، 39)، ربما كمحاولة لمصالحة، ولكنه أرادها مصالحة يحكمها التكافؤ والمساواة مع الغرب، أراد بها أن يفهم الغرب أن هناك طريقة أفضل لتقاسم خيرات هذا العالم تقوم على الحب والعدل والمساواة، وهي أفضل من طريقتهم التي تقوم على الأرقام والاستعلاء والجشع وحب التملك والاغتصاب. ولكن محاولته فشلت، ما أدّى إلى تحطيم قلبه كما جاء في دفاع بروفيسور فستر كين عنه إذ يقول: “مصطفي سعيد يا حضرات المحلفين إنسان نبيل، استوعب عقله حضارة الغرب، لكنها حطمت قلبه”. (موسم، 36).
ويرى القاسم (2008) إنّ بطل الرواية (مصطفى سعيد)، يمكن فهمه من الرواية، بأنه أحد أبناء الطبقة الكومبرادورية التي اعتاد الاستعمار الأوروبي بناءها أثناء احتلاله للمستعمرات، في كافة أنحاء العالم، حيث يتمكن المستعمِر من خلالهم، من التواصل مع البلد المحتل، حتى بعد زوال الاحتلال، كي يمكنه من خلالهم السيطرة على اقتصاديات البلد المحتل، وقد قدم هذا الشخص، خدمات كثيرة للمحتل البريطاني، كما غيره من الفئات المستفيدة من الاحتلال، من خلال ما كان يكلف به من أعمال خاصة، يقوم بها خدمة لمن عملوا على تعليمه وتوظيفه.
فإذا صحّت هذه الرؤية فإنني اعتقد أن الغرب المستعمِر ورغم ما أخذ من مصطفى سعيد، قد فشل في ترويضه وتوظيفه لخدمته، أولا بدليل تصرفه في الغرب وإعلانه غزوه لهم وقتلهم، وثانيا بدليل أنهم سجنوه وشرّدوه عقابا لتمرده، وثالثا بدليل أنّه عاد إلى الوطن يحمل مشروعا فيه خدمة للوطن وناسه، وكما صرّح للراوي بأنه لا يريد لهذا البلد إلا الخير، ولم يختفي إلا بعد أن ضمن الاستمرارية لمشروعه من خلال الراوي وزوجته حسنة بنت محمود. وفي حديثنا عن الراوي سنبين ما بينه وبين مصطفى سعيد من التماهي خاصة في مسألة العودة إلى الوطن، ما يؤكد فشل محاولة الاستعمار تجنيد مصطفى سعيد لخدمته وكون محاولة التجنيد واحدا من الأسباب في حبه للانتقام من الاستعمار وإعلان الحرب عليه. وربما هذا ما يتوخاه الطيب صالح من هذه الطبقة التي تدمر المجتمع العربي بجهلها وعمالتها، أن تتحول من طبقة برجوازية رجعية مستعدة لبيع الوطن من أجل مصالحها، إلى برجوازية وطنية يستفيد الوطن من استثمار مصالحها.
وفي المرحلة الثانية، مرحلة العودة إلى الوطن، جاء الصدام الثاني، الصدام مع الشرق ومع المجتمع الذي ينتمي إليه مصطفى سعيد. وهنا يمثل مصطفى سعيد المثقف الشرقي العربي المسلم الذي يبدأ مشروعا تقدميا، فكرا وثقافة، فيصطدم داخل مجتمعه بالقوالب الثابتة، اجتماعية كانت أو دينية، والتي تعارض المشروع وتعمل على هدمه. وهذا ما أشرنا إليه في الفصل السابق في تعريفنا للآخر أنه يمكن أن يتموقع داخل الذات الفردية أو الجمعية.
هذه الازدواجية في الصراع، إن صحّ التعبير، تساهم مساهمة كبيرة في توتر شخصية مصطفى سعيد المتوترة أصلا، إذ يرى الياس خوري، (1974، ص 26) أنّ مصطفى سعيد الذي يعتبر من أهم “الشخصيات في الرواية العربية، إنها شخصية شديدة التوتر”، ويرى محمد رشد (2009)، أنّ هذا التوتر يبدو جليا من خلال استعراض أحداث حياته: “مصطفى سعيد من مواليد الخرطوم، 16 أغسطس 1888 … الأب متوفي، الأم فاطمة عبد الصادق” (موسم، ص، 22)، فهو إذن يتيم مات أبوه قبل ولادته، ولم يبق له في الدنيا سوى أمه التي “كانت كأنها شخص غريب جمعتني به الظروف صدفة في الطريق” (موسم، ص،23). والأمر يبدو واضحا في الرواية إذ ليست علاقته بأمه فقط هي المتوترة والمثيرة للتساؤل، وإنما مجمل علاقاته مع كل من ربطته بهم علاقة ما، في الغرب أو في وطنه، كلها كانت علاقات متوترة ومثيرة للتساؤل، ينعكس عليها ذلك التوتر الذي في شخصية مصطفى سعيد مما يجعلها شخصية غريبة ومثيرة للجدل. ولا أدري إذا كان الكم الهائل من الدراسات التي كتبت حوله قد أوفاه حقه أو لا. ربما من الناحية الفنية نعم، ولكن من حيث فكّ كل رموزه وفهم كل دلالاته ففي اعتقادي لا.
ومما يؤكد ما سبق، أي أنّ شخصية مصطفى سعيد لا تمثل الأنا على الصعيد الفردي فقط، هو ما ذهب إليه حج محمد (2007)، إذ يقول: “وإذا كان النقاد يعرفون الرواية بأنها “ترجمة أو تصوير لواقع الحياة” فإن “موسم الهجرة إلى الشمال” هي تصوير لواقع اجتماعي عربي عام، وعلى الرغم من أنّ أحداث الرواية تدور في الريف السوداني إلا أنها تسلط الضوء على أساسيات التركيبة الاجتماعية العربية، وترسم صورة للإنسان العربي في واقعه المعاش، صورته الاجتماعية بحلوها ومرها، وزيفها وحقيقتها، إنها رواية البؤس العربي بامتياز”. ألم يسبق لنا القول أنّ الطيب صالح تمتع بفهم شمولي للحالة العربية وبؤسها.
وعليه فإن مصطفى سعيد يمثل الشرق بشكل عام، والعالم العربي بشكل خاص، في صراعه مع الغرب الإمبريالي الذي استعمر الشرق، ونظر إليه نظرة دونية، وامتهن كرامته فحرمه حريته وسيادته على أرضه، ونهب خيراته، وتمتع بها، بدون أن يعطي له فرصة التمتع ولو بالنزر اليسير من هذه الخيرات. مصطفى سعيد الذي رأى ألا بدّ من هجوم على العالم الإمبريالي في عقر داره، هجوم ثقافي حضاري سلاحه الثقافة والجنس والتضليل (السياسة)، هجوم يحسم الصراع أو يجيّره لمصلحة مصطفى سعيد وما يمثله، مصلحة شعبه ووطنه، لكي تتسنى له فرصة العودة إلى وطنه ليخوض المعركة الأخرى الضرورية مع القوالب الرجعية المتسلطة في مجتمعه، والتي بدون حسمها لن يستطيع هذا المجتمع النهوض من جديد ومتابعة حياته بحرية وكرامة. وما الأوضاع السائدة في العالم العربي اليوم إلا دليل على أن الطيب صالح يعي تمام الوعي أنّ مشوار مصطفى سعيد وبعده حسنة والراوي لم يكتمل بعد، وأنّ صرخات الراوي بطلب النجدة ما زالت مدوية لا بدّ أن تصل إلى من سيتابع الطريق. ومن خلال فهمنا لكل الظروف المحيطة بالطيب صالح وبروايته، فأن مصطفى سعيد هو ليس الوضع العربي الراهن فحسب، إنما هو يمثل التاريخي أيضا، الأمر الذي يبدو جليا أولا في تدرجه في التعامل مع الشخصيات الغربية وخاصة آن همند، شيلا غرينود، إيزابيلا سيمور وجين مورس، أو في طريقة تعاملها هي معه، وثانيا في دفاع بروفيسور فستر كين عنه في المحكمة “… هاتان الفتاتان لم يقتلهما مصطفى سعيد ولكن قتلهما جرثوم مرض عضال أصابهما منذ ألف عام” (موسم، 36-37). وما الذي دعاه إلى تضليل كل الفتيات إن لم يكن تمثيلهن للإمبريالية في مختلف عصورها وأشكالها؟ إلا تشير العبارة السابقة “منذ ألف عام” إلى الغزو الصليبي الذي لا يختلف عما حدث ويحدث في أيامنا؟ أنا أومن بذلك ومحمد عزام (1992) يؤكده (ص 38-39).
الراوي
الشخصية الثانية التي تمثل الأنا أمام مصطفى سعيد والغرب من جهة، والمجتمع العربي من أخرى، هي شخصية الراوي، أو هو المستوى الثاني للسرد ودلالاته، كما أسلفنا، والذي عن قصد تركه الطيب صالح مغيّب الاسم أو مجهوله، فإنّ فيه من مقومات التماهي مع شخصية مصطفى سعيد الشيء الكثير بحيث يمكـّننا ذلك من النظر إليه على أنه امتداد لمصطفى سعيد “إنني ابتدئ من حيث انتهى مصطفى سعيد” (موسم، ص 135)، والذي أوكل إليه متابعة مشروعه بغية إتمامه. ويظهر لنا ذلك جليا في إطلاع مصطفى سعيد للراوي على سرّه وجعله وصيّا على بيته وزوجته وولديه من بعده. “إنني أترك زوجتي وولدي وكل مالي من متاع الدنيا في ذمتك، وأنا أعلم أنك ستكون أمينا على كل شيء” (موسم، ص 69). ويؤكد ذلك ما تراه سميرة سليمان، (2009)، إذ تقول: كان هناك رابط خفي يربط بين الراوي وبطل الرواية “مصطفى سعيد” يجعل كل منهما يفهم الآخر ويعرفه جيدا … قد يكون ذلك بسبب تجربة السفر لكل منهما إلى نفس المكان، وقد يكون خوف الراوي أن يصبح نسخة من مصطفى سعيد ويلاقي نفس مصيره وفي ذلك يتساءل الراوي: “…هل كان من المحتمل أن يحدث لي ما حدث لمصطفى سعيد؟ قال إنه أكذوبة؟ فهل أنا أيضاً أكذوبة؟” (موسم، ص 52). يترك مصطفى سعيد رسالة للراوي يوصيه بزوجته وولده وكل ماله، فهو يثق بأمانته. ونعرف من الخطاب أيضا أن مصطفى سعيد ترك للراوي مفتاح غرفة خاصة به فيقول: “…أعلم أنك تعاني من رغبة استطلاع مفرطة بشأني، الأمر الذي لا أجد له مبررا. فحياتي مهما كان من أمرها ليس فيها عظة أو عبرة لأحد” (موسم، ص 69). هذا الأمر يؤكد استمرارية دور مصطفى سعيد في الوطن، من خلال شخصية الراوي ومتابعته للوصية التي حمّله مصطفى سعيد وزرها. أي أنّ الراوي سيقود الصدام الذي بدأه مصطفى سعيد ولكن في الداخل، داخل المجتمع السوداني / العربي.
وإذا كنا مقتنعين بقضية التماهي بين شخصيتي مصطفى سعيد والراوي، فإنّ توتر مصطفى سعيد الذي جعله يشكك بمصداقيته، فكونه جعل من نفسه أكذوبة إنما قصد الطيب صالح بذلك أن بيرز الجانب الآخر لشخصية مصطفى سعيد، المثقف السوداني أو العربي الذي يعود لوطنه يقتله الشوق لأرضه وناسه ليكمل مشروعا ينقذ به الوطن الغارق في أحضان الماضي المتخلف، إذ نرى في شخصية الراوي أنها الوجه الحقيقي لمصطفى سعيد الذي لم يستطع أن يموت أو يختفي قبل أن يظهره. هذا يظهر بوضوح في شكل العودة والنهاية لكل من الشخصيتين. عودة مصطفى سعيد ونهايته اللتان يكتنفهما الغموض، وعودة الراوي الواضحة بعد غيبة دامت سبعة أعوام اعتمل فيها حنين متواصل لأرض وناس فرح وفرحوا بعودته إليهم. “المهم أنني عدت وبي شوق عظيم إلى أهلي في تلك القرية الصغيرة عند منحنى النيل. سبعة أعوام وأنا أحنّ إليهم واحلم بهم، ولما جئتهم كانت لحظة عجيبة أن وجدتني حقيقة قائما بينهم، فرحوا بي وضجوا حولي، ولم يمض وقت طويل حتى أحسست كأن ثلجا يذوب في دخيلتي، فكأنني مقرور طلعت عليه الشمس”. (موسم، 5). وليس عبثا قضى الراوي سبع سنوات في الغرب كانت موازية لسبع سنوات سجن فيها مصطفى سعيد. سبع سنوات سجن وسبع سنوات تعليم، بقدر ما فيها من التماهي فهي فترة استعداد وتأهيل لحمل المسؤولية لدى الراوي، وفترة تفكير عميق وتأمل في أن يظهر جيل يستطيع مصطفى سعيد أن يعتمد عليه في حمل المسؤولية والاستمرار بها قدما.
سنرى هذا التماهي أيضا، بين شخصية الراوي وشخصية مصطفى سعيد من خلال الحديث عن حسنة بنت محمود زوجة مصطفى سعيد التي ما كانت لتأمن جانبه (الراوي) وتدخله بيتها لولا أن رأت فيه امتدادا لزوجها. وكأنّ مصطفى سعيد ما عاد إلى الوطن إلا لينقل إلى أهله، المتمثلين بالراوي وحسنة، لينقل إليهم بذرة التمرد ومتابعة الطريق الذي سلكه في غزوه للغرب ثم عاد ليرفد وطنه ومجتمعه بثمار ذلك الغزو. ورغم أنّ مصطفى سعيد لم يجد الكثيرين للقيام بالمهمة إلا أنّ الراوي وحسنة كانا كافيين لتحمل تبعات المضي بها، على أقل تقدير، لكيلا تنطفئ الشعلة التي أوقدها.
حسنة بنت محمود
وأخيرا، حسنة بنت محمود، هي في رأينا الوجه المشرق في الصراع داخل المجتمع السوداني، الأفريقي، العربي أو الشرقي، وليس عبثا اختيار الطيب صالح للاسم “حسنة”. هي الوجه المشرق الذي رفض الظلم والظلام برفضه للقوالب الاجتماعية والدينية الثابتة. حاولت تغييرها فدفعت الثمن غاليا، ولكن عن أيمان ورغبة بدفع الثمن لكسر تلك القوالب، مفضلة ذلك على الرضوخ لها. يتمثل ذلك بوضوح في محاولة حسنة الخروج عن المألوف في انتقاء الزوج، ورفضها الزواج من ود الريس وما يمثله من قوالب رجعية جاهزة وثابتة، والذي مثل باغتصابه لحسنة اغتصاب هذه القوالب الرجعية للواقع العربي. ولما فشلت حسنة في محاولتها، كإشارة إلى قوة تلك القوالب الجاهزة وتغلغلها في المجتمع السوداني / العربي / الشرقي، آثرت النهاية المأساوية بقتل ود الريس وانتحارها، وما في ذلك من إشارة إلى قوة الرفض والحاجة إليها وإلى التضحية من أجل بلوغ الهدف: التغيير من أجل الانعتاق والحرية. ومن نفس المنطلق يتساءل محمد رشد (2009)، ولماذا تفضل “حسنة بنت محمود” أرملة “مصطفى سعيد” الراوي على جميع من تقدموا لخطبتها، وحين أرغمها أهلها على الزواج من “ود الريس” قتلته وانتحرت؟ لو لم تكن قد رأت في الراوي استمرارا لزوجها الذي لقحها بأفكاره ومدنيّته، فلما مات أرادت أن تستمر في نفس الطريق الذي بدأته معه، ولم يكن “ود الريس” ليمثل لها المعين والمساعد. ويبدو واضحا هنا أنها رأت في الراوي المعين والمساعد، ولكن الفكر الاجتماعي والديني المتحجر والمسيطر في المجتمع لم يمكنهما من المواصلة فماتت حسنة بنت محمود وصرخ الراوي صرخته المدوية والمعبرة “النجدة. النجدة” (موسم، ص 171)، كتعبير عن طلب الحياة، والتي ما زال صداها يتردد في أجواء العالم العربي كله ليوقظ الضمائر ويشحذ الهمم بإن لا بدّ من تضافر القوى الخيرة النيرة لتستمرّ الحياة الحرة الكريمة. هذه الشخصيات الثلاث تمثل الأنا الفردي والجمعي في الشرق بكل إشكالياته. إلا أنّ الذي يهمنا أكثر، كما أسلفنا، هو الأنا الجمعي الذي يمثل الشرق، كذلك بكل إشكالياته وتعقيداته: الشرق / أفريقيا / العالم العربي / العالم الثالث / السودان / أو أي قطر عربي آخر في أفريقيا أو العالم العربي أو العالم الثالث المستعمَر. يبدو لي واضحا في الرواية أنّ هذه الشخصيات الثلاث هي التي تشعل الصراع وتقود الصدام مع الآخر / الغرب أو مع الآخر في المجتمع الشرقي العربي نفسه. الأمر الذي يجعل القتال على جبهتين، مختلفتين متناقضتين، أكثر صعوبة وتعقيدا، ما أدّى بهذه الشخصيات إلى دفع الثمن الفادح ولكن عن طيب خاطر، حبا في التضحية من أجل التغيير. وهو أيضا الأمر الذي يبيّن بوضوح معرفة الطيب صالح بمواطن الوجع في هذا الوطن والحاجة إلى شفائه منها مهما كلف الثمن. وهو الأمر الذي جعله لا يختار لبطله “المصالحة الظاهرية مع الواقع والرفض الضمني له (كما حدث في روايات سابقة) بل تعدّ هذا الخيار السلبي إلى المشاركة في عمل جماعي من أجل تغيير الواقع والسعي نحو مستقبل أفضل وأكثر تلاؤما مع القيم الحقيقية التي يسعى إلى تحقيقها (عثمان، 1982، ص، 94). هوية الآخر بشقيه، في داخل الذات وخارجها، والصدام أو الصراع مع هذا الآخر بشقيه هو موضوع حديثنا في الفصل التالي.
“الآخر” وما يمثله في الرواية
إذا كان الطيب صالح في روايته “موسم الهجرة إلى الشمال” كما يرى رامي أبو شهاب (2009) قد وضع الذات مركزا لها … وقد انطلق من ذاته أولا، فقد جعل هذه الذات تشمل بعدا جغرافيا، وآخر عرقيا، وآخر قوميا، وآخر ثقافيا، وآخر تاريخيا. وعليه فإنّ المتتبع للرواية بدءا بعنوانها، يلمح أنّها تنطلق من بدايتها من ثنائية الجغرافيا، حيث الهجرة إلى الشمال، مما يعني ثنائية الطرف الغائب عن العنوان، وهو الجنوب، وهو متسع جدا ليشمل كل جنوب في مواجهة كل شمال، ما يشي منذ اللحظة الأولى أنّ صداما ما بين الذات (الأنا) والآخر واقع لا محالة.
وكما أسلفنا فإنّ النظر إلى الآخر في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال” يجب أن يتشعّب تشعّب الآخر في الواقع. فالآخر هنا ينقسم إلى آخرين: الأول هو الغرب بكل ما يمثله وعلى كل المستويات التي سنأتي على ذكرها لاحقا. والثاني هو القوالب الاجتماعية والدينية المتحجرة والتي تعادي كل فكر تقدميّ نيّر في المجتمع السوداني الذي يمثل بدوره المجتمع الأفريقي، العربي، الإسلامي، والشرقي بتركيباته وتعقيداته الاجتماعية والدينية.
الآخر / الغرب الإمبريالي المستعمِر
في “موسم الهجرة إلى الشمال” كل الشخصيات الغربية التي ظهرت تمثل الغرب، بغض النظر عن حجم ظهورها. ولكن سنكتفي بالحديث عن أهم خمس شخصيات، وهي الشخصيات النسائية تحديدا، حسب ظهورها في الرواية رغم ما بينها من تقاطع أحيانا. هذه الشخصيات هي: مسز روبنسن، آن همند، شيلا غرينود، إيزابيلا سيمور وجين مورس. سأبدأ الحديث بمسز روبنسن وما تمثله لأنها الوحيدة المختلفة بين الشخصيات الخمس:
السيدة روبنسن
هذه السيدة تمثل الوجه الآخر للغرب. الوجه الإنساني الذي أغرقته مظاهر الإمبريالية في الغرب فتوجّه إلى حيث يمكن له أن يشرق من جديد، إلى القاهرة / الشرق. إنّ لقاء هذه السيدة لمصطفى سعيد واحتضانه بين ذراعيها وفي بيتها، احتضان الأم لولدها يؤكد أنها وجه الغرب المشرق الذي هجر الغرب ليحافظ على إشراقه. الغرب الذي يقبل الآخر كندّ يستحق الاحترام والمساواة. لنتمعن في خطابها لمصطفى سعيد: ” أنت يا مستر سعيد” (موسم، 29). وقبلها زوجها “كيف أنت يا مستر سعيد” وإجابته له “أنا بخير يا مستر روبنسن” (موسم، 29)، أليس في ذلك خطاب الندّ للندّ؟ وكيف يمكن أن نفسّر هذا الاحتضان من جهة السيدة روبنسن مدعوما برضى زوجها، وبإجادته للغة العربية واعتناقه للإسلام، كيف يمكن أن نفسره إلا أن يكون قبولا للآخر لدرجة الالتحام معه في مجموعة واحدة، لغة وفكرا وعقيدة؟ أيّ قبول للآخر يمكن أن يكون أقوى من هذا الذي يمثله مسز ومستر روبنسن؟ و”كان مستر روبنسن يحسن اللغة العربية، ويعنى بالفكر الإسلامي والعمارة الإسلامية، فزرت معهما جوامع القاهرة، ومتاحفها وآثارها”(موسم، 29)، أليست هذه مفارقة؟ إذ من الذي يجب أن يعرّف من على القاهرة وجوامعها ومتاحفها وآثارها؟ أليست هذه هي حضارة مصطفى سعيد الذي يجب أن يعرفها ويعرف كيف يطلع الآخر عليها؟ إلا تبيّن هذه العبارة بوضوح أنّ وجه الآخر عندما يكون مشرقا يساعدك بل يقودك إلى اكتشاف مجاهل نفسك؟ واكتشاف آخر، تقول مسز روبنسن لمصطفى سعيد “أنت يا مستر سعيد خالٍ من المرح تماما” (موسم، 29). والأهم من ذلك، يبدو مصطفى سعيد كأنه لم يكن يعرف ذلك أو لم يكتشف ذلك إلا بعد أن أشارت إليه مسز روبنسن، ويبدو ذلك، وإن لم يكن واضحا تماما، في عبارته “صحيح إنني لم أكن أضحك” (موسم، 29). إذ لو كانت هنالك فاصلة بعد كلمة “صحيح” وعلامة تعجب بعد العبارة التالية لها، لبدا الأمر جليا.
وأخيرا، هل وجد مصطفى سعيد يوم حكموا عليه في الأولد بيلي بالسجن سبع سنوات، هل وجد صدرا غير صدر مسز روبنسن يسند إليه رأسه؟ (موسم، 29). لن نجد أيّا من هذه السمات لدى أيّ من الشخصيات الأربع التالية؟ اللهم إلا في نظرة مصطفى سعيد إليهن جميعا كنساء أثرن شهوته الجنسية، وإن كانت، في حالة مسز روبنسن، شهوة مبهمة لم يحس بها من قبل. ربما نفهمها كقبول منه هو للآخر تعكسه لذة اللقاء والانسجام بينهما.
آن همند
قبل بدء الحديث عن آن همند، أو غيرها من الفتيات، المنتحرات بشكل خاص، من الجدير أن نسجل هنا ما أورده محمد عزام عن أنّ مصطفى سعيد كان “يعلم جيدا أنّ الهجرة هي دوما إلى الشمال، وأنّ الأنهار تصب جميعا باتجاه الشمال، وأنّ التاريخ هو جنوب يحنّ إلى الشمال. أما حنين الشمال إلى الجنوب فأكذوبة (عزام، ص 34-35). هذه العبارة “أما حنين الشمال إلى الجنوب فأكذوبة” في منتهى الأهمية خاصة في تفسيرنا لتعلق الفتيات بمصطفى سعيد وانتحارهن المزعوم بسببه.
كانت آن همند ابنة ضابط في سلاح المهندسين، أمها من العوائل الثرية في لفربول، وعمتها زوجة نائب في البرلمان، قضت طفولتها في مدرسة للراهبات، والتحقت بعدها بجامعة أكسفورد لدراسة اللغات الشرقية، كانت تحن إلى الشرق، وكانت مترددة بين اعتناق البوذية أو الإسلام، تعرفت إلى مصطفى سعيد لأنه حرك فيها هذا الحنين إلى الشرق عن طريق أشعار المجون لأبي نواس، وكذبه وتلفيقه. في علاقتها بمصطفى سعيد تقمصت شخصية الجارية (سوسن) ولعب هو دور السيد، لكنها في النهاية انتحرت بالغاز تاركة ورقة صغيرة باسم مصطفى سعيد فيها هذه العبارة “مستر سعيد. لعنة الله عليك”.
هذه السمات التي تتمتع بها هذه الشخصية تمثل، في رأينا، مرحلة التفكير الإمبريالي الغربي في استعمار الشرق، وتعكس تهيّؤ كل الظروف المطلوبة للتنفيذ. فكونها أبنة ضابط هذا يمثل القدرة العسكرية، وسلاح الهندسة هو القادر على رسم الطريق وشقّها. وانتماء أمها إلى العوائل الثرية يمثل رأس المال الذي لا يهدأ إلا في مضاعفة نفسه (الفكر الإمبريالي). وكون عمتها زوجة نائب في البرلمان يعني تهيؤ الظروف السياسية. وكونها قضت طفولتها في مدرسة للراهبات لا يعني إلا تمرّغ السياسيين وأصحاب رؤوس الأموال في أحضان الكنيسة لتبارك حملاتهم الصليبية “الدينية” على الكفار “محتلي الأراضي المقدسة”. وما دراستها للغات الشرقية في جامعة أكسفورد التي تمثل الصرح العلمي للإمبريالية البريطانية (الغربية) إلا إشارة إلى دراسة الشرق ومفاتيحه بهدف استعماره. وحملة نابليون على مصر واصطحابه للعلماء هما خير دليل على ذلك. وحنينها للشرق وترددها بين اعتناق البوذية أو الإسلام لا يزيد على أن يكون تلك الجرثومة، أو تلك السياسة الإمبريالية الغربية الماكرة التي تجمّل بها الإمبريالية صورتها البشعة لتظهر أمام الشرقيين بمظهر المحب الوافد للدعم والمساعدة. وقد يعني تعرفها على مصطفى سعيد الذي حرك حنينها إلى الشرق، تعرفها على خيرات الشرق وتحريك شهوتها وفتح شهيتها على تلك الخيرات التي يمثلها سحر مصطفى سعيد وقدراته الجنسية الجذابة إلى درجة القمع. وقد تقمّصت شخصية الجارية “سوسن” كذلك لتجميل صورتها البشعة فيظهر بذلك مصطفى سعيد وكأنه هو السيد. وهل يخاف السيد من جاريته مهما طغت؟ إذن، كل هذا ما هو إلا نصْبُ الشرك وتلفيق المشاعر التي تحرك قلب الشرق وتسبي عقله.
وقد يسأل سائل: ولماذا الانتحار وبالغاز تحديدا؟ ونجيب بأسئلة واضحة المراد. أليس كل ما فعلته آن همند هو تضحيات منها من أجل بلوغ الهدف الذي يستحق، من وجهة نظرها، أكثر من ذلك؟ أو بلغة الإمبريالية نفسها: أليس ما بذلته آن همند هو رأس المال المستثمر في الشرق سعيا وراء جني الأرباح التي تفوقه أضعافا مضاعفة؟ ولكن، عودة إلى الانتحار والغاز: أليست كل عملية غزو هي عملية انتحارية مكتوب لها النهاية والفشل مهما طالت؟ وأليس الغاز هو النفط العربي الذي تسعى إليه الإمبريالية، ولكنها تحترق وتحرق العالم به؟ ألم يحرق بوش ومن يدفعوه كل جسور الإنسانية من أجل السيطرة على العراق ونفطه؟ وماذا يمكن أن تكون محصلة الاستعمار والغزو الإمبريالي مهما طال، ومهما التهم من خيرات الشعوب؟ أليست تلك العبارة التي تركتها آن همند في ورقة صغيرة “مستر سعيد، لعنة الله عليك”؟ لننظر إلى التناقض بين ورقة صغيرة و”مستر”. ألا تعني الورق الصغيرة استمرارية الاحتقار، وكلمة “مستر” اعترافا بالسيادة، سيادة الشرقي على شرقه، وخروج المستعمِر مهما مكث ونهب كأنه لم يمكث ولم ينهب؟ ألن تخرج أمريكا من العراق، مهما طال مكوثها فيه، لاعنة العراق ووحله؟ ألم تحرق إنسانيتها بغاز العراق.
وأخيرا، ألم ير الطيب صالح، من خلال روايته الصادرة في أواخر الستينات، ما كان وما سيكون؟ وأين تبدأ الأمور وإلى أين ستؤول؟ ألا يفسر ذلك تمثيله للتاريخي والراهن والقادم؟ فإذا كان الشعراء أنبياء شعوبهم فقد احتلت الرواية في العالم العربي مملكة الشعر ودحرت جيوشه وحدّت من صولته؟ ألا يصبح الروائيون أمثال الطيب صالح، بتصويرهم للتاريخ والحاضر واستشرافهم للمستقبل، أنبياء شعوبهم حقـّا؟
شيلا غرينود
كما ورد في الرواية، كانت شيلا غرينود “خادمة في مطعم في سوهو، بسيطة حلوة المبسم، حلوة الحديث، وأهلها قرويون من ضواحي هل. أغراها فأحبته … دخلت غرفة نومه (مصطفى سعيد) بتولا بكرا، وخرجت تحمل جرثومة المرض في دمها. (موسم، 38). وانتحرت. كانت تعمل في النهار وتواصل دراستها في الليل، ذكية، تؤمن بمستقبل الطبقة العاملة وانعدام الفروق فيصير الناس كلهم أخوة. (موسم، 140). ورغم أنها لا تبالي فهي تعترف أنها بنت المجتمع المعادي الرافض للشرق:”أمي ستجن، وأبي سيقتلني، إذا علما أنني أحب رجلا أسود، ولكنني لا أبالي”. (موسم، 140).
بعد أن مثلت آن همند تهيؤ الظروف، أعتقد أن شيلا غرينود جاءت لتمثل الطاقات البشرية اللازمة، القوات المسلحة، الجنود، أبناء الطبقات العاملة المسحوقة في الغرب، الذين يكونون عادة الوقود للمعركة، ترسلهم الإمبريالية ليقوموا بالأعمال العسكرية القذرة، فهي لا تبالي بمن يعيش أو يموت منهم فيكونوا عادة هم الضحية، ضحية الجشع الإمبريالي. كل ذلك في حين يرفض الأهل أرسال أبنائهم إلى الحرب، فهم يخافون عليهم من الاحتراق في جحيمها. وأكثر من ذلك، يخافون عليهم من الضياع في متاهات سحر الشرق، المجهول، والبربري المتوحش في رأيهم وحسب نظرتهم الاستعلائية. وهذا ما يمثله موقف والدي شيلا. ولكن الأبناء، الشباب المتمرد، المتمثل في شخصية شيلا، والذي يجذبه سحر المجهول يندفع لا يبالي فيدفع حياته ثمنا ويذهب ضحية، ليس لجشع الامبريالية فحسب، وإنما لتهوره ولامبالاته واندفاعه نحو المغامرات مجهولة العواقب كذلك. وقد سبق أن أشرنا إلى أنّ كل عملية غزو هي رحلة إلى المجهول، لا تزيد على أن تكون عملية انتحارية قلما يسلم المشارك فيها، ما يمكن أن يكون تفسيرا لانتحار شيلا غرينود.
إيزابيلا سيمور
الاختلاف بين إيزابيلا سيمور وسابقتيها “أنها امرأة متزوجة من جراح ناجح وأمّ لابنتين وابن. قضت أحد عشر عاما في حياة زوجية سعيدة، تذهب للكنيسة صباح كل أحد بانتظام، وتساهم في جمعيات البر” (موسم، 141). امرأة ناضجة، هكذا يتبادر إلينا وهكذا يراها مصطفى سعيد “امرأة في حدود الأربعين، مهما حدث لها من التجارب فإنّ الزمن عامل جسدها بحنو. التجاعيد الدقيقة على جبهتها وعلى أركان فمها لا تقول لك انها شاخت، بل تقول نضجت” (موسم، 44). ومع ذلك فقد أسرها سحر أفريقيا والشرق وأكاذيب مصطفى سعيد ففتحت شدقيها واسعين على خيراته ضاربة بذلك كل المثل والقيم الانسانية، دينية واجتماعية، عرض الحائط. تحررت من الرباط الديني المقدس، “المسيحيون يقولون إنّ إلههم صلب ليحمل وزر خطاياهم. إنه إذن مات عبثا. فما يسمونه الخطيئة ما هو إلا زفرة الاكتفاء بمعانقتك، يا إله وثنيتي. أنت إلهي ولا إله غيرك” (موسم، 111)، وتحررت من الرباط الاجتماعي، فقد اعترفت أنها ضحّت بزوجها وأولادها لأنها “لم تستطع أن تمنع السعادة من دخول قلبها، ولو في ذلك إخلال بالعرف وجرح لكبرياء زوج” (موسم، 141)، كل ذلك بهدف تحقيق ملذاتها الشخصية التي لا شيء يستطيع أن يقف أمامها، حيث منطق اللذة هو الإله المتحكم وهو الدافع إلى حب السيطرة والتملك. أليست هذه هي أخلاقيات الامبريالية المتهتكة التي لا يهمها إلا السيطرة على الغير ونهب خيراته مهما كلفها ذلك من ثمن. وهو مرض تأكل جراثيمه أصحاب رؤوس الأموال الذين لا شفاء لهم إلا بسيطرة رأسمالهم على كل شيء في بلدانهم وخارجها.
هل انتحرت إيزابيلا سيمور أو ماتت بالسرطان؟ في رأيي كلاهما سيان. يقول زوجها: “إن إيزابيلا زوجتي كانت تعلم إنها مريضة بالسرطان” (موسم، 142). ومجرد سؤال أطرحه للتفكير فقط وربما للمقارنة: أليس هذا هو نفس السرطان الذي عانى منه بوش، ممثلا للإمبريالية الأمريكية / الغربية، فدفعه لغزو العراق؟ خاصة وأنّ كل الأسباب (الأكاذيب) التي لفقها من أجل شرعنة الاحتلال قد تفنـّدت قبل بداية الغزو، ولكنّ ذلك لم يردعه. وسؤال آخر: أليست كل الظروف التي أحاطت بإيزابيلا كان يجب أن تردعها ولم تردعها؟ إذن ما الفرق الآن بين أن تكون انتحرت أو ماتت، ليس بالسرطان المرض المعروف، وإنما بسرطانها الخاص بها هي، مرض الاستعمار وهوس السيطرة الامبريالية الذي لا شفاء منه؟
وبعد تفنيد أسباب (أكاذيب) بوش في غزو العراق، إلا يمكن أن يكون الدافع الأول والحقيقي للغزو هو الحب التاريخي للانتقام؟ ويبدو ذلك واضحا أيضا في أنّ إيزابيلا سيمور تمثل هذا الحب التاريخي عند الغرب للانتقام من الشرق، عربيا كان أو إسلاميا، والذي تجرأ يوما وغزا الغرب (الأندلس، إسبانيا) وإلا فما هو الدافع الذي دفع بالطيب صالح ليرسم إيزابيلا سيمور بنتا لأمّ إسبانية؟ أليست هي الإشارة إلى أنّ هنالك علاقة قديمة بين العرب والغرب، علاقة لا يقبلها الغرب فحوّلها إلى حساب قديم تجب تصفيته؟ وعندما قال لها مصطفى سعيد “لا بدّ أنّ جدي كان جنديا في جيش طارق بن زياد، ولا بد أنه قابل جدتك …” (موسم، 46)، ألا يمثل ذلك فهم الطيب صالح للتاريخ ولحقد الغرب التاريخي؟ وعندما ردّت قائلة “يا لك من شيطان” (موسم، 46)، أليس هذا اعترافا منها أو من الغرب أنّ الشرق المتمثل بمصطفى سعيد أصبح يعرف سرّ هذا الانجذاب الغربي إلى الشرق؟ أيّ أنّ سياسة الغرب تجاه الشرق باتت مفضوحة.
جين موريس
تعتبر جين موريس الشخصية الأهم بين الشخصيات النسائية الأوربية الخمس، وهي الرابعة بين اللواتي يمثلن الوجه الإمبريالي المظلم للغرب. الأربع اللواتي غزا مصطفى سعيد أفكارهن بفكره وأجسادهن بجسده. الأربع اللواتي أقام معهن علاقة جنسية تمثل غزوه للغرب بسلاح الجنس.
رشد (2009) يرى أنّ “الغازي اختار الجنس سلاحا، عندئذ تحددت المرأة كطرف مقابل ممثل للغرب في صدامه مع الذات (الشرق). لقد استعمل الطيب صالح كلا من (آن وشيلا وإيزابيلا) كتمهيد لعلاقة مصطفى سعيد بجين مورس التي تجمع كل الخصائص التي مثلتها الغربيات الثلاث الأخريات”. ربما لهذا السبب لم يتوقف الطيب صالح عند وصفها وإظهار سماتها كالأخريات، وقد اكتفى برسمها من خلال مطاردة مصطفى سعيد لها وردود فعلها لهذه المطاردة. لقد طاردها لمدة ثلاث سنوات واجه فيها من أصناف المهانة والاحتقار الشيء الكثير. كانت تحتقر شكله ومظهره إذ تقول له: “أنت بشع، لم أر في حياتي وجها بشِعاً كوجهك.” (موسم، 34). وتصفه بالوحشية والهمجية إذ تقول له: “أنت ثور همجي لا يكل من الطراد” (موسم، 37). ولكنها في النهاية استسلمت لمطاردته التي لم تعرف الكلل فعبرت عن استسلامها بقولها: “إنني تعبت من مطاردتك لي، ومن جريي أمامك، تزوجني”. “فتزوجتها” (موسم، 37) تأتي هاتان العبارتان، على لسان جين موريس ولسان مصطفى سعيد، في غاية الأهمية. أولا، لأنّ استسلام جين موريس لا يمثل استسلاما حقيقيا، فهو إما نوع من الاستراحة لإعادة الحسابات، أو فرصة للمراوغة من أجل شنّ الحرب من جديد. وإلا كيف نفسر تصرّفات جين موريس بعد زواجها من مصطفى سعيد؟ فقد استمرت في احتقاره والنظر إليه نظرة استعلائية تذكره دائما بأصلها الأوروبي الأبيض مقابل أصله الأفريقي الأسود الذي يمثل دونيته في نظرها. لا بل تعدّت ذلك إلى خيانته علنا. ربما كان يفكر بقتلها أثناء ممارساتها القذرة ولكنه لم يتخذ قرارا حاسما بقتلها إلا بعد أن عرض عليها إقامة علاقة إنسانية بينهما فرفضت. هنا فقط حزم أمره على الانتقام والأخذ بالثأر وحقّ قوله: “فكأننا فلكان في السماء اشتبكا في ساعة نحس” (موسم، 165) ما يؤكد صعوبة اللقاء بين الشرق والغرب إن لم يكن استحالته. وتكمن أهمية العبارة التي جاءت على لسان مصطفى سعيد “فتزوجتها” في أنّ زواجه منها إنما يعبر عن أنّ الإنسان الشرقي لا يتخلى عن إنسانيته حتى في أحلك الظروف، وفعل الزواج هنا جاء ليعبر عن محاولة للمصالحة بين الغرب والشرق لم ييأس منها مصطفى سعيد حتى آخر لحظة، وقد كانت له محاولة أخرى سبق لنا ذكرها وهي محاولته تعليم الاقتصاد المبني على الحب لا على الأرقام. ولكن في حالة جين موريس التي تمثل الوجه الشمولي البشع للإمبريالية الجشعة تبدو المهمة مستحيلة لا يمكن أن يكتب لها النجاح، فالإمبريالية تفضل أن تجلب الدمار على نفسها وعلى أعدائها من أن ترضخ لهم. ويتمثل هذا الأمر بشكل واضح في عبارة جين موريس وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة “تعال معي. تعال. لا تدعني أذهب وحدي”. (موسم، 167). إذن، جين موريس الشخصية التي تمثل الغرب الاستعماري بشموليته في حين مثلت النساء الثلاث الأخريات، كل واحدة وجها أو بعضا من وجوه الغرب الامبريالي المتعددة. أو هي كما يرى يوسف غيشان (200)، أنّ جين موريس هي “المكافل الرمزي للآخر المستعمر التي لا تكفّ عن الابتسام للسخرية من البطل (الشرق) … فينتصر عليها أخيرا بالنجاح في امتلاكها … ثم قتلها”.
ليس بالضرورة أن يمثل القتل انتصار مصطفى سعيد على الاستعمار وقلع جذوره، ولكن يمكنه أن يمثل قدرة الشرق على مواجهة الغرب إذا استخدم، في ذلك، السلاح أو الأسلحة المناسبة أو إذا واجه الغرب بنفس الأسلحة التي يستعملها الغرب في غزوه للشرق. وهنا يأتي دور الأكاذيب والمراوغة، أو السياسة حتى بوجهها الفاسد، فالغرب لا يشنّ حربا دون أن ترافقها حملة سياسة تستند في كثير من جوانبها على الأكاذيب المضللة. ومرة أخرى، فإنّ الحرب على العراق لهي خير دليل على ذلك.
الآخر / الشرق أو الآخر كجزء من الذات
قبل الخوض في الآخر والشخصيات التي تمثله في المجتمع السوداني / العربي / الشرقي، لا بدّ من وقفة مع شخصية مصطفى سعيد كممثل للآخر أمام الراوي الذي يمثل الأنا بدليل أنه يروي قصة مصطفى سعيد بضمير المتكلم (الأنا)، أي من وجهة نظره هو، الراوي.
عاد مصطفى سعيد من الغرب تاركا توتره وتناقضاته هناك، وربما ساعده في ذلك تشرده بعد السجن. ولكنه لم يترك رغبته في التمرد. العكس تماما، فإنّ عودته كانت من أجل هذا الهدف، نقل بذرة التمرد إلى المجتمع السوداني، أو إلى من يستطيع حملها فيه. وقد وجد ضالته في زوجته حسنة بنت محمود وفي الراوي. في الغرب تعامل مصطفى سعيد مع الناس والأشياء بعقلانية بلغت حدّ الجفاف، فقد جاء للغرب بهذا الشكل أصلا، ما يبدو واضحا في قوله “وانطلقت بعد ذلك لا ألوي على شيء. عقلي كان مدية حادة، تقطع في برود وفعالية.” (موسم، 26)، وفي قول مسيز روبنسن “أنت يا مستر سعيد خال تماما من المرح … ألا تستطيع أن تنسى عقلك أبدا؟”. (موسم، 29). هذا الأمر أثار شكوك الراوي وحقده نحوه، فيما كان الراوي يتعامل مع الناس والأشياء بعاطفة ملتهبة منذ لحظة وصوله إلى الوطن ولقائه لأرضه وناسه. ولكن الراوي اكتشف علاقته بالحياة من خلال عقلانية مصطفى سعيد الممتزجة بعاطفته، وقد بدت كل واحدة مدمرة إذا عملت بانفراد عن الأخرى، ما يعني أنّ الراوي قرر ترشيد عواطفه بعقلانية مصطفى سعيد وترشيد عقلانية مصطفى سعيد بعواطفه. امتزاج العقل بالعاطفة يبدو واضحا في حوار الراوي مع نفسه في نهاية الرواية “أنني أقرر الآن أنني أختار الحياة. سأحيا لأنّ ثمة أناس قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن ولأنّ عليّ واجبات يجب أن أؤديها” (موسم، 170). فإذا كان الراوي هو الأنا ومصطفى سعيد هو الآخر، وإذا عدنا إلى الشخصية أو الذات ومكوناتها فإنّ من واجبات الأنا ترشيد نزعات الآخر (ال “هو”) لئلا يدمر نفسه ومن حوله. وبهذا يتحد فعل الأنا والآخر في خدمة الذات كلها.
وإذا كان مصطفى سعيد والراوي وحسنه يمثلون الأنا، كما أسلفنا، في المجتمع السوداني / العربي / الشرقي، وإذا كان مصطفى سعيد قد استطاع غرس بذرة العنف والتمرد في كل من حسنة والراوي، فقد جاء الصدام عنيفا بينهما وبين الآخر المتمثل بعدة شخصيات نكتفي منها باثنتين هما والد حسنة وود الريس. هذا الصدام أودى بحياة حسنة وكاد يودي بحياة الراوي.
المجتمع السوداني / العربي ككل مجتمع آخر، أنتج عبر تاريخه قيم وعادات مختلفة، ولكنه ليس ككل مجتمع حضاري يلجأ للتغيير والتطوير حسب احتياجاته، فتموت قيم وعادات لتحلّ محلها قيم وعادات جديدة أكثر نجاعة في خدمته. القيم والعادات نفسها ومنذ قرون هي التي ما زالت تتحكم بعقليات معظم أفراده. وفي حالة مجتمعنا هناك السلطة الاجتماعية أو الدينية أو السياسية التي تحمي هذه القيم والعادات حتى وإن لم تعد تنفع، إما لأنّ عقلية هذه السلطة متحجرة لا تقبل التغيير، وإما لأنّ مصالحها تقتضي المحافظة على الوضع القائم. وهناك مستهلكون لهذه القيم والعادات أو لنقل هناك انتهازيون يروق لهم بقاؤها فهي تغذي حاجاتهم أفضل من غيرها، خاصة الجديد الذي يحدّ من تلبية احتياجاتهم الشخصية لصالح المجتمع. والد حسنة خير مثل للنموذج الأول وود الريس خير مثل للنموذج الثاني. هاتان الشخصيتان تمثلان التحجّر الفكري، اجتماعيا كان أو دينيا. وفي الحالتين تدفع حسنة الثمن.
حسنة، وجه السودان المشرق الباحث عن التغيير بالانعتاق من القيود الاجتماعية والدينية، مات زوجها مصطفى سعيد، والتي، وفي عرف المجتمع (المتخلف) لا بدّ لها أن تتزوج بعد موت زوجها لأن الناس لا يتركون المرأة الأرملة وشأنها فتصبح عرضة لكلامهم في أي تصرف من تصرفاتها فتسيئ بذلك لشرفها وشرف أبيها أي شرف المجتمع. حسنه هذه خرجت عن المألوف، أولا برفضها للعريس، ود الريس، وثانيا بمحاولتها اختيار العريس (الراوي)، واجهت من الحواجز ما يصعب اختراقه. أولا، أبوها الذي هو صاحب القرار والمتحكم بمصيرها وهي لا تستطيع أن تعصى له أمرا لكي “لا يصبح أضحوكة، ويقول الناس ابنته لا تسمع كلامه” (موسم، 124). خاصة وأنه أعطى وعدا لود الريس (موسم، 123). وثانيا، ود الريس الذي أصرّ (على الزواج من حسنة) كأنما أصابه هوس” (موسم، 124). كل هذا بعد أن لم يفلح تدخل محجوب الذي لم يستطع إقناع أبيها وود الريس بالعدول كلّ عن رأيه، ما يؤكد صعوبة الحواجز التي تواجهها حسنة.
ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عن الآخر في المجتمع السوداني / العربي الذي نمثله هنا بشخصيتي والد حسنة وود الريس اللذيْن يمثلان بشكل صارخ التخلف والتحجر الفكري الاجتماعي والديني وذلك من خلال تصرفهما مع حسنة ووقوفهما حاجزا أمام طموحاتها مما أدّى للنهاية المأساوية: قتلها ود الريس وانتحارها. ولكن هذه النهاية التي اختارتها حسنة لا تمثل، في رأيي، إلا التضحية والاصرار على المواجهة مهما كلف الثمن، لأنّ الانسان المصرّ على انتزاع حريته من براثن التخلف والجهل يعرف جيدا أنّ الأمر مرهون بتضحيات جسام.
خلاصة
وخلاصة القول، إنّ الطيب صالح في رائعته “موسم الهجرة إلى الشمال” أظهر وعيا شموليا لمشاكل المجتمع العربي وقضاياه المختلفة، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتاريخيا، وخاصة في علاقاته الإشكالية مع الآخر، وخاصة الآخر المتمثل بالغرب الاستعماري.
لقد كان اختيار الطيب صالح للبطل الإشكالي الملتبس، متمثلا بشخصية مصطفى سعيد، اختيارا في منتهى الوعي والذكاء حيث أنّه وبطله لم يطرح مجرد طرح للمصالحة مع الذات (مجتمعه) أو مع الآخر (الغرب) كما فعل روائيون آخرون طرقوا الموضوع في رواياتهم، وقدموا البطل الإشكالي واضحا من خلال انتهائه إلى المصالحة مع ذاته ومجتمعه. لقد آثر الطيب صالح البطل الإشكالي الملتبس الذي، عندما وجد المصالحة على مبدأ التكافؤ والمساواة لا تفلح، لم يتأتئ بل لجأ إلى المواجهة باستخدام شتى الأسلحة المتاحة: الفكر، الثقافة، الجنس، السياسة (تلفيق الأكاذيب) والعنف (القتل)، لأنّ المصالحة منفردة أو التأتأة باستخدام الأسلحة المتاحة تعني قبول الواقع المرفوض والتكيّف معه.
وعندما أبرز الطيب صالح الجنس كأهمّ سلاح استخدمه فذلك لأنه استوعب عقلية الغرب الاستعمارية وحساسيته للمادة، بغض النظر عما إذا كانت تقدّم له أو تؤخذ منه. من الأهمية بمكان القيام بدراسة الجنس كسلاح في هذه الرواية ولكني وجدت هذه الدراسة لا تتسع للموضوع بكل جوانبه، فهو موضوع يحتاج إلى دراسة منفردة إذا شئنا أن نعطيه حقه وندرسه بكل أبعاده. وأخيرا، في اعتقادي أنّ عملا جبارا مثل “موسم الهجرة إلى الشمال” رغم كثرة ما كتب عنها ما زالت قادرة على جذب القراء والدارسين، وستظلّ كذلك ما دام الوضع العربي الراهن يحصّن قوالبه ويراوح عندها.

ثبت المراجع
· خوري، إلياس. تجربة البحث عن افق “مقدمة لدراسة الرواية العربية بعد الهزيمة”، بيروت: مركز الابحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، 1974.
· صالح، الطيب. موسم الهجرة إلى الشمال، بيروت: دار العودة، ط: 2، 1969.
· عبد الله، عبد البديع. الذاتية والغيرية والحوار بين الأنا والآخر في الرواية، القاهرة: مكتبة الآداب 1995.
· عثمان، اعتدال. “البطل المعضل بين الاغتراب والانتماء”، مجلة فصول، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجلد، 2، عدد 2، 1982.
· عزام، محمد. البطل الاشكالي في الرواية العربية،دمشق: دار الأهالي، 1992.
· القاسم، أفنان. عبد الرحمن مجيد الربيعي والبطل السلبي في القصة العربية المعاصرة، بيروت: عالم الكتب، 1984.
· أبو شهاب، رامي. الطيب صالح شكلانية الموت: قراءة في موسم الهجرة إلى الشمال بين الاستثناء والامتلاء، 2009. في: http://pulpit.alwatanvoice.com/cont…
· حج محمد، فراس. سلوك الرجل والمرأة في رواية “موسم الهجرة إلى الشمال”، رابطة أدباء الشام، 2007. في: http://www.odabasham.net/show.php?s…
· رُشد، محمد. علاقة الأنا والآخر في “موسم الهجرة إلى الشمال”، 2009. في: http://www.diwanalarab.com/spip.php…
· سليمان، سميرة. أشهر روايات الطيب صالح “موسم الهجرة إلى الشمال” … ليل لا يعقبه نهار!، 2009. في: http://www.moheet.com/show_news.asp…
· عصفور، جابر. موسم الهجرة إلى الشمال، 2008. في:
· غيشان، يوسف. موسم الهجرة الى الموت، 2009. في: